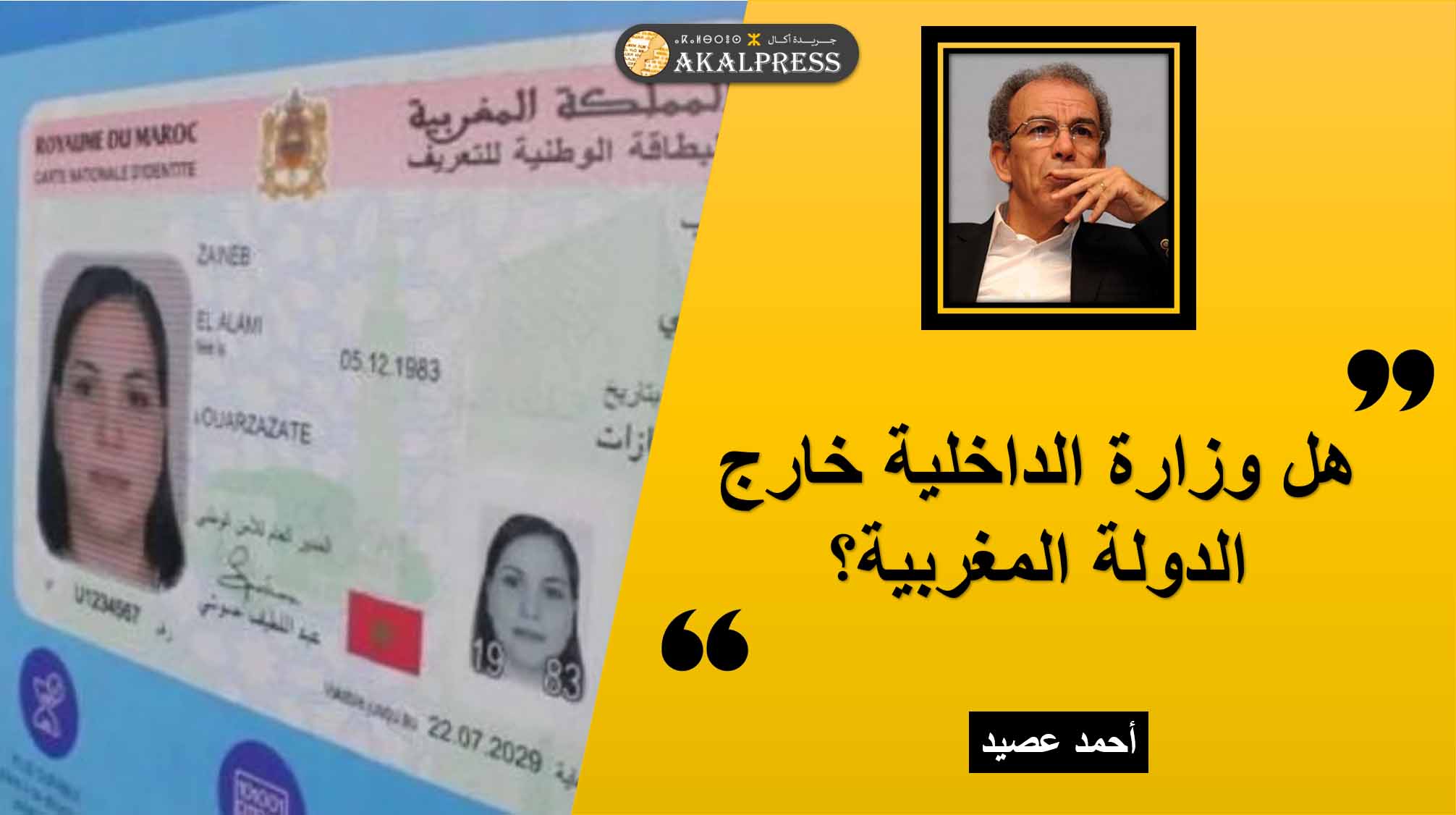الهوية المغربية والخطايا الأصلية
“يمكن أن يكون الشعور بالهوية مصدرا، ليس فقط للفخر والبهجة، بل أيضا للقوة والثقة. إلا أن الهوية يمكن أن تقتل وبلا رحمة”.
أَمَارتيَا صن
يعتقد الكثيرون بأن سؤال الهوية، مجرد هوس يشغل الناس عن القضايا الحقيقة، لكن بمجرد ما ينتبهون إلى كل الفضاعات والمآسي التي يتسبب فيها العنف الهوياتي تتغير مواقفهم. الهوية لا تترك أحدا على الحياد، كل واحد منا حسب النشأة والظروف والمواقف ينحاز إلى عنصر من عناصر هويته المركبة. تكمن خطورة الإستخفاف بقضايا الهوية في كونها وقود سريع الإشتعال يحمله بَشَر مشحون بعناصر انفجارية.
مخاطر الهوية دفعت الروائي “أمين معلوف”، وهو العارف بتضاريس الهويات القاتلة، إلى أن يُمَاثل بين الهوية والفهد، فالفهد يقتل إذا طاردناه، ويقتل إذا تركناه طليقا، والأسوأ أن نكون قد جرحناه، لكننا نستطيع أن نروضه. بمعنى آخر، لا يجب أن نعالج مسألة الهوية بالتجاهل أو بالاضطهاد والتواطؤ، بل بالترويض.
رغم فرادة النموذج الهوياتي المغربي، ونجاح المغاربة في صناعة خيمياء هوياتية مكنتهم من رسم ملاحم تاريخية، سواء في العصر المرابطي أو الموحدي وما بعدهما، ورغم حفاظ المغرب على استقراره في الزمن الحاضر مقارنة مع يحدث من اقتتال هوياتي في افريقيا والشرق الأوسط خصوصا، رغم كل ذلك، يمكن القول بأن المغرب لم يستطع بعد ترويض هويته، بسبب أربع خطايا أصلية :
- خطيئة ثنائية الأمازيغي والعربي.
- خطيئة الربط الماكر بين اللغة العربية وإيديولوجية العروبة.
- خطيئة الإعتقاد بوجود هوية مفردة خالصة : أمازيغية كانت أو عربية.
- خطيئة الخلط بين اليهودية والصهيونية.
تنبيه : نوظف مصطلح الخطيئة الأصلية، بمعناها اللاهوتي الكاثوليكي الذي يعني فيما يعنيه، خطيئة يتحمل المرء مسؤوليتها رغم أنه لم يرتكبها، ولأنها خطيئة فيجب على المجتمع أفرادا وجماعات التطهر منها قبل مواصلة البناء المجتمعي المشترك على أسس متينة.
خطيئة ثنائية الأمازيغي والعربي
لم يكن المغاربة يولون أهمية كبيرة للتصنيفات الهوياتية، القائمة على العرق واللغة. فرغم أن حضور اللغة ضمن عناصر الهوية بوصفها بنية تعددية، يعد أمرا واقعا، إلا أن الأهمية النسبية التي علقها المغاربة عليها تبقى هامشية جدا مقارنة مع عناصر الهوية الأخرى كالقبيلة والجهة والمكانة الاجتماعية : محظوظ أو مَحروم. كما أن الموقف من السلطة المخزنية، لم تكن تمليه اعتبارات عرقية أو لغوية بقدر ما كانت تمليه طبيعة تدبير ممثلي السلطان، قوادا كانوا أو جباة ضرائب، للعلاقة مع القبائل. تتمرد القبائل حينما يُثقل كاهلها بالضرائب ويُستَفحل جور القواد أو عندما يفشل المخزن في استتباب الأمن ورد العدوان الأجنبي.
ظل المغاربة إذن في منأى عن ثنائية الأمازيغي والعربي، ولم تؤثر فيهم حتى شجرات النسب الشريف التي كانت في متناول كل ذي جاه أو حضوة أو طموح، بغض النظر عن أصله وفصله. كما ظل الأمر على ما هو عليه خلال العشرين سنة الأولى من زمن الحماية، رغم المجهود الجبار لرواد السوسيولوجيا الكولونيالية للتمييز بين” البربر والعرب” والتأسيس لهذا التمييز نظريا خدمة لسياسات سلطات الحماية.
وفي هذا الباب، يعتبر كتاب “التعرف على المغرب” للراهب شارل دوفوكو، والذي ضمنه خلاصات رحلته الإستكشافية إلى المغرب سنة 1883، مرجعا أساسيا، اعتمدت عليه الجمعية الجغرافية الفرنسية ومن أتى بعده من الباحثين وأعوان الحماية من ظباط الشؤون الأهلية وغيرهم.
لقد لعبت هذه الجمعية التي كان الماريشال ليوطي أحد أعضائها، أدوار محورية في التأسيس لسياسة التمييز بين” البربر والعرب” بالمغرب، ففي مقرها في سانت جرمان بباريس عقد المؤتمر العربي الأول سنة 1913 والذي انتهت أشغاله، بتبنى أول وثيقة تاريخية ترفع مطالب باسم العرب والوطن العربي. ولأهمية الحدث بالنسبة لفرنسا والقوميين العرب احتفل معهد العالم العربي بباريس سنة 2013، بذكرى مرور مائة سنة على عقد المؤتمر العربي الأول، احتفال حضرته فعاليات قومية عربية ونخبة من الباحثين وممثلي مراكز البحوث العربية.
لم تكن فرنسا تستهدف من خلال المؤتمر العربي الأول، سنة 1913، إزعاج الإمبراطورية العثمانية فقط، بل كانت تسعى إلى توظيفه أيضا في مساعيها لتقسيم المغرب ومستعمراتها بشمال إفريقيا عموما، على أساس إثني وعرقي، في إطار استراتيحبة “فَرق تَسُد”. لم يَطُل انتظار سلطات الحماية لجني ثمار المؤتمر العربي الأول، فبعد صدور ظهير 16 ماي 1930، بشأن تنظيم سير العدالة بالقبائل ذات الأعراف التي لا توجد بها محاكم لتطبيق الشريعة، خرجت مجموعات من القوميين العرب المغاربة لتقرأ لطيف “اللهم لا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر”.
فاللطيف أسس للتمايز العرقي بين العرب والأمازيغ، وأجبر المغاربة على اكتشاف الجانب اللامفكر فيه من هويتهم، جانب الملل والنحل والعرق والآخر المختلف. لقد استهدفت سلطات الحماية من خلال ثنائية العربي/البربري تدمير الثقة الإجتماعية بين المغاربة، ومسح نتائج قرون من تفاعل عناصر الخيمياء الهوياتية بالمغرب، وقد اعتمدت في ذلك على القوميين العرب وبعض القواد “البربر”، كما تسميهم، المُسَلطين على القبائل.
كانت حجة القوميين العرب من وراء قراءة اللطيف المؤسس لثنائية العرب/البربر هي الحيلولة دون تحويل “البربر” إلى نصارى، والحال أنه وباعتراف المفكر المغربي، الراحل محمد عابد الجابري، أحد منظري الوعي العروبي بالمغرب، فالحجة كانت أكثر من واهية. يقول الراحل محمد عابد الجابري في بحث له سنة 1986، حول يقظة الوعي العروبي بالمغرب :”لم يَتَنَصر ولا شخص واحد من المغاربة من أصل بربري كان أو عربي، باستثناء أحد أفراد إحدى العائلات بفاس ولم يكن بربريا بل كان من الإرستقراطية المدينية ومن عائلة مرموقة.”
نعم فشلت فرنسا في تأليب المغاربة ضد بعضهم البعض على أساس عرقي، لكنها نجحت بدعم من القوميين العرب في التأسيس لأسطورة ثنائية العرب والأمازيغ، وغرزت بذلك اسفينا في الجسم الإجتماعي المغربي، يؤلم المغاربة كلما اشتدت حركة المتطرفين، سواء باسم العروبة أو المزوغة.
خطيئة الربط الماكر بين اللغة العربية وإيديولوجية العروبة
كان هدف القوميين العرب من التركيز على ثنائية العرب و الأمازيغ، منذ ماي 1930، إيهام المغاربة بأن بلادهم مهددة في وحدتها بسبب وجود عرقين ولغتين مختلفين، وبالتالي وجب الإرتكاز على اللغة العربية لجمع شملهم وتحقيق وحدة أمتهم.
لقد استلهموا نموذج الوحدة على أساس لغوي، من الجمهورية الفرنسية، حيث تلعب اللغة الفرنسية دورا أساسيا في ترميز الوحدة الوطنية بديلا عن رمز ساقط هو جسد الملك المغتال. وحتى تلعب اللغة العربية هذا الدور، وجب الحط من قيمة باقي التعبيرات اللغوية والثقافية في البلاد في أفق انقراضها. (يراجع لمزيد من التوضيح كتاب “اللغة والسلطة والمجتمع في المغرب العربي” لجلبير غرانغيوم).
ظهرت إيديولوجية القومية العربية على مسرح الأحداث بالمغرب، في زمن كانت فيه للعربية مكانة خاصة عند جميع المغاربة، ليس فقط لدواع دينية بل لدواع حضارية أيضا، فقد كان الإقبال عليها طوعيا ولم يكن ثمة أي تناقض أو تنافر بين التبحر في علوم اللغة العربية والإعتزاز باللغة الأم، سواء الدارجة المغربية أو إحدى التعبيرات اللغوية الأمازيغية (يراجع في هذا الشأن كتاب المعسول للعلامة المختار السوسي). لذلك فشل القوميون العرب المغاربة في إقناع المغاربة بما يبشرون به، فقد كانوا كمن خرج للناس في ظهيرة يوم صيفي مشمس مبشرا إياهم بظهور الشمس.
بعد أن فشلت خطة اللطيف في تحقيق زخم شعبي لمشروعهم، ركز القوميون العرب مجهودهم على البروباغاندا بتوظيف أسطورة “الظهير البربري”، وعلى التموقع السياسي استعدادا لمرحلة الإستقلال. بعد إلغاء معاهدة الحماية وهيمنة القوميين العرب والمتعاطفين معهم على الكثير من مراكز القرار في دواليب الدولة، فُرضَت العروبة والتعريب على المغاربة بوصفهما الوجه الثقافي للإستقلال والعنصر المكمل للتحرر السياسي والإقتصادي. لقد كان الهدف من ربط العروبة والتعريب بالإستقلال، دفع المغاربة إلى مماهاة الإستقلال مع العروبة والنخب الحاملة للوائها المتحكمة في جهاز الدولة، لشرعنة احتكار السلطة والتحكم في آليات الإنتاج الإجتماعية من أجل تأبيد الإحتكار.
فنخب العروبة سوقت مشروع التعريب وطالبت الشعب باحتضانه، في الوقت الذي اعتمدت فيه على اللغة الفرنسية ومدارس البعثة الثقافية الفرنسية في إعداد أبنائها للنجاح في عملية الإنتقاء الإجتماعي، لمواصلة احتكار الجاه والسلطة والقيم ؛ فخريجو المدرسة العمومية المعربين لن ينافسوا نظرائهم خريجي مدارس البعثات. فاللغة العربية كانت تفتقد إلى الفعالية والنجاعة ولم تتم تهيئتها لتنافس اللغة الفرنسية. لقد كان التعريب من وجهة نظر سوسيولوجية ، كما أشار إلى ذلك “جلبير غرانغيوم”، بمثابة مكان للتعبير في آن واحد عن الخطاب الأيديولوجي الوطني وحقل التوترات السوسيو-إيديولوجية المغلق.
لقد أخذت تلك التوترات السوسيو-إيديولوجية طابعا عنيفا بعد تفاقم الأوضاع الإقتصادية بالمغرب مع بداية الثمانينات من القرن الماضي، حيث اندلعت انتفاضات شعبية في كل من الدارالبيضاء سنة 1981 وفي مراكش ومدن أخرى سنة 1984. لقد خرج المغاربة للإحتجاج على الأعطاب التي أصابت المصعد الإجتماعي، والتي كان من بينها فشل المنظومة التعليمية بسبب التعريب إلى جانب احتكار قلة من النخب للثروة والسلطة. لقد دمرت الإنتفاضتين، حصان طروادة احتكار الثروة والسلطة والقيم، المتمثل في التعريب وإيديولوجية العروبة.
أمام الرفض الشعبي لحصيلة ربع قرن من الإستقلال وتدبير شؤون البلاد والعباد، ومن ضمنها نتائج التعريب وأيديولوجية العروبة، اختارت النخب العروبية الهروب إلى الأمام. وعوض تحمل مسؤولية ما ترتب عن سياسة التعريب من نتائج كارثية والقيام بالنقد الذاتي المطلوب، تطرف خطابها وصولا إلى حد المطالبة بإبادة لغوية في حق التعبيرات اللغوية الأمازيغية. ففي سنة 1985، أطلق الأستاذ محمد عابد الجابري، دعوته إلى إماتة اللهجات المحلية البربرية، مؤكدا على الأهمية الكبرى للقيام بذلك لإنجاح عملية التعريب الشاملة. ( المرجع: كتاب “أضواء على مشكل التعليم بالمغرب” للأستاذ محمد عابد الجابري، دار النشر المغربية/ الدارالبيضاء).
رغم ما لحق الجسد الإجتماعي والمنظومة التعليمية بسبب التعريب، وما لحق اللغة العربية نفسها جراء توظيفها في معارك أيديولوجية العروبة وفي سياسة احتكار الثروة والسلطة، يبدو أن الدولة لم تستخلص الدروس اللازمة لحماية المغاربة من تلاعب بعض النخب بمصير أمة ومصائر أجيال المستقبل. فبعد فشل المشروع القومي، ها هي الحركة الإسلامية، وفريق منها يحكم المغرب، توظف اللغة العربية والتعريب في التدافع والتموقع وحروب الهوية. فهل يلدغ المغاربة من ذات الجحر مرتين؟
خطيئة الإعتقاد بوجود هوية مفردة خالصة : أمازيغية كانت أو عربية.
تعتمد النسبية الثقافية على الإختلاف وتعايش الثقافات بدل اقتتالها، وهي لا تؤمن بوجود تراتبية بينها أو سلم مفاضلة، كما لا تؤمن بتفوق إحداها على الأخرى. لقد تسلحت الحركة الأمازيغية بهذا المبدأ، منذ تأسيسها سنة 1967، في مقارعة حجة قوة القوميين العرب وتغولهم بقوة حجة مشروعها النسبي التعددي ؛ فلم تكن تنادي بالهوية المفردة الخالصة، ولا بإحلال اللغة الأمازيغية مكان اللغة العربية، بل كانت تطالب بالتنوع في ظل الوحدة. وقد ساعدها ذلك في تحقيق المكتسبات تلو الأخرى.
غير انه يجب الإعتراف بأنه حصل انحراف في الطرح الأمازيغي منذ عشر سنوات تقريبا، وخرجت من رحم الحركة الأمازيغية بعض التيارات، الهامشية لحد الآن، تنادي بالهوية الأمازيغية المفردة الخالصة والتمييز بين ما هو أصل وما هو فرع، ما هو سابق وما هو لاحق، ما هو مستقل وما هو تابع، ما هو أول وما هو ثان، ما هو رئيسي وما هو ثانوي! إن الحقل المفاهيمي الذي ينهل منه منظرو هذه التيارات أدواتهم المعرفية، لا يختلف كثيرا عن ذلك الذي ينهل منه كل المنظرين الذين يقسمون الناس إلى أقسام منفصلة وجماعات لا تفاعل ولا انصهار بينها وكأنهم محبوسون في صناديق من فولاذ في انتظار الخروج يوم الحسم والمواجهة لتحديد المنتصر في حرب الهوية.
علمتنا النسبية الثقافية بأن الأمازيغية ليست هوية الأمازيغوفوني على وجه الحصر، وأن العربية ليست هوية العربوفوني على وجه التحديد. يمكن لأي مغربي أن يعيش أمازيغيته دون ان يتوقف عن أن يحس بفخر الإشتراك مع مغاربة آخرين في الحفاظ على اللغة العربية كرصيد مشترك، كما يمكن لكل مغربي أن يعيش عَرَبيته دون أن يتوقف عن المساهمة في الحفاظ على اللغة الأمازيغية كرصيد مشترك. فلا يمكن سجن المغاربة داخل مجموعات منفصلة من الصناديق الهوياتية.
يقول الفيلسوف والإقتصادي “أمارتيا صن” في كتاب “الهوية والعنف” : “ليس التاريخ والنشأة هما الوسيلة الوحيدة لرؤية أنفسنا والجماعات التي ننتمي إليها، فهناك مجموعة هائلة من التصنيفات التي ننتمي إليها في الوقت نفسه”.
فبإمكاني كمغربي أن أكون في الوقت نفسه، مدافعا عن الأمازيغية، ومعتزا باللغة العربية، وشغوفا بالأدب الفرنسي، ومطالبا بفصل الدين عن السياسة، وعلى خلاف مع دعاة العلمانية المتطرفة، ومتعاطفا مع الشعب الفلسطيني، ومطالبا بالتوقف عن الخلط بين اليهودية والصهيونية. هذه مجرد عينة صغيرة من التصنيفات التي يمكن أن أنتمي إليها في الوقت نفسه.
خطيئة الخلط بين اليهودية والصهيونية
أحيانا قد لا نكون مدركين لتعريف الآخرين لنا، ولا نكتشف بأننا مختلفون عنهم إلا بعد إصرار منهم على تذكيرنا في كل وقت وحين بأننا مختلفون، وفي الغالب الأعم يتخذ هذا الإصرار شكل إسناد الصفات التحقيرية لنا، أو معاملتنا بالقسوة والعنف. في “تأملات في المسألة اليهودية” كتب جان بول سارتر يقول :”اليهودي إنسان، ينظر إليه الناس الآخرون باعتباره يهوديا…إن المعادي للسامية هو الذي يصنع اليهودي”. في ذات السياق، كتب تيودور هرزل يقول :”المعادون للسامية هم أصدقاؤنا الأوفياء…والأمم المعادية للسامية حلفاؤنا”. فاستهداف اليهود في الكثير من دول العالم هو الذي عجل بهجرتهم إلى إسرائيل، ما يجعل كل من ساهم في هذا الإستهداف حليفا طبيعيا للصهيونية.
فاليهودي المغربي، صنعته التصنيفات الهوياتية والتوصيفات التي دأب المغاربة على استعمالها في تعريف إخوانهم اليهود المغاربة، والتي كانت مشحونة بغير قليل من الإزدراء والإحتقار. وقد استفحل الإزدراء والإحتقار بعد النكبة الفلسطينية وقيام دولة إسرائيل سنة 1948، رغم أن لا علاقة بين اليهود المغاربة وما كان يدور في فلسطين. كما أن مغادرة آلاف اليهود المغاربة لبلادهم، بعد اشتداد الضغط عليهم، خدم مصالح الصهيونية، ووضع غلاة المحرضين على معاداة إخوانهم اليهود، الأبرياء من الدم الفلسطيني، في صف حلفاء الصهيونية وإسرائيل.
لم يكن الخلط بين اليهودية والصهيونية خطيئة فقط، بل جريمة متكاملة الأركان في حق الوطن ومواطنيه من اليهود.
في سبيل ترويض الهوية المغربية المركبة
ينص دستور المملكة المغربية، في الفقرة الثانية من تصديره، على “أن الدولة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية” . إن تعريف المشرع الدستوري للهوية المغربية يعتبر تقدما على ما كان عليه الأمر في الدساتير السابقة، وخطوة جبارة في سبيل نموذج مغربي للهوية يُرتَكز عليه لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.
غير أنه وجب القول بأن الإعتراف بتنوع مقومات الهوية الوطنية في ظل وحدتها، يحتاج إلى انصهار تلك المقومات في خيمياء هوياتية، بالشكل الذي تصبح فيه الهوية الجامعة المركبة أكبر من مجموع عناصرها. فلا يكفي انصهار المقومات في كل واحد بل يجب ترويض مجموع العناصر المنصهرة حتى تأخذ شكل هوية مواطنة رئيسية، يجد فيها كل مغربي ذاته دون تخليه عن انتماءاته الهوياتية الثانوية الأخرى. كما أن الترويض يحتاج إلى صيانة حقوق كل العناصر الهوياتية على قدم المساواة، في إطار تَمَلك المغاربة لها جميعها، دونما إقصاء لهذا العنصر أو ذاك.
ويوم ينجح المغرب في ترويض هويته المركبة، سيكون المغاربة قد نجحوا في التطهر من الخطايا الأصلية، وسيكون بإمكان الدولة تعبئة طاقات كل مواطنيها، لاستكمال البناء الديمقراطي وبناء دولة قادرة على الصمود في عالم لا يعج بالتحديات والأخطار فقط، بل بفُرَص النجاح في بناء دولة قوية في خدمة كل مواطنيها دونما تمييز.

ناشط حقوقي وباحث، ساهم في تأسيس العديد من الجمعيات. رئيس منظمة تاماينوت سابقا، عضو مؤسس للفضاء الجمعوي بالمغرب، والرئيس المؤسس للمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات ولتكتل تمغربيت للإلتقائيات المواطنة.