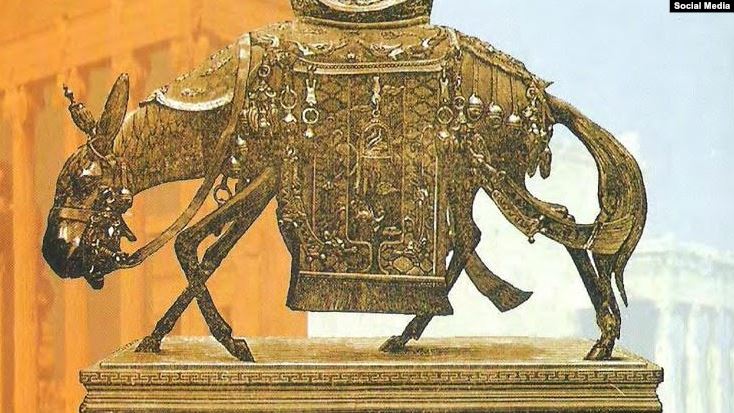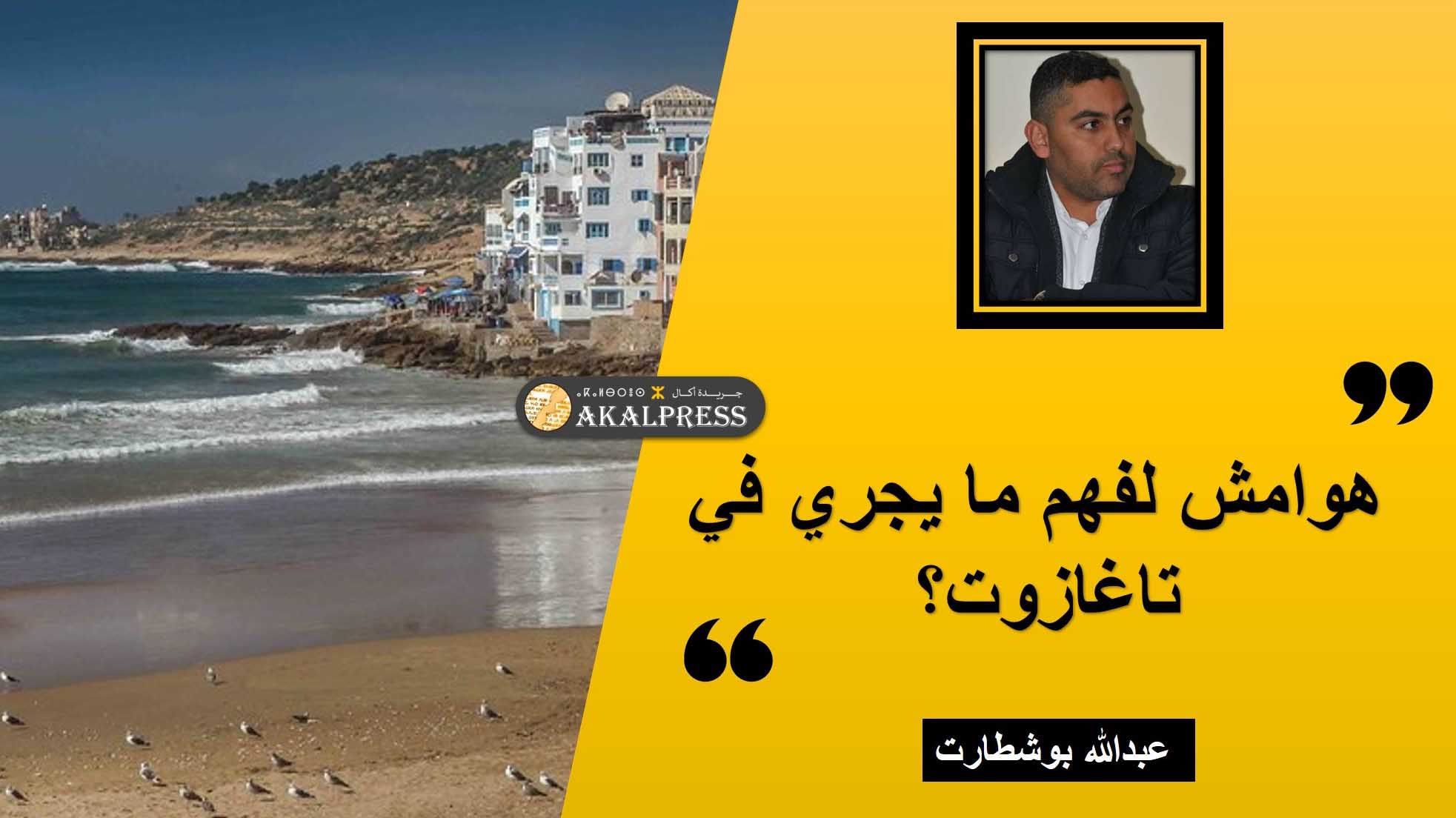رواية “العودة” لميمون أمسبريذ
أصدر الكاتب ميمون أمسبريذ، في ماي 2023، رواية بالأمازيغية تحت عنوان «العودة، مذكّرات “بادي”». يروي الكاتب أحداث القصة بصيغة المتكلّم، مما يجعل القارئ يعتقد، وبلا أدنى شك، بأنه هو المعني بتلك الأحداث، حتى لو كانت إبداعا متخيَلا. وفقط في الأسطر السبعة الأخيرة من الصفحة 150 الأخيرة، يخبرنا ويشرح لنا بأنه عندما تقدّم، هو وإمام المسجد، لنقل المتوفّى المسمّى قيد حياته “بادي”، أحد ساكنة بلدة “تاغزوت” (تقع بإقليم الدريوش)، إلى مكان الغسل لتجهيزه للصلاة عليه في المسجد ثم دفنه، عثر تحت وسادة ببيته على هذه القصة، مدوّنة على مجموعة من الأوراق كتبها “بادي” بالأمازيغية كما هي منطوقة. وقد قام الكاتب بمراجعتها وتصحيح كتابتها وفق القواعد الإملائية للكتابة الأمازيغية في حدود معرفته بهذه القواعد.
القصة:
يحكي “بادي” أنه ازداد بـ”تاغزوت”. وقد قضى عشر سنين في حفظ القرآن ثم تحفيظه، قبل أن يهاجر إلى الجزائر للعمل في ضيعات المعمّرين الفرنسيين. وبعد استقلال الجزائر عاد إلى “تاغزوت”. بعد ذلك سيهاجر إلى بلجيكا للعمل هناك. بعد بضع سنوات من زواجه ببنت صديق أبيه نزولا لدى رغبة هذا الأخير، سينقل أسرته إلى بلجيكا، في إطار “التجمّع العائلي”. بعد خمسين سنة قضاها في المهجر، سيقرّر، هو وزوجته “حمّوت”، العودة للاستقرار النهائي في “تاغزوت”. ومن هنا عنوان الرواية: “العودة”.
بعد العودة النهائية إلى “تاغزوت”، ستبدأ، وفي خريف العمر، حياة جديدة، سواء على مستوى الوضع النفسي لـ”بادي” و”حمّوت”، أو على مستوى بلدة “تاغزوت” نفسها التي ستعود إلى سابق ازدهارها الفلاحي بفضل “تافسوت”، حفيدة “بادي” و”حمّوت”، التي وُلدت وعاشت ودرست بالخارج علم الفلاحة البيولوجية (bio)، الذي يرمي إلى الحفاظ على البيئة واقتصاد الماء وعدم إجهاد التربية، وهو العلم الذي ستطبّقه ببلدة “تاغزوت” بجانب زوجها “ماسين”، ابن المنطقة الذي أنهى دراسته الجامعية ولم يحصل على عمل. وقد كان “بادي” يرى في زواج “تافسوت” و”ماسين” زواجا مع “تاغزوت”، لأن بفضل هذا الزواج ستستمر “تاغزوت” حية بعد مماته (106).
في مذكّراته يحكي “بادي”، ليس فقط عن هجرته الجغرافية من “تاغزوت” إلى بلجيكا، بل عن هجرته الفكرية والمذهبية والهوياتية التي قادته إلى اعتناق الخطاب القومي اليساري، ثم الخطاب الإسلاموي المتشدّد، ثم الخطاب الشيعي مع سطوع نجم الخميني… وكل ذلك كان من أجل الوصول إلى الحقيقة، حقيقة ذاته ومن يكون.
بعد سنوات من الاستقرار ببلجيكا، بدأ يصل إليها مهاجرون مغاربة من نوع آخر، مهاجرون لم يأتوا من أجل العمل. فيهم من هم طلبة قدموا من أجل الدراسة، وفيهم من كانوا يزعمون بأنهم “يساريون” و”معارضون” فروا من النظام وجاؤوا إلى بلجيكا طلبا للجوء. هؤلاء المهاجرون، من هذا الصنف الجديد، بدأوا يجالسون ويخالطون مجموعة العمال الذين ينتمي إليهم “بادي”. سيدرك أن كلام هؤلاء نوع من الخطاب «جديد ومختلف، يدور حول أمور “كبيرة”، و”بعيدة”، لا علاقة لها بحياتنا في بلجيكا ولا في “تاغزوت”» (صفحة 23). وهذا ما جعله يقتني مذياعا ضبطه على إذاعة “صوت العرب” حتى يستمع إلى ذلك الخطاب من منبعه. هكذا سيتبنّى “بادي”، مع عمال مغاربة آخرين، هذا الخطاب القومي الذي كان يروّجه اليساريون والعروبيون حتى أنه لم يعد يتحدّث، هو ورفاقه من أهل “تاغزوت”، عندما يجتمعون فيما بينهم، عن بلدتهم وأحوال سكانها، بل كانوا يلوكون (هكذا كتب “بادي” في مذكراته بصفحة 24) ما يسمعونه من الطلبة و”اليساريين” طالبي اللجوء، وما تردّده إذاعة “صوت العرب” من كلام حول: “الأمة العربية”، “الوحدة العربية”، “الشعب العربي”، “الصهيونية العالمية”، “الإمبريالية”، “الرجعية”… لقد كان هذا الخطاب «يجعلنا، كما يعترف “بادي”، أكبر من أنفسنا، يحملنا إلى سماوات مفتوحة وعريضة، فيها يكون شفاؤنا من كل جراحاتنا الغائرة» (صفحة 24). وبتكرار خطاب القوميين والدوام على الاستماع إليه، ظهرت لدى معتنقي هذا الخطاب من التاغزوتيين، لغة عربية “جديدة” ليست هي “عربية” الكتّاب القرآني حيث درس ودرّس “بادي”، والتي كان يُنظر إليها على أنها أمازيغية المسجد (صفحة 25)، بل عربية تغرف مفرداتها من قاموس “صوت العرب” وخطاب القوميين.
بعد عشرين سنة من العمل في بلجيكا، بدأت العديد من المعامل تغلق أبوابها مع منح العمال تعويضات البطالة. فأصبح هؤلاء العمال يقضون جل أوقاتهم داخل منازلهم. وهنا بدأ صنف آخر من المهاجرين، من بلدان مختلفة، وبلباس باكستاني، يتصلون بهم ويُخرجونهم للصلاة معهم في “كراجات” أعدّوها لهذا الغرض. وعندما يتأكدون أن هؤلاء المستقطبين أصبحوا منهم، يطلبون منهم القيام بتبليغ الرسالة (صفحة 28). لقد عرف أصحاب اللباس الباكستاني كيف يستقطبون “بادي” في الوقت الأنسب: فمشاكل أولاده تتفاقم يوما عن يوم (اعتقال وسجن، تجارة المخدرات، السكر العلني…)، زوجته تحوّلت إلى امرأة لا تطاق.. ونظرا لمعرفته للعربية التي تعلمها في الكتّاب عندما كان يحفظ ويحفّظ القرآن، اختاره أصحاب اللباس الباكستاني أن يكون “مترجما” لتبليغ ما يسمونه “الرسالة” (صفحة 30). كانوا “يبلّغون” الرسالة في البداية إلى أحياء المسلمين ببلجيكا، ثم في مرحلة ثانية إلى مسلمي بلدان أوروبية أخرى، ثم في مرحلة ثالثة انتقلوا بـ”بادي” إلى باكستان وبنغلاديش، البلدين اللذيْن انطلق منهما أصحاب “التبليغ” الأولون (صفحة 30).
مع انخراطه الحماسي في تيار جماعة “التبليغ”، لم يعد شغل “بادي” هو هموم أسرته الصغيرة، بل أصبح شغله منصبا على الأسرة الكبيرة التي هي “الأمة الإسلامية”. يقول: «لقد هربت من نفسي إلى أنفسنا، من الدار إلى الدنيا، من الأسرة إلى الأمة. أصبحت أشعر بنفسي كمن كان مكبّلا فتخلّص من قيده، كمن كانت تحجب بصره غشاوة ثم زالت. لم أعد اهتم بمن يدرس ومن انقطع عن الدراسة من أبنائي، من منهم دخل السجن أو من منهم خرج منه. لكن كنت أراقب زوجتي وبناتي: ماذا يلبسن وكيف يلبسن، لأن لباس المرأة هو من انشغالات أصحاب التبليغ» (صفحة 30).
بعد أن كثر أتباع جماعة “التبليغ”، ظهرت بينهم مذاهب وخلافات حول نوع اللباس (بكاساتي، أفغاني، سعودي…) وشكل اللحية، وطريقة التعامل مع “الكفار”، أبناء البلدان التي يقيمون بها في أوربا. يقول بادي: «كنا نتخاصم في “تاغزوت”، في حال حصول ذلك، بسبب الأرض. أما الآن فالخصومة هي بسبب اللحية» (صفحة 32). وحتى في الصيف، عندما كان “بادي” يزور “تاغزوت” كان ينشر بها خطاب أصحاب “التبليغ” حول “الأمة”، “الحلال”، “الحرام”، “الإسلام الحقيقي”، “الكفر”، “البدعة”، “السنة”، “نحن”، “هم”… وقد نجح في ذلك حتى أن الخلافات “المذهبية” بين سكان البلدة، حول اللباس والحجاب وطريقة قراءة القرآن ودفن الموتى، وهل التلفزة حرام أم حلال…، فاقت تلك المعروفة في بلدان المهجر (صفحة 33).
مع نجاح الثورة الإيرانية بقيادة الخميني، سيكون لهذا الأخير تأثير قوي وعميق على “بادي” بخصوص مواقفه واختياراته المذهبية. لقد رأى فيه نموذج المسلم الحقيقي، وفي مذهبه الشيعي الإسلامَ الحقيقي. لقد أحدث في شخصيته انقلابا حقيقيا. يقول “بادي” عن الخميني: «منذ أن شاهدته (في التلفزة) لم أعد أنا هو أنا: كل ما عشته، كل ما رأيته، كل ما عرفته، كل ما اقتنعت به في بلجيكا… كل ذلك ذاب كقطعة من الثلج تحت أشعة الشمس» (صفحة 34). لقد اعتنق مذهب الخميني وتحوّل إلى شيعي يعادي أهل السنة، وافتتح هو وجماعة من الشيعيين الآخرين مسجدا للصلاة خاص بأتباع “أهل البيت” (صفحة 38)، أي أتباع المذهب الشيعي الذي يمثّله الخميني. ولم يكفه ما توصّل إليه، بقراءاته لبعض الكتب التي تخص الشيعة، حول حقيقة هذا المذهب، فأراد أن يغرف من النبع الأصلي للتشيع فسافر إلى النجف وكربلاء بالعراق ثم “قم” بإيران (صفحة 39).
شيئا فشيئا سيتحول الخميني، في نظر “بادي”، إلى دكتاتور وطاغية. لكنه يبزّ الطغاة الآخرين لكونه يمارس طغيانه باسم السماء، كما يقول (صفحة 41). وهكذا سيتخلّى هو وأعضاء مجموعته عن الانتماء الشيعي ومبايعتهم للخميني دون أن يخبر أحد منهم الآخرين.
بعد توصله برسالة الإحالة على المعاش، بدأ يستعرض مراحل من حياته، متوقفا عند مرحلة “تاغزوت” عندما كانت هي “الأمة” قبل أن تحل محلها “أمة” اليساريين والإسلاميين (صفحة 45 ـ 46). لقد تحولت بلدان المهجر إلى ضرة لـ”تاغزوت”: الكثير من أبناء المهاجرين التاغزوتيين ينتمون إليها أكثر مما ينتمون إلى “تاغزوت”. بل الحقيقة أنهم لا ينتمون إلى هذه ولا إلى تلك (صفحة 47). هكذا أصبح الجيل الجديد من أبناء المهاجرين لا يعرفون أي انتماء إلى الأرض، لأنهم يشعرون بالانتماء إلى السماء، الذي يعتبرونه الانتماء الحقيقي. فتراهم يتسابقون إلى الدفاع عن الإسلام والمسلمين في أي بلد يتعرض فيه هؤلاء لمعاملة يرونها، من وجهة نظرهم، غير لائقة. يقول “بادي”: أصبحنا «نشاهد، عبر فيديوهات مبثوثة، ابن حدّو يقوم بذبح رجل يعتبره كافرا… وعبدل وموستا وسيمو (هذه هي أسماؤهم قبل أن يسموا أنفسهم: أبو عبيدة، أبو ياسر، أبو جابر) وهم يعنفون بنات ونساء لعدم ارتدائهن الحجاب» (صفحة 49). وبجانب هؤلاء الذين التحقوا بجبهات قتال “الكفار”، هناك من بقي ببلدان أوروبا “الكافرة”، يجاهد باستعمال نفسه كقنبلة، أو بدهس المارة بسيارة، أو بالهجوم عليهم بسكين…» (صفحة 49). هؤلاء الشبان يفعلون ذلك لأنهم لا يشعرون بالانتماء إلى هذه الأرض. لقد ولدوا بها وتربوا فيها لكنهم عندما يصبحون رجالا ونساء تغلق في وجوههم الأبواب. هذا هو الجانب الذي يستغله مستقطبو هؤلاء الشبان (صفحة 49). مع هؤلاء لم يعد الأوربيون “نصرانيين” (إيروميين) بل أصبحوا “كفارا” (صفحة 51).
في “تاغزوت” بعد العودة:
بمجرد الاستقرار في “تاغزوت” سيشتري “بادي”، بطلب من “حمّوت”، زوجين من النعاج والماعز والدجاج (صفحة 67) ليبدآ في فلاحة الأرض وتربية بعض الدواجن. ولهذا كانت السنة الأولى من إقامة “بادي” و”حمّوت” في “تاغزوت” سنة للتعلم من جديد الاتصالَ بالحياة في كل مظاهرها (صفحة 70)
بعد أن تعرّف “بادي” على الشاب “ماسين” الذي حضر إلى “تاغزوت” قادما إليها من المدينة حيث تقطن أسرته، التي تملك أرضا مجاورة لأرض “بادي”، سيقبل الثاني الانضمام إلى مشروع “بادي” المتمثّل في فلاحة حقول من الأرض لإحيائها من جديد في حدود المستطاع. بعد سنة ونصف، أصبحت تلك الحقول كلها خضراوات وفواكه، حتى أن “بادي” لم يعد يقتني من السوق الأسبوعي إلا المواد التي لا توفّرها الفلاحة (صفحة 81).
في صيف السنة الثانية من استقرار “بادي” و”زوجته” بـ”تاغزوت”، ستحضر “تافسوت”، حفيدتهما، لقضاء العطلة مع جدها وجدتها. هي تنتمي إلى الجيل الثالث، حاصلة على دبلوم في الزراعة البيولوجية (صفحة 82). ستختار، هي أيضا، الاستقرار النهائي بالبدة، وستتزوج الشاب “ماسين”، وتحوّل الضيعة إلى مختبر (صفحة 123) لإجراء تجارب في مجال “الزراعة البديلة” التي تتوخى تحسين مردودية إنتاج الأرض بأقل إجهاد للتربة وأكبر اقتصاد ممكن للماء باعتماد السقي بالقطرات، مع استبعاد استعمال أية مواد غير طبيعية كالأسمدة والمبيدات. بل حتى الطاقة التي يتطلبها إخراج ماء الري من الآبار هي مستمدّة من الألواح الشمسية، كطاقة نظيفة وطبيعية. بعمل ماسين وتوجيهات “تافسوت”، تحولت “تاغزوت” إلى جنة خضراء (صفحة 90). وبذلك أصبحت البلدة معروفة بمنتوجاتها الطبيعية (البيولوجية) يتردّد إليها الناس من المدينة ومن القرى المجاورة، فضلا عن مهاجري الخارج الذين يتوافدون عليها في الصيف، لاقتناء خضرواتها وفواكهها الموسمية (صفحة 135). ولارتفاع الطلب على المنتوجات الفلاحية لـ”لتاغزوت”، تم إنشاء “تعاونية تاغزوت” لتشغيل شباب المنطقة (صفحة 123) للرفع من الإنتاج. وكان ذلك دافعا لعودة الحياة من جديد إلى “تاغزوت” بعد أن استقر بها شباب التعاونية ومن التحق بهم من قرى أخرى، فتزاوجوا وأنجبوا فعادت الحياة إلى “تاغزوت” بكل مظاهرها الاجتماعية والطبيعية (صفحة 137). مع تواصل إعمار البلدة، سيدعو “بادي” إلى ترميم وإصلاح المسجد والضريح باعتبارهما جزءا من هوية “تاغزوت”. وبرغبة من “تافسوت” ستقوم جدتها “حمّوت” بإعطاء دروس في فن الطبخ التقليدي الأصيل لفتيات القرية، مركزة على وصفات لتحضير الأطعمة اختفت أو في طريقها إلى الاختفاء، مثل وصفات تحضير 12 نوعا من الطعام فقط من حبوب الشعير، حسب ما إذا كان أخضر أو يابسا، في الوقت الذي لم تعد تُعرف من هذه الوصفات سوى وصفة إعداد الخبز (صفحة 136). هكذا ستتحول “تاغزوت” إلى مدرسة يفد عليها أبناؤها ليتعلموا الحياة والهوية والأصالة (صفحة 144). مثل طائر العنقاء الأسطوري الذي ينبعث من الرماد، عادت “تاغزوت” من رمادها بعد أن احترقت، كما علّق “بادي” (صفحة 144).
دلالة أخرى؟
قد نتعامل مع مضمون هذه الرواية حسب دلالتها المباشرة الظاهرة، دون تأويل أو بحث عن دلالة خفية مفترضة. ومما يؤكّد هذه الدلالة المباشرة الظاهرة أن الكاتب، ميمون أمسبريذ، هو نفسه ابن “تاغزوت”، وهو نفسه يعمل ويقيم ببلجيكا. فله إذن معرفة ميدانية بظروف عمال المهجر، وخصوصا المنتمين منهم إلى قريته مثل “بادي”. فتكون رواية “العودة” عبارة عن “سيرة ذاتية” للمهاجر “بادي”، لا أقل ولا أكثر.
لكن التركيز في هذه الرواية، وبشكل بارز ولافت، على ما تعرّض له “بادي” من استلاب وغسل للدماع سهّلا استقطابَه من طرف تيارات إيديولوجية ومذهبية لا تمتّ بأية صلة إلى “تاغزوت”، ولا ثقافتها ولغتها وهويتها، ولا هموم وانشغالات سكانها، جعلت منه جنديا يدافع عنها بإخلاص، ويستميت في ترويج أفكارها ومذاهبها والسفر إلى بلدان نائية لنشرها وخدمتها، قد يوحي (التركيز) بأن “تاغزوت” لا تعني فقط تلك البلدة الريفية المعروفة بإقليم الدريوش، وإنما قد تعني الهوية الأمازيغية النابعة من أرض “تاغزوت”؛ بل قد تعني حتى كل المغرب، مع ما يحمله من ثقافة ولغة وهوية أمازيغية. ويظهر هذا الوعي الهوياتي عند “بادي” بشكل بيّن عندما يشرح لماذا اختار كتابة سيرته الذاتية بلسان “تاغزوت”، فيقول: «نحن، أهل “تاغزوت”، لا نكتب عن أنفسنا. وإذا كتبنا استعملنا لغات الآخرين… هكذا نمحو آثارنا، أو نتحوّل، عبر الكتابة بلغات أجنبية، إلى آخرين. أنا لم أرد أن أكتب بلغات الآخرين. فقلت في نفسي: لماذا لا أكتب سيرتي بلغتنا حتى أحميها من الزوال، لأنها ستكون مقيّدة (من القيد) بلغتي، لغة “تاغزوت”.[…] في لسان “تاغزوت، يتوحّد الإنسان واللغة والأرض. غياب أحد العناصر يؤدّي إلى غياب العنصرين الآخريْن. فلا وجود لـ”تاغزوت” بلا وجود للغتها، ولا وجود للإنسان بلا وجود للغته وأرضه» (صفحة 148). واضح أن من لم يكتبوا عن أنفسهم بلغتهم، أو استعملوا لغات الآخرين لإنجاز هذه الكتابة، ليسوا فقط سكان “تاغزوت”، بل كل الأمازيغيين في كل المغرب، بل في كل شمال إفريقيا. وهذا ما قد يؤكّد أن “العودة” إلى “تاغزوت”، بعد نصف قرن من الاستلاب والوعي الزائف، قد ترمز إلى عودة الأمازيغيين، الذين هم المغاربة فيما يخص المغرب، إلى أمازيغيتهم، هوياتيا وثقافيا ولسانا. وبالتالي تكون دعوة التاغزوتيين من طرف “بادي” إلى استعمال لسان “تاغزوت” للكتابة كما فعل هو في تدوين سيرته الذاتية، هي دعوة لهؤلاء الأمازيغيين إلى استعمال لغتهم الأمازيغية في الكتابة بأنفسهم عن أنفسهم. ولا ننسى أن اسم “تاغزوت” علم جغرافي معروف ومستعمل في كل مناطق المغرب، وفي الجزائر كذلك، يُطلق على العديد من البلدات والقرى، وهو لفظ أمازيغي في صيغته، حتى لو افترضنا أن جذره قد يكون من أصول لغوية أخرى. ثم إن كل المغاربة الذين ظهورا في فيديوهات يقطعون الرؤوس بمناطق سورية تسيطر عليها “داعش”، وكل الذين قاموا منهم بعمليات دهس بالشاحنات واعتداء بالسكاكين في الشوارع ببلدان أوروبية، كما جاء في الرواية، لا ينتمون إلى “تاغزوت” الريفية، بل هم مغاربة ـ أو جزائريون ـ ينحدرون من مناطق مغربية مختلفة، مما قد يعني أن “تاغزوت” هي المغرب الأمازيغي. ولما حلّ “بادي” بـ”تاغزوت” بعد العودة النهائية إليها، وجدها قد «اندرست معالمها بفعل الشمس والرياح والأمطار منذ أن غادرها أبناؤها، ولم يعودوا يتعهدونها بالرعاية وتسوية أخاديدها التي حفرت أديمها» (صفحة 59). أليس هذا ما حدث للهوية الأمازيغية الجماعية للمغرب، منذ أن هجرها العديد من أبنائها وتنكّروا لها ولم يعودوا يتعهدونها بالعناية بها والدفاع عنها، مفضلين عنها هويات أجنبية زائفة بديلا عنها، حتى كادت تندرس وتحتفي بفعل مختلف عوامل التعرية الهوياتية؟
إذا تبنّيْنا هذه القراءة، فستكون “العودة إلى “تاغزوت”، بعد خمسين سنة من التيه بين مختلف الإيديولوجيات والتيارات الدينية والمذهبية، ليست مجرد عودة “بادي” إلى أرض “تاغزوت” الريفية، بل قد تعني عودة كل الذين يشبهون “بادي” في استلابهم واعتناقهم لإيديولوجيات وهويات وقضايا زائفة أجنبية، مع هجرهم لهويتهم الأصلية الحقيقية وتخلّيهم عن قضايا بلدهم الذي ينتمون إليه، (هي عودة) إلى هويتهم الأمازيغية التي تنبع من هذه الأرض المغربية التي تمثّلها “تاغزوت”. يقول “بادي”، شارحا هذا التيه وهذه العودة: «لقد كنت كالطفل الذي ضاعت منه أمّه في عرس، فبدأت أتعقّب أمهات صنعن من الكلام وليس من التراب (الأرض). أجري وراءهن وأمسك بتلابيبهن. وعندما يُدرْن وجوههن أجدهن غولات، فأهرب منهن وأدخل في نفسي. أمّ من كلام لن تكون أبدا مثل أمّ الأرض. الأرض لا تكذب لأنها لا تتكلم» (صفحة 61). فما عاشه “بادي”، بعد هجرانه لأمّه (هويته الحقيقية) التي تنبع من أرض “تاغزوت”، واستعاضتها بأمهات من كلام (مختلف خطابات القوميين والشيعيين والإسلاميين…)، هو نفس ما يعيشه المغاربة الذين تحوّلوا من جنسهم الأمازيغي إلى جنس آخر أجنبي، فأصبحوا يدّعون أنهم غير أمازيغيين بعد تشبّعهم بالخطاب العروبي، بصيغتيه القومية والإسلامية. فكما أن خطاب أصحاب التبليغ الذي تشبّع به “بادي”، والذي كان يمثل بالنسبة إليه، حسب تجربته الاستلابية، الحقيقة كاملة، هو الذي كان يباعد بينه وبين “تاغزوت” اعتقادا منه، حسب ما أقنعه به هذا الخطاب، أنه كلما ابتعد عنها اقترب أكثر من الحقيقة التي تمثلها الأمة في مقابل “الكذبة” التي تمثلها “تاغزوت” (صفحة 67)، فكذلك الخطاب العروبي، القومي والإسلامي، يدفع معتنقيه من المغاربة إلى الغلو في التنكّر لهويتهم الأمازيغية إلى درجة محاربتها، إيمانا منهم أن ذلك هو البرهان على أنهم لم يبقوْا أمازيغيين.
وإذا كان “بادي” قد رأى في “ماسين”، الناشط في جمعيات تدافع عن اللغة والهوية الأمازيغيتين، الشخص الأنسب لـ”تاغزوت” (صفحة 80)، فذلك لأنه عندما سأله في لقائه الأول به عن سبب زياته لـ”تاغزوت”، أجاب: «في السنوات الأخيرة بدأنا نهتم بمن نكون، بدأنا نسأل: من نحن؟ لماذا لسنا نحن هم نحن؟ لما ذا نحن آخرون، رغم أن لغتنا ليست لغتهم، وأرضنا ليست أرضهم، ونمط حياتنا ليس هو نمط حياتهم؟» (صفحة 75 ـ 76).
وإذا كانت العودة إلى “تاغزوت” هي عودة، هوياتيا وثقافيا ولغويا، إلى الأمازيغية بعد استعادة الوعي السليم والتخلص من الوعي الزائف، فلا يعني ذلك عودة إلى هوية ماضوية، غير مواكبة للتطور والتجديد. فقد رأينا أن الإحياء الزراعي لـ”تاغزوت” اعتمد فيه على آخر التقنيات الخاصة بـ”الزراعة البديلة”، تحت إشراف عالمة متخصصة في علم الفلاحة، وهي المهندسة “تافسوت”. وحتى عندما تم ترميم الضريح، أُنشئت به “دار للثقافة والتربية” يجتمع بها شباب البلدة لمناقشة القضايا التي تهم شؤون القرية، وتعلّم مجموعة من المهارات والمعارف. فأصبح اسم “الضريح” ليس هو “أمرابظ”، بل “دار الثقافة والتنمية” (صفحة 131). تحويل الضريح إلى دار للثقافة هو نوع من التعامل الحداثي الجديد مع عادات ومعتقدات قديمة. وهذا ما قصده “ماسين” عندما كان يشرح أن هناك جمعيات تعمل على الحفاظ على الأمازيغية ونمط الحياة الأمازيغية، ولكن ليس كأرشيف ميت، وإنما كحياة متجددة (صفحة 95). بل حتى هاجس توحيد اللغة الأمازيغية حاضر في الرواية، وذلك عندما يقول “بادي” بأن “تاغزوت”، بعد أن أصبحت قطبا سياحيا لمختلف المهاجرين التاغزوتيين، ساهمت في تحويل قلعة بابل (صفحة 145) المتعددة الألسن (مهاجرون يتحدثون الألمانية، الفرنسية، الإيطالية، الفلامية، الإسبانية، الدارجة المغربية…) إلى لسان واحد هو اللسان الأمازيغي الذي كان الزوار مضطرين إلى استعماله مستعينين بتلك التعابير القليلة التي تعلموها من والديهم أو أجدادهم بالنسبة لأبناء الجيل الثالث من المهاجرين، مثل “تافسوت” التي تنتمي إلى هذا الجيل الثالث.
ودائما في إطار هذه الدلالة الأخرى الممكنة للرواية، فقد نقرأ في العناية بالمسجد وبالضريح، الذي تحوّل إلى “دار للثقافة والتنمية”، مظهرا لما يسمّيه البعض بـ”الإسلام المغربي” الذي ليس في الحقيقة إلا “الإسلام الأمازيغي”، أي التدين كما كان يمارسه الأمازيغيون منذ انتشار الإسلام بالمغرب حتى 1956. ويظهر هذا التديّن كذلك فيما يخص ممارسة الصلاة حيث يقول “بادي” بأن فقط ـ في”تاغزوت” وقبل الهجرة إلى أوروبا ـ كبار السن و”الطلْبة” هم الذين يصلون في المسجد. أما الآخرون إما أنهم لا يصلون بتاتا أو يصلون بمنازلهم (صفحة 21). ولم يكن ذلك يثير ملاحظات أو يخلق مشكلا بين من يصلي ومن لا يصلي.
أعرف أنه من المغري الاعتراض بأن هذه القراءة الممكنة لدلالة “العودة” تعبّر عما يرغب كاتب هذه السطور في أن تقوله الرواية، وليس ما تقوله بالفعل. لكن ماذا سنفعل بالتطابق، الذي يكاد يفقأ العين، بين عودة “بادي”، بعد ضلال إيديولجي وهوياتي عاشه لمدة نصف قرن، إلى “تاغزوت”، مع ما صاحب ذلك من إحياء لهذه البلدة وبعثها، كالعنقاء، من رمادها بعد أن كادت أن تحترق، كما وصف عملية ذلك الإحياء، وبين ما يدعو إليه المدافعون عن الأمازيغية من عودة المغاربية الضالين والتائهين، هوياتيا وإيديولوجيا، إلى هويتهم الأمازيغية الجماعية للمغرب وللمغاربة، مع ما يتطلّبه ذلك من إحياء للغة الأمازيغية بالعمل على نشرها بين المغاربة عبر تدريسها الإجباري الموحّد؟
اللغة والأسلوب:
رغم أن الأحداث، بتسلسلها وترابطها ومفاجآتها، عنصر أساسي مهم في الكتابة الروائية، إلا ما يضفي على هذه الأحداث الجمال والتشويق والمزيد من الواقعية، هو طريقة حبكها وكتابتها باعتبار أن الرواية ليست مجرد إخبار بأحداث وقعت، بل هي فن وإبداع وخلق للجمال، وإثارة لمشاعر السموّ والرضى والإعجاب. وهذا ما نحسّ به وندركه ونحن نقرأ مذكّرات “بادي”، دون أن يكون لدينا خيار آخر، لأن الكاتب هو الذي يفرض علينا هذا الإحساس والإدراك.
إذا عرفنا أن الإنتاج الكتابي بالأمازيغية لا زال في بداياته، يمارسه “مقاومون” و”مناضلون” مهووسون بحب الأمازيغية، وفي غياب لتعلّم مدرسي للكتابة الأمازيغية، فإن كل من يكتب نصا بالأمازيغية فهو في الحقيقة كاتب متقدّم عن زمانه، أي الزمان المدرسي للأمازيغية. أما من يكتب رواية فسيكون كاتبا مبدعا، ونابغة ملهَما. وهذا ما يصدق على ميمون أمسبريذ، وغيره من رواد الرواية الأمازيغية. فبدون عتاد أمازيغي مدرسي، يخلقون، بشغفهم بالأمازيغية، هذا العتاد عبر الكتابة الروائية. فغياب تدريس الأمازيغية ـ أقصد التدريس الجدي والحقيقي، وليس الشكلي الكاذب ـ هو ما يجعل الإنتاج الكتابي الأمازيغي لم يخرج بعدُ من “المرحلة الانتقالية” من الشفوية إلى الكتابة، مع كل ما يصاحب ذلك من تجريب واستمرار لحضور الشفوي في الكثير من الكتابات الأمازيغية التي لا تختلف عن هذا الشفوي إلا في كونها مدوّنة بحروف وليست منطوقة بأصوات. «لكن عندما نقرأ للكاتب ميمون أمسبريذ، يتكوّن لدينا انطباع، بل قناعة، أن كتاباته ليست “بداية” ولا “مرحلة انتقالية” للأمازيغية من الشفوية إلى الكتابة، وإنما هي كتابة تُبرز الأمازيغية كما لو كانت لغة تُمارس بها الكتابة منذ قرون، كلغة كاملة ومكتملة، قادرة على التعبير عن كل الوضعيات والأحداث والمشاعر والأفكار المغرقة في التجريد، كلغة لا تختلف في شيء عن اللغات التي أنتجت تراثا ثقافيا وأدبيا، غنيا وراقيا. […] والأمازيغية التي يكتب بها تمثّل السهل الممتنع: هي سهلة لأنها أمازيغية معروفة ومتداولة، لكنها في نفس الوقت صعبة لأنه لا أحد ـ كما يبدو ـ من غير أمسبريذ بقادر على استعمالها الكتابي بنفس الأسلوب الرائع والبديع». هذا ما كتبته (انقر هنا) في أكتوبر 2015 حول مجموعة من نصوصه القصصية (لقد أصدر هذه القصص في 2023 تحت عنوان: “الماء الأسود”) والشعرية.
وحتى أقرّب القارئ من هذا الأسلوب الجميل والبديع الذي يكتب به ميمون أمسبريذ، أنقل إلى العربية، فيما يلي، مقتطفات من الرواية، كنماذج معبّرة عن الأسلوب الروائي للكاتب، مع ما يقتضيه هذا النقل من “خيانة” للنص الأمازيغي الأصلي الذي لا تخلو منه أية ترجمة:
ـ عندما وصل “بادي” إلى بلجيكا للمرة الأولى، كان أول ما استرعى انتباهه، كفارق بارز بين سكان هذا البلد وسكان “تاغزوت”، هو أن الأولين تحكمهم “الساعة” في حين أن الأخيرين تحكمهم “الشمس”. يقول الكاتب على لسان “بادي”، للتعبير عن هذا الاختلاف في إدراك الزمن: «سكان هذه البلاد لا ينجزون أشغالهم تبعا لموقع الشمس في السماء: فحتى لو كان النهار قصيرا (كما في فصل الشتاء)، فإن “الساعة” تجبره على أن يكون طويلا. يخصمون من الليل ويزيدون في النهار، كمن يخصم من العرض ليزيد في الطول! في ساعات متقدمة من الليل تجدهم يملأون أنفاق المترو: هؤلاء ينزلون، أولئك يركبون، يتجارون كالنمل في مسالكها. لا أحد يهتم بالآخر، لا أحد ينظر إلى الآخر، لا أحد يعرف الآخر» (صفحة 9). «في “تاغزوت”، الحياة ليست مجزأة إلى أقسام كما في بلجيكا: قسم للعمل، قسم للموسيقى، قسم للعب… ما هو مجزأ في بلجيكا هو وحدة مندمجة في “تاغزوت”» (صفحة 10).
ـ في أول لقائه بالقوميين، يقول الكاتب، على لسان “بادي” في وصف حي لهؤلاء: «يتكلمون بقناعة، وبحرقة، عيونهم متقدة كأن بها نارا، وفي حناجرهم مرارة وإصرار» (صفحة 23).
ـ وفي حديثه عن الجهاديين والمتطرفين، يقول عنهم في تعبير يلخّص ما يطمحون إلى تحقيقه: «لا يعتبرون أنفسهم أبناء الأرض، بل أبناء السماء. لقد ضاقت بهم الأرض حتى تمنوا أن يصعدوا إلى السماء أو يُنزلوا السماء إلى الأرض حتى تكون هذه السماء هي أرضهم، أرض ليست من تراب: أرض الدين الحقيقي، حيث لا يعود الناس هم الناس أنفسهم، يعيشون بأنفسهم ولأنفسهم» (صفحة 48).
ـ وقد لاحظ “بادي”، وهو يتأمل صغير الشاة يكبر ونبات الجلباب ينمو، أن الناس، بعد أن لم يعودوا يمارسون زراعة الأرض، لا يرون من الحياة (ما هو حي) إلا نهايتها، أي ما هو ناضج وجاهز للاستهلاك، ولا يرون كيف وصل إلى مرحلة النضج. وقد عبّر الكاتب عن ذلك بقوله: «في بلجيكا، الخروف ليس حياة (ما هو حي)، هو فقط كتلة من اللحم. الجلبان ليس نباتا ينمو، هو طعام فقط. في بلجيكا، العيون لا ترى سوى المرحلة الأخيرة من مسلسل الحياة. في “تاغزوت” نرى الحياة من بدايتها حتى نهايتها» (صفحة 70).
ـ بمناسبة التحضير لحفل زفاف “تافسوت” و”ماسين”، يقول الكاتب على لسان “بادي”، مقارنا بين عرس اليوم وعرس السنين الماضية: «ليس هناك من قضى على العرس التقليدي الأصيل مثل بدعة مموّن الحفلات traiteur» (صفحة 92). «عرس اليوم يشرف عليه أناس (يقصد الندُل) مثل “مخازنية” بملابسهم التي لا تشبه ملابس أصحاب العرس، كلامهم جاف ووجوههم صفيقة مثل حراس السجناء. المدعوون ينتظرون متى يُقدّم الطعام ليأكلوا ثم ينصرفوا. هذا هو عرس اليوم […] في السنين الأخيرة، انضاف “النشيد” الذي يمارسه من يدعون أنهم المسلمون الحقيقيون، فمنعوا الرقص والغناء وأحلّوا مكانهما “النشيد” الديني، الذي يؤدّيه منشدون يأتون من خارج “تاغزوت”، بألبسة أفغانية» (صفحة 93 ـ 94). «هكذا كان عرسنا قبل أن نصبح غير ما نحن عليه، قبل أن يحوّله أبناء اليوم إلى معرض للأطعمة، […] عاد العرس جلوسا وأكلا وكلاما يتلاشى كالرغوة بمجرد خروجه من بين الشفاه. منذ أن تخلينا عن العرس التقليدي الأصيل، جفّفنا ينبوع الفن، فغدونا لا نملك شيئا: تركنا خيراتنا وبدأنا نقترض من الآخرين» (صفحة 99). «…عرس اليوم هو معرض للأطعمة، يوزعها ندُل لا يتكلمون، لا يعرفون أحدا من الحاضرين ولا يعرفهم أحد من هؤلاء، ذوو لباس موحد مثل لباس رجال المخزن، خطواتهم سريعة كجنود “محلّة” مخزنية كالتي كان المخزن يرسلها لمعاقبة القبائل المتمردة. هذه “المحلة” الجديدة هي التي يسمونها “تريتور” traiteur، قضت على التضامن الذي كان ميزة العرس التقليدي، أسكتت الحناجر (حناجر الغناء)، وأخرست البنادير، وأقعدت الراقصات، تخنق أنفاس الرجال في صدورهم. […] نكتفي بالجلوس، نأكل، نستمع إلى أصوات تنبعث من آلة تتكلم (ترديد أغاني مسجلة)، أو إلى “مديح” غريب عنا يسمونه “النشيد” (الديني) كأننا في مأتم» (صفحة 101)
ـ وفي وصفه لضربات البندير أثناء العرس الذي أُقيم بالطريقة التقليدية الأصيلة، بلا مموّن للحفلات ولا “نشيد”، يقول الكاتب على لسان “بادي”: «الضربات على البندير للنساء المسنّات كانت عميقة، قوية وممتلئة كأنها لا تنبعث من البندير نفسه وإنما من أعماق الأرض، لا نسمعها بالأذن فقط، بل بكل جوارحنا» (صفحة 100).
ـ في وصفه لشجرة الخورب السامقة رغم نقص الأمطار، يقول: «شجرة الخروب الناطحة للسماء بأوراقها الوارفة كأنها تسخر من الجفاف» (143)
ـ في حديثه عن اختيار سكان “تاغزوت”، الذين غادروها، أن يُنقلوا إليها عند وفاتهم ليُدفنوا بها، يقول: «أينما مات أحد التاغزوتيين بعيدا عن “تاغزوت”، ينقل أهله جثمانه ليدفن بمقبرتها. هذا ما جعل مقابر “تاغزوت” تبقى “حية” في حين أن كل ما حولها “ميت”. تاغزوت” خالية من سكانها لكن مقابرها عامرة. مساكن “تاغزوت” تتساقط، لكن مقابرها تنتصب. لا يستطيع أبناء “تاغزوت” أن يسكنوا بها وهم أحياء، لكنهم يعودون للسكن بها وهم أموات» (صفحة 60)
من يقرأ النصوص الأمازيغية؟
قلت، أعلاه، بإن من يكتب نصا بالأمازيغية فهو في الحقيقة كاتب متقدّم عن زمانه، أي الزمان المدرسي للأمازيغية. وأقول إن من يقرأ نصا بالأمازيغية، فهو كذلك متقدّم عن نفس الزمان المدرسي، لأن الكتابة والقراءة عملية مدرسية واحدة، حتى لو أن من تعلّم القراءة والكتابة قد لا يكتب ويكتفي بممارسة القراءة. لقد ظهرت أولى الكتابات الأمازيغية مع السبعينيات من القرن الماضي. وبعد نصف قرن لا زال ليس هناك تراكم للإنتاج الكتابي الأمازيغي. لماذا؟ لعدم وجود قراء لهذه الإنتاجات، مما يعني غياب الطلب عليها. ولماذا؟ لغياب الأمازيغية، مرة أخرى، من المدرسة. لهذا يبقى عدد قراء النصوص الأمازيغية يشكّلون قلة من “المقاومين” و”المناضلين”، مثلهم مثل “المقاومين” و”المناضلين” الممارسين للكتابة. وهذا مأزق للأمازيغية: فحتى تنتقل إلى المرحلة الكتابية، يجب أن يكون هناك متابعة قرائية للإنتاج الكتابي الأمازيغي. وحتى يتحقّق هذا وذاك، لا بد من تدريس الأمازيغية لتواصل إعادة إنتاجها بالاستعمال الكتابي بعد أن أصبح استعمالها الشفوي غير قادر على ضمان إعادة إنتاجها عبر الأجيال كما كان ذلك منذ العشرات من القرون. والحال أن هذا التدريس ـ أقصد التدريس الجدي والحقيقي، وليس الشكلي الكاذب ـ غائب. وهو ما يستمر معه غياب كتابة الأمازيغية وقراءتها خارج ما هو “مقاومة” و”نضال”.
وحتى الإرادة الصلبة، مع ما تعبّر عنه من فعل “مقاومة” و”نضال”، ومن حب للأمازيغية وتعلق بها، الحاضر بشكل قوي لدى كتاب الأمازيغية وقرائها، لا تستطيع أن تغيّر كثيرا من الواقع المتردي للأمازيغية، ما دام أنها لا تستطيع أن تفرض تدريسها، بالشكل السليم والمطلوب. فما ننساه عندما نطالب، منطلقين من “إرادوية” صادقة، محبّي الأمازيغية باستعمالها الشفوي والكتابي في كل المواقف والسياقات حسب الحاجة إلى ذلك، هو أننا لسنا “أحرارا” في أن نتحدث بالأمازيغية ونكتب بها ونقرأها. فهناك دولة هي التي تمنعنا من ممارسة ذلك التحدث وتلك الكتابة والقراءة. وهذا المنع لا تمارسه هذه الدولة بشكل مباشر كأن تقمع من يتحدث بالأمازيغية أو يكتب بها أو يقرأها. وإنما يظهر هذا المنع في كون مؤسسات الدولة لا تستعمل الأمازيغية، مما يستتبع أن المواطن الذي يتوجه إلى إحدى هذه المؤسسات، كمقر للشرطة أو الدرك أو محكمة…، لقضاء بعض أغراضه ويستعمل الأمازيغية في تواصله مع مسؤولي هذه المؤسسات، فقد تتعطل مصالحه التي من أجلها جاء إلى تلك المؤسسة لأن أولئك الموظفين لا يفهمون ما يقول إذا كانوا دارجفونيين. وهذا ما يضطره إلى استعمال الدارجة أو الفرنسية. فيكون هذا المواطن قد مُنع من استعمال لغته، فقط لأنه لا يستطيع الحصول على ما جاء من أجله باستعماله للأمازيغية. ونفس الشيء يصدق على الكتابة: فمن يحرّر طلبا بالأمازيغية موجها إلى إحدى البلديات من أجل الحصول على رخصة ما، سوف لن يحصل على جواب سواء بالرفض أو الموافقة. وهكذا ستتعطل مصالحه، مما سيثنيه عن الاستعمال الكتابي للأمازيغية لأغراض إدارية. فيكون قد مُنع من هذا الاستعمال دون أن يتدخل أحد لممارسة هذا المنع. فهنا أيضا، ما ينقص لرفع هذا “المنع” هو تدريس الأمازيغية حتى تكون لغة تستعملها مؤسسات الدولة، يتحدثها ويكتبها ويقرأها موظفو هذه المؤسسات بعد أن يكونوا قد درسوها لسنوات كافية لإتقان الحديث بها وكتابتها وقراءتها.
وكمثال على هذا المنع غير المباشر لاستعمال الأمازيغية والكتابة بها، هو هذا المقال نفسه. فلا الدولة ولا أحد غيرها منعني من أن أكتبه بالأمازيغية، وخصوصا أنه يخص الأمازيغية نفسها. فلماذا لم أكتبه بالأمازيغية؟ لنتخطى مسألة أنني لم أدرسها بالمدرسة ولا أعرف بالتالي كتابتها بشكل صحيح وسليم، ونكتفي بمسألة أنني عندما أكتبه بالأمازيغية، ودون أن يتدخل أحد لمنعي من ذلك، يطرح سؤال حول أين سينشر (ليست جميع المنابر تقبل نشر النصوص الأمازيغية) ومن سيقرأه. فيكون الجواب: يقرأه قلة من “المقاومين” و”المناضلين” من أصحاب الإرادة الصلبة. وهكذا نبقى في دائرة “الإرادوية” التي لا تستطيع تغيير الوضع بشكل كبير لصالح الأمازيغية أمام وجود الدولة. فما تحتاجه الأمازيغية اليوم ليس الإرادة القوية لمحبيها والمدافعين عنها، رغم أهمية ذلك، بل إرادة الدولة. وهذه هي الحلقة المفرغة للأمازيغية: ليس هناك قراء أتوجه إليهم بالكتابة الأمازيغية، مما يدفعني إلى الكتابة بالعربية حول الأمازيغية نفسها. وينتج عن هذا أن الكتابات الأمازيغية، كالرواية، تبقى بلا متابعة نقدية باللغة الأمازيغية نفسها، مما لا يساهم في تطوير وتوسيع الإنتاج الكتابي الأمازيغي. واستحضار الدولة، بخصوص مسألة كتابة وقراءة الأمازيغية، يعني أن موضوع الأمازيغية هو، في عمقه، موضوع سياسي، مرتبط بغياب الإرادة السياسية لدى الدولة لتدريس جدي وحقيقي وموحّد للأمازيغية، حتى لا تبقى فقط لغة “المقاومين” و”المناضلين” من المدافعين عنها، بل لغة الدولة التي تضطلع هي بالدفاع عنها وفرضها بمؤسساتها وإداراتها.

كاتب ومفكر وباحث ومناضل أمازيغي منحدر من منطقة الريف ومدير نشر جريدة تاويزا. ألف العديد من الكتب والمقالات التنويرية القيمة