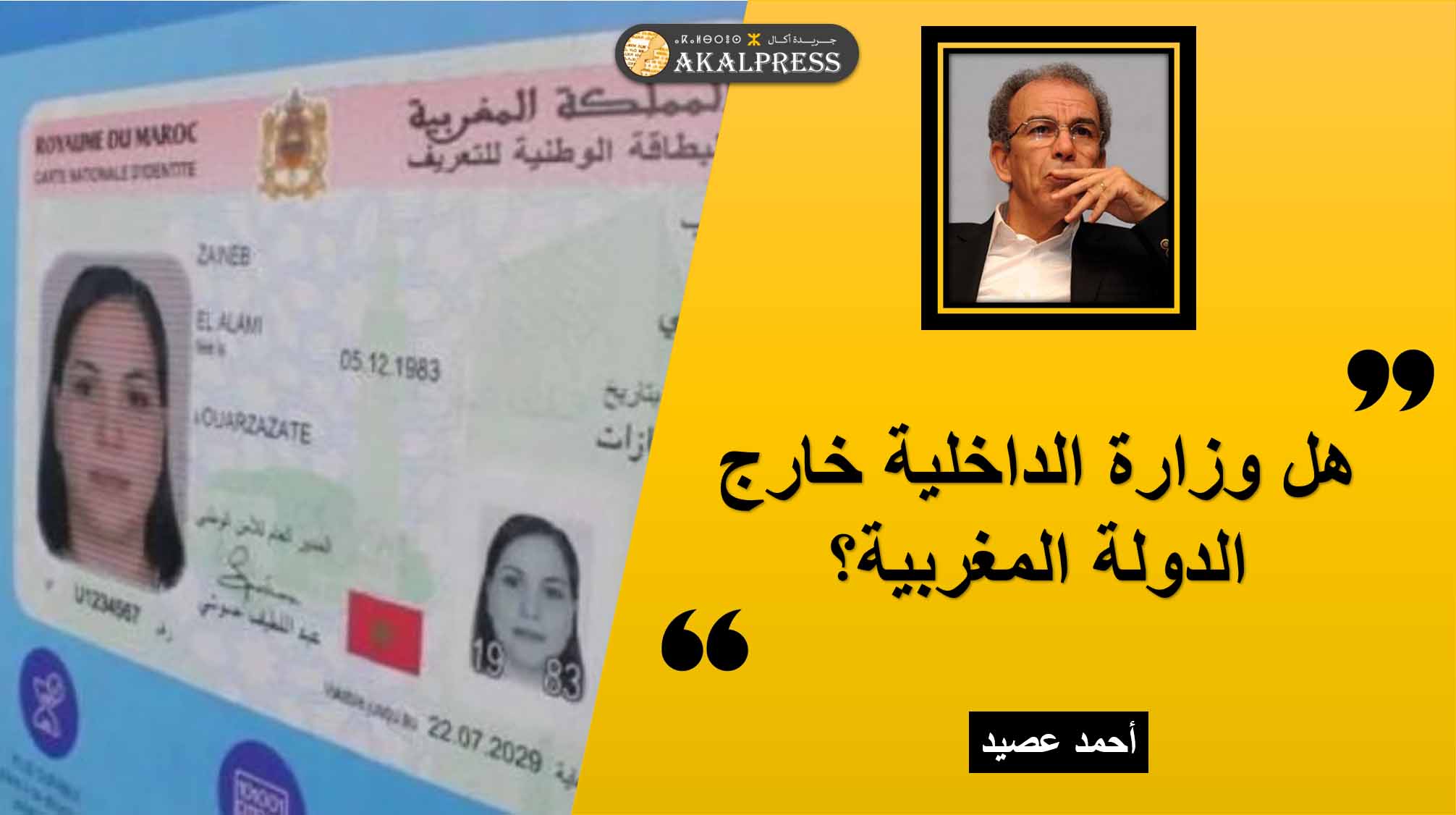أحمد عصيد يكتب عن ظاهرة نبش القبور وتخريبها في تاريخ الإسلام
مارس البشر الكثير من الأفعال الوحشية ضدّ بني جنسهم في حياتهم بغرض التنكيل والإذلال، وأحيانا ما كان يتم الانتقام من خصومهم حتى بعد رحيلهم عن هذا العالم، وذلك بالتسلط على قبورهم أو النصُب والشواهد التي وُضعت لذكراهم بهدف التشفي والانتقام، وإذا كانت هذه الظاهرة قد عرفتها كل الثقافات البشرية في الماضي، فلعلها استمرت في عصرنا لدى اليمين المتطرف والنازية في الغرب، كما استمرت عند المسلمين بسبب الحروب الطائفية وبروز الحركات الدينية المتشدّدة.
ولعل الجهل بتاريخ الإسلام، أو تجاهله المقصود عند البعض، يؤدي إلى عدم معرفة جذور الكثير من السلوكات الحالية، كما يؤدي إلى تكرار الأخطاء، فنبش القبور أو تدنيس شواهدها وتخريبها، بل حتى العبث بمحتوياتها فعلٌ شنيع له تاريخ طويل في حياة المسلمين، وقد بدأ مع بداية الصراع السياسي بينهم حول الخلافة. ورغم أن الإسلام في نصوصه لم يدعُ إلى تخريب قبور المسلمين أو المساس بها كما نهى عن التمثيل بالجثث، إلا أن المسلمين مارسوا ذلك العمل الشنيع في فترات مختلفة من تاريخ دولة الخلافة، بل استمر ذلك إلى اليوم كما حدث في العديد من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط خاصة بعد سنة 2011 كما سنبين في هذا المقال.
تطلعنا المراجع الكبرى للتاريخ الإسلامي وخاصة “تاريخ الطبري” و”الكامل في التاريخ” لابن الأثير و”البداية والنهاية” لابن كثير و”تاريخ الخلفاء ” للسيوطي و”الإمامة والسياسة” لابن قتيبة و”المنتظم في تاريخ الملوك والأمم” لابن الجوزي وغيرها، على معطيات كثيرة تؤكد بأن المسلمين قد مارسوا تخريب القبور ونبشها والتمثيل بالجثث، وتظهر هذه المراجع بوضوح بأن هذا العمل الشنيع تمّ لسببين اثنين:
1) الخلافات والحروب السياسية على السلطة.
2) الصراع الحاد بسبب اختلاف المذاهب الفقهية والكلامية.
نبش القبور إبّان الدعوة الإسلامية:
وقبل أن نتطرق إلى نبش القبور وإتلافها بسبب الصراع السياسي الذي اندلع بمقتل عثمان فيما سمي بـ”الفتنة الكبرى”، التي قتل فيها عدد من الصحابة الكبار وكان لها ما بعدها إلى اليوم، نشير إلى أن نبش القبور وإتلافها قد عرف في عهد الدعوة النبوية وخلال الغزوات الأولى ضدّ غير المسلمين، وهو ما نتج عنه استنتاج الفقهاء من المذاهب الأربعة بأن نبش قبور المسلمين لا يجوز “لما فيه من هتك لحرمة الميت”، وأن نبش قبور “الكفار” وتخريبها جائز إذا كان للمسلمين مصلحة في ذلك، واعتمد الفقهاء في هذا الموقف حديث بناء مسجد النبي في “صحيح البخاري” إذ يقول إنّ الرسول : “أمر بقبور المشركين فنُبشت، عندما أراد بناء المسجد.”
بل إنّ بعض الفقهاء يرون بأن نبش قبور “الكفار والمشركين” لا يشترط أن يكون لغرض فيه مصلحة أو حاجة لدى المسلمين، حيث قال ابن بطال “لا حرج فيه لأن المشرك لا حرمة له حياً أو ميتاً”، ويضيف في تفسير حديث بناء مسجد النبي “والقبور التي أمر النبي بنبشها لبناء المسجد كانت قبورًا لا حرمة لأهلها، لأن العرب هنالك لم يكونوا أهل كتاب، فلم يكن لعظامهم حُرمة”، وأضاف ابن حجر العسقلاني في هذا الباب: “وأما الكفرة فلا حرج في نبش قبورهم إذ لا حرج في إهانتهم”. ويجعلنا هذا الموقف نفهم الأسباب التي تجعل المسلمين ينبشون قبور بعضهم البعض في لحظات الخلاف الإيديولوجي الحادّ، حيث يعتبرون من خالفوهم “كفارا” و”مشركين” بسبب الخلاف في الرأي والتوجّه والمذهب كما سيأتي من تفصيل في الفقرات الموالية.
وفي مرحلة الدعوة النبوية الأولى جاءت بعض المصادر بخبر عن محاولة قريش أثناء حروبها مع النبي نبش قبر أمه آمنة بن وهب، وذلك عندما خرج جيش قريش لملاقاة جيش المسلمين في غزوة “أحد”، حيث نزلت قريش بمنطقة تدعى “الأبواء” فقالت هند بنت عتبة لأبي سفيان: “لو بحثتم قبر أم محمد فإنها بالأبواء”، غير أن أبا سفيان كان أكثر حكمة عندما أجاب “لا تفتحوا هذا الباب لئلا تفتح بنو بكر موتانا”.
الفتنة الكبرى وكيف صار نبش القبور تقليدا:
ولعل من أقدم الوقائع التي أوردتها كتب تاريخ الإسلام وعلى رأسها “تاريخ الطبري” ما حدث في دفن عثمان بن عفان بعد مقتله، حيث يشير المؤرخون إلى أن جثته ظلت ملقاة ثلاثة أيام “لم يقدروا فيها على دفنه” بسبب رفض الأنصار الصلاة عليه أو دفنه في مقابر المسلمين، ما أدى إلى دفنه بعد ذلك سرّا في مكان يدعى “حشّ كوكب” وهو مكان “كان اليهود يدفنون به موتاهم”، ويقول المؤرخون إنه دُفن ليلا بسبب ترصّد المسلمين الثائرين للجنازة حتى يرجموها بالحجارة، كما ظل مكان دفنه مجهولا بين النخيل إلا من بعض الصحابة خشية أن يُنبش قبره ويُعبث به، وفي لحظة دفنه حاولت إحدى بناته الصراخ والبكاء فنهرها القوم وقالوا: “إنا نخاف عليه من هؤلاء الغوغاء أن ينبشوه”، وقد انتظر أهله عدة سنوات لكي يتقوى حُكم بني أمية ويسيطروا على البلاد كلها ويتمكنوا أخيرا من ردّ الاعتبار لمدفن عثمان.
هذه الواقعة المفجعة صارت بداية لكثير من التقاليد السيئة التي استمرت طوال تاريخ الإسلام إلى اليوم، حيث أوصى الكثير من الصحابة الذين خاضوا في الخلاف السياسي بأن يُدفنوا ليلا خشية نبش قبورهم، بل إن بعضهم دُفن في قبر مُموّه وذلك لأن حملة التكفير والتكفير المضادّ كانت على أشدّها ولم تخمد أبدا.
ومن الأمور الغريبة ما جاء في كتاب “الجهاد” لابن المبارك من أن معاوية بن أبي سفيان أول حكام بني أمية أمر واليه على المدينة بنبش قبور الصحابة من قتلى معركة “أحد”، والعذر الذي أدلى به آنذاك هو حاجته إلى إجراء عين ماء بتلك الناحية، وكان قد مرّ على دفنهم هناك أزيد من نصف قرن.
ولعله من سخرية الأقدار أن قبر معاوية هذا هو أول قبر سيتعرض للنبش والتخريب بمجرد صعود الدولة العباسية واستيلائهم على عاصمة الأمويين دمشق، وذكر ابن الأثير في “الكامل في التاريخ” أن عبد الله بن علي قائد جيوش العباسيين “أمر بنبش قبور بني أمية في دمشق، فنُبش قبر معاوية بن أبي سفيان (…) ونبش قبر يزيد بن معاوية (…) ونُبش قبر عبد الملك ” وهكذا حتى نبشوا جميع قبور خلفاء بني أمية، ويضيف ابن الأثير بأن عبد الله بن علي جلد بقايا رفاة هشام بن عبد الملك “بالسياط وصلبه وحرّقه وذرّاه في الريح”.
بداية “فتنة الحنابلة” والصراع المذهبي:
وفي عهد الخليفة العباسي المتوكل، وبسبب الأحقاد التي تراكمت بين العباسيين والعلويين، فقد استمر نبش القبور وتخريبها حيث جاء في “تاريخ الأمم والملوك” للطبري أن هذا الخليفة بعث بجنوده عام 236 هجرية إلى قبر الإمام الحسين بن علي في كربلاء، وأمرهم بتدميره ونبشه، بل إنه تجاوز ذلك حين أمر جنوده بأن يحرثوا بالبقر مكان الضريح، ويقوموا بسقيه حتى لا يبقى له أثر، وذلك للحيلولة دون أن يصير مزارا يُتبرك به. ويُرجع المؤرخ هذا السلوك المتعصب للخليفة إلى انجراره وراء مذهب الحنابلة الذين كانوا متشدّدين في موضوع المقابر والأضرحة، حيث بمجرد أن تولى الحكم بعد الخليفة الواثق قام بتقريب الإمام أحمد بن حنبل وإكرامه والسماح لأتباعه الحنابلة بنشر مذهبهم المتشدّد، “فصار لهم جيوش من العوام”. وهو ما أكده ابن الجوزي كذلك في “المنتظم في تاريخ الملوك والأمم”.
وقال ابن الأثير في وصف “فتنة الحنابلة” متحدثا عن سنة 323هـ “وفيها عظم أمر الحنابلة ببغداد وقويت شوكتهم، وصاروا يكبسون دور القواد والعامة، وإن وجدوا نبيذا أراقوه، وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة الغناء، واعترضوا في البيع والشراء ومشْي الرجل مع النساء والصبيان، فإن رأوا ذلك سألوه عن الذي معه من هو، فإن أخبرهم وإلا ضربوه وحملوه إلى صاحب الشرطة وشهدوا عليه بالفاحشة، فأرهجوا بغداد، وركب صاحب الشرطة ونادى في جانبي بغداد لا يجتمع من الحنابلة إثنان، ولا يناظرون في مذهبهم (…) فلم يُفد فيهم وزاد شرّهم وفتنتهم، (…) وكان إذا مرّ بهم شافعي المذهب أغروا به العميان حتى يكاد يموت”.
وقد اضطرّت فتنة الحنابلة هذه خليفة المسلمين آنذاك أبا العباس محمد الملقب بـ”الراضي بالله” أن ينشر منشورا تحذيريا ضدّهم جاء فيه حسب ابن الأثير: “لعن الله شيطانا زين لكم هذه المنكرات وما أغواه، وأمير المؤمنين يقسم بالله قسما جهرا يلزمه الوفاء به، لئن لم تنتهوا عن مذموم مذهبكم ومُعوجّ طريقتكم ليوسعنكم ضربا شديدا وقتلا وتبديدا، وليستعملن السيف في رقابكم، والنار في منازلكم”.
ويبدو أن كل الجهود التي بذلها الحكام لم تتمكن من إخماد الفتنة المذهبية بين المسلمين، وقد أشار بعض المؤرخين إلى أن من أسباب هذه الظاهرة ارتباط المذهب الفقهي بسياسة الدولة وارتباط الفقه بالمناصب وأجورها ومكاسبها الدنيوية، ما أدى إلى احتداد التنافس بين الفقهاء ومحاولتهم الطعن في بعضهم البعض، وتهييج العوام بهدف القضاء على خصومهم من المذاهب الأخرى، مما جعل النقاش الفقهي يخرج عن حدود الحوار الفكري والخلاف المذهبي العلمي إلى السبّ والقذف والتكفير والتحريض والتناحر بالأسلحة والتباغض الشديد الذي كان يصل ذروته بنبش القبور وجلد الجثث وإحراقها.
ولعل من المشاهد الدرامية ما فعله الحنابلة بالعلامة المفسّر والمؤرخ الكبير محمد بن جرير الطبري، حيث جاء في كتاب “الوافي بالوفيات” لصلاح الدين الصفدي أنهم حاصروه في بيته وضيقوا عليه إلى أن هدموا عليه الدار فمات تحت الرّدم، ودفنه أهله في ما تبقى من بيته خوفا من نبش قبره.
وذكر ابن الأثير أنه في سنة 443 هـ، نبش الحنابلة قبر الإمام موسى بن جعفر الكاظم ونهبوا مقامه ثمّ أحرقوه، يقول: “قصدوا مشهد باب التبن فنقبوا في سوره فدخلوا ونهبوا ما في المشهد من قناديل ومحاريب ذهب وفضّة وسُتور وغير ذلك. فلمّا كان الغد، كثر جمعهم فقصدوا المشهد، وأحرقوا جميع الترب والآراج، واحترق ضريح موسى، وضريح ابن ابنه محمّد بن عليّ الجواد، والقُبتان الساج اللتان عليهما، وجرى من الأمر الفظيع ما لم يجرِ في الدنيا مثله”.
بين الحنفية والشافعية:
وما لبثت الفتنة أن اشتدّت بين الحنفية والشافعية أيضا لنفس الأسباب المشار إليها، وقد كتب ياقوت الحموي في وصف الخلاف بين الشافعية والحنفية بمدينة “أصفهان” في كتابه “معجم البلدان” قائلا :”وقد فشا فيها الخراب في هذا الوقت لكثرة الفتن والتعصب بين الشافعية والحنفية والحروب المتصلة بين الحزبين، فكلما ظهرت طائفة نهبت محلة الأخرى وأحرقتها وخربتها، لا يأخذهم في ذلك إلٌّ ولا ذمة”.
ومن الغرائب التي ذكرها عبد الوهاب حسن في مقاله “الصراع بين المذاهب السنية، دروس مستفادة” ما يبرز مقدار ما بلغته العداوة والتكفير بين الشافعية والحنفية حيث كانوا يرفضون دفن الموتى في مقابر بعضهم البعض، ومن أمثلة ذلك ما أجّج الفتنة الثالثة بين الحنابلة والشافعية ببغداد سنة 573 هجرية ، حيث بعد وفاة خطيب جامع المنصور محمد بن عبد الله الشافعي، امتنع الحنابلة من دفنه بمقبرة الإمام أحمد بن حنبل؛ لأنه شافعي وليس حنبليًّا ، فوقعت مواجهات دموية بين أتباع المذهبين اضطر معها الخليفة العباسي المقتفي للتدخل شخصيا لإيقافها.
وكذلك ما رواه نقلا عن المؤرخين مما حدث زمن الوزير الخوارزمي مسعود بن علي المُتوفى سنة 596 هجرية ، والذي بنى مسجدا للشافعية كان أكبر من مسجد مجاور للحنفية ما أدى إلى غضب الحنفية فأحرقوا الجامع الجديد، واندلعت فتنة عنيفة مدمّرة بين الطائفتين.
وفي سنة 567هـ ، ذكر قيام الفقيه الصوفي نجم الدين الخبوشاني الشافعي الأشعري بنبش قبر المقرئ أبي عبد الله بن الكيزاني المدفون بقرب ضريح الإمام الشافعي بمدينة مصر قائلا عنه “هذا رجل حشوي لا يكون بجانب الشافعي” وأخذ رفاته ودفنها في موضع آخر، فكان ذلك سببا لصراع خطير مع الحنابلة.
ولم يسلم قبر النبي نفسه من محاولة النبش، وذلك في عهد السلطان نور الدين زنكي، حيث جاء في كتاب علي السمهودي “وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى” أن هذا السلطان اضطر إلى تقوية حجرة النبي بالرصاص والآجر من الجهات الأربع حماية لها، بعد أن كادت تتعرض للنهب والسرقة.
بين السّنة والشيعة:
ولم ينحصر الخلاف والصدام في هذه الفترة بين أهل السنة بل امتدّ إلى الشيعة أيضا، قال ابن الأثير في حوادث سنة 443هـ:”في هذه السنة تجددت الفتنة بين السنة والشيعة، وعظمت أضعاف ما كانت قديما، وسببها أن أهل الكرخ (من الشيعة) صنعوا أبراجا كتبوا عليها بالذهب “محمد وعلي خير البشر”، وأنكر السنة ذلك (…) وقتل رجلٌ هاشميٌ من الشيعة فحمله أهله على نعش وطافوا به واستنفروا الناس للأخذ بثأره، ثم دفنوه عند أحمد بن حنبل فلما رجعوا من دفنه قصدوا المشهد فدخلوه ونهبوا ما فيه من قناديل ومحاريب من ذهب وفضة، فلما كان الغد اجتمعوا وأضرموا حريقا، فاحترق كثير من قبور الأئمة وما يجاورها من قبور بني بويه، وقصدوا إلى خان الفقهاء الحنفيين فنهبوه، وقتلوا مُدرّس الحنفية أبا سعد السرخسي وأحرقوا الخان ودور الفقهاء وامتدّت الفتنة إلى الجانب الشرقي”.
انتقال الفتنة إلى المغرب:
وجدير بالذكر أنه في هذه الفترة بالضبط من القرن السادس الهجري حمل محمد ابن تومرت عقيدة الأشعرية والتعصب المذهبي من الشرق إلى المغرب فأغرق مراكش في الدماء، واستمرت فتنة الموحّدين بعد وفاته في مجازر مرعبة عقودا طويلة نتج عنها مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتدمير الكثير من المنشآت السابقة على الموحدين.
هكذا لم تنجُ قبور ملوك المرابطين التي خُربت على يد الموحدين، ولا قبور ملوك الموحدين التي تم نبشها من طرف المرينيين أيضا، جاء في كتاب “وصف إفريقيا” للحسن الوزان أن الموحدين لما اقتحموا مراكش بعد حصار دام أشهرا فتكوا بالناس وقتلوا ما تبقى من نسل الأمراء المرابطين، واستباحوا المدينة لمدة ثلاثة أيام، يبطشون بالذكور والاناث بمختلف أعمارهم، ومن المشاهد الفظيعة ما قام به عبد المومن بن علي شخصيا عندما أخذ ” آخر من تبقى من أبناء ابراهيم بن تاشفين ـ ويسمى إسحاق ـ وذبحه بيده بكل شراسة”. وقد عُـرف عن عبد المومن عداءه الشديد للمرابطين، ولهذا تسلط على قبور أمراء المرابطين فنبشها واستهدف المساجد، حيث هدم جميع مساجد مراكش وبنى مكانها مساجد أخرى، لأنها حسب اعتقاد الموحدين “منحرفة عن القبلة”، وحاول محو كل أثر يرمز إلى مجد المرابطين، بل إنه حوّل القبة المجاورة لمسجد ابن يوسف إلى مرحاض يقضي به الناس حوائجهم. وكلف فرقة “البوعديين” بتعقب جميع آثار المرابطين وهدمها. كما لم يدع كنيسة أو بيعة من بيع اليهود إلا هدمها، وألغى الجزية وأرغم اليهود على الدخول في الإسلام عنوة أو الرحيل إلى “دار الحرب” أو ضرب رقابهم، وكانت تلك فاتحة عهد مظلم لليهود المغاربة مع الموحدين.
وقد جاء في كتاب “المعجب في تلخيص أخبار المغرب” لعبد الواحد المراكشي ما يلي : ” وبعد دخول عبد المومن مراكش طلب قبر أمير المسلمين علي بن يوسف، وبحث عنه أشد البحث فأخفاه الله وستره”. وسبب عدم عثوره عليه ما ذكره عباس بن ابراهيم المراكشي صاحب كتاب “الإعلام بمن حلّ بمراكش من الأعلام” من أن علي بن يوسف قبل وفاته في رجب 537 هـ أمر بدفنه بين مقابر المسلمين دون علم أحد، وكأنه كان يحدس ما تخبئه الأيام له ولدولته وعائلته.
وذكر ابن عذارى في “البيان المُغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب” أن الموحدين نجحوا في العثور على جثة تاشفين بن علي بن يوسف واستخراجها من مدفنها حيث عمدوا إلى إحراقها وحملوا الجمجمة إلى “تينمل” وعلقوها هناك على غصن شجرة .
وكما تدين تُدان، فقد تعرضت مقابر الموحدين بعد أفول دولتهم إلى النبش والتخريب، كما تعرضت رفاتهم إلى التمثيل والحرق والصلب، جاء في كتاب “السلوك لمعرفة دول الملوك” لأحمد بن علي المقريزي:”نبش عمال بني مرين قبور خلفاء الموحدين وأخرجوا عبد المومن بن علي وابنه يعقوب المنصور من قبريهما، وقطعوا رأسيهما وضربت أعناق من كان بجبل “تينمل” وصلبوا بمراكش وأُخذت أموالهم”.
هجمة المغول وخراب بغداد:
وبعد تدهور أحوال الخلافة في بداية العصر المملوكي خلال القرن السابع الهجري تعرضت دار الخلافة لزحف المغول المدمّر، حيث يروي المؤرخون ومنهم فضل الله الهمذاني في كتابه “جامع التواريخ” أن المغول بعد اقتحامهم بغداد أقدموا على أعمال التقتيل والتخريب ستة أسابيع، فدُمرت القصور والمساجد والأضرحة وقبور الخلفاء وكل مظاهر الحضارة بغية الحصول على القباب الذهبية والنصُب الثمينة والأواني النفيسة. كما تم تخريب بيت الحكمة ونهب الكتب وإتلاف المصنفات الثمينة التي تراكمت على مدى قرون عديدة.
وروى ابن كثير أنه تمّ حرق جامع المدينة الكبير، ومشهد موسى الكاظم، والمدرستين، التاجية وبنفشا، وكذا القباب والأضرحة وكل المعالم الكبرى والظاهرة بالمدينة.
ويقول المؤرخ “ظهير الدين الكازروني” واصفاً بغداد بعد زيارته لها عقب الغزو: “وافيتُها بلدة خالية، وأمة جالية، ودمنة حائلة، ومحنة جاثمة، وقصوراً خاوية، وعراصاً باكية، وقد رحل عنها سكانها، وبان عنها قطانها، وتمزّقوا في البلاد، ونزلوا بكل واد”.
غُلو الصفوية وانتهاك قبر أبي حنيفة:
وفي القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي ذكر المؤرخون ما قام به سلاطين الدولة الصفوية الشيعية حيث سارعوا إلى الأخذ بثأرهم من السنة بمجرد احتلالهم بغداد وإعمال السيف في سكانها، وتخريب مساجدها ونبش قبور أهل السنة، وتحكي المصادر السنية والشيعية عما فعله الشاه إسماعيل الصفوي، عندما بادر إلى نبش قبر الامام أبي حنيفة النعمان في الأعظمية، وإخراج ما وجدوه من عظام الإمام الكبير وبقاياه، ولمزيد من الانتقام والتشفي فإنهم وضعوا أشلاء كلب أسود مكان الرجل في مدفنه، بل إنه في عهد الشاه عباس الأول حفيد اسماعيل الصفوي، جُعِل من مقام أبي حنيفة في الأعظمية “مرحاضا” للعامة، ولم يقف هذا التخريب عند قبر أبي حنيفة، فلقد تجاوزوه إلى الصوفي الكبير عبد القادر الكيلاني الذي خربوا قبره بدوره مما اضطر عائلته إلى الفرار ومغادرة العراق إلى الشام.
ويبدو من هذه الوقائع والأحداث الخطيرة أن المذاهب الدينية في الإسلام قد تحولت بالتدريج إلى ما يشبه الديانات المستقلة القائمة بذاتها، فصار من يخالفها في الرأي “كافرا” بها و”مارقا” يستحق البغض والنبذ والانتقام.
الصفحة الدموية للوهابية:
وفي القرن الثامن عشر الميلادي فتحت صفحة دموية جديدة بظهور الحنابلة الجُدُد ممثلين في أتباع محمد بن عبد الوهاب بصحراء نجد بجزيرة العرب، حيث أدى التحالف بين هذا الشيخ الحنبلي وأحد قطاع الطرق بجزيرة العرب وهو محمد بن سعود إلى أحداث رهيبة قتل بسببها خلق كثير، فبعد انتشار الدعوة الوهابية بعقود عبر الغزو والتقتيل حدث في بداية القرن التاسع عشر يوم 22 أبريل 1802م أن قاد سعود بن عبد العزيز آل سعود حملة شرسة على كربلاء لإبادة “الروافض” كما يسميهم الوهابيون، فقتل الرجال والنساء والأطفال والعجائز والمرضى كما روى صاحب كتاب “بغية النبلاء في تاريخ كربلاء”.
وهو ما رواه بفخر واعتزاز كذلك مؤرخ الدولة السعودية الأولى والثانية، عثمان بن بشر النجدي الحنبلي، في كتابه «عنوان المجد في تاريخ نجد»: حين كتب “إنّ سعود قصد أرض كربلاء بالجيوش المنصورة والخيل العتاق المشهورة، ونازل أهل بلد الحسين، فحشد فيها المسلمين (يعني الوهابيين)، وتسوّروا جدرانها، ودخلوها عنوة، وقتلوا غالب أهلها في الأسواق والبيوت”.
وكما كان يفعل الغزاة طوال التاريخ الإسلامي ربط سعود خيله في صحن ضريح الحسين وأمر بإعداد القهوة باستعمال أوانيه ، وأمر بتخريب القباب ونهب المعدات ونبش الضريح وتخريبه ومصادرة كل ما فيه.
يصف المؤرخ والسياسي البريطاني ستيفن همسلي لونكريك Stephen Hemsley Longrigg فظائع الوهابيين في كربلاء، في كتابه «أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث»، فيقول: «قتلوا من دون رحمة جميع من صادفوه، كما سرقوا كل دار، ولم يرحموا الشيخ ولا الطفل، لم يحترموا النساء ولا الرجال، فلم يسلم أحد من وحشيتهم» .
ويبدو أن قبر النبي وحجرته لم يسلما هذه المرة من همجية آل سعود، حيث ذكر المؤرخون بعد قرابة عامين من مذبحة كربلاء، هجوم سعود على المدينة المنورة، بنفس أسلوبه الوحشي، وقبل ذلك قام بالهجوم على الطائف وإبادة أهلها سنة 1803، ويصف المؤرخ أحمد بن زيني دحلان في كتابه “خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام” ما قام به الوهابيون من مجازر في الطائف فيقول: «ولمّا دخلوا الطائف قتلوا الناس قتلاً عاماً، واستوعبوا الكبير والصغير، والمأمور والأمير، والشريف والوضيع، وصاروا يذبحون على صدر الأم الطفل الرضيع، وصاروا يصعدون البيوت يُخرجون من توارى فيها، فيقتلونهم. فوجدوا جماعة يتدارسون القرآن فقتلوهم عن آخرهم حتى أبادوا من في البيوت جميعاً، ثم خرجوا الى الحوانيت والمساجد وقتلوا من فيها… يقتلون الرجل في المسجد وهو راكع أو ساجد، حتى أفنوا هؤلاء المخلوقات”.
وتوجه سعود بعد ذلك في نفس السنة إلى مكة فاستولى عليها بدون قتال لكن ذلك لم يشفع لأهلها، حيث وصف أحمد بن زيني دحلان ما أقدم عليه الوهابيون في مكة قائلاً: «بادروا بهدم المساجد ومآثر الصالحين، فهدموا أولاً ما في المعلى من القبب فكانت كثيرة، ثم هدموا قبة مولد النبي (ص)، ومولد أبي بكر، ومولد سيدنا علي، وقبة السيدة خديجة، وتتبعوا جميع المواضع التي فيها آثار الصالحين… وهم عند الهدم يرتجزون ويضربون الطبل ويغنون… وبالغوا في شتم القبور التي هدموها. حتى قيل بأن بعضهم بالَ على قبر السيد المحجوب. وبعد ثلاثة أيام من عمليات التدمير المنظّمة، مُحِيت الآثار الإسلامية في مكة المكرمة”.
بعد أن فرغ سعود من تدمير أضرحة مكة وقبابها ومقابر أعلامها، توجه نحو المدينة واقتحمها وأباحها لجنوده فاغتصبوا نساءها وبناتها وتوجه إلى المسجد النبوي، فقام بنهبه والاستيلاء على كل ما فيه، وقد روى أحد المؤرخين وهو حسن الركي في كتابه “لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب” تفاصيل ذلك النهب والتخريب.
وبعد عقود طويلة جاء دور عبد العزيز بن سعود ليكمل في بداية القرن العشرين أعمال النهب والتخريب في نفس المكان في مقبرة البقيع بالمدينة، كما اتجه إلى مكة ونهب قبر خديجة بنت خويلد زوجة النبي، وقبر أمه آمنة بنت وهب، فهدمهما ومحا أثرهما.
الصراع الطائفي بعد غزو العراق:
ولم يتوقف مسلسل نبش القبور وتخريبها في عصرنا بل استمر بنفس الوحشية السابقة، وهكذا أدى سقوط نظام صدام حسين وغزو العراق من طرف القوات الأمريكية إلى انبعاث الصراع الطائفي من جديد بين الشيعة والسنة، فكان تخريب قبر الإمام أبي حنيفة مرة أخرى باستعمال القصف المدفعي من طرف الميليشيات الشيعية يوم 10 أبريل 2003م ، كما تم تخريب الجامع والبيوت المحيطة به. وفيما بين 2003 و2013 عرف العراق كذلك تخريب وهدم الكثير من الحسينيات والمساجد والأضرحة الشيعية والكنائس المسيحية والمعابد الإيزيدية من طرف التيار السلفي.
ولعل من أخطر الوقائع التي حدثت بهذا الصدد والتي أجّجت الصراع الطائفي إقدام المجموعات المسلحة السنية المتطرفة على تفجير الحرم العسكري في سامراء الذي يضم الإمامين الشيعيين علي الهادي والحسن العسكري والسيدتين حكيمة أخت الإمام الهادي ونرجس أم الإمام المهدي وأيضاً تفجير رمز الإمام “المهدي المنتظر”.
سوريا والربيع الدامي:
وفي سوريا عرفت ساحة المعارك بعد 2011 عودة رهيبة لتقاليد نبش القبور وانتهاك حرمات الموتى، حيث تبادل المتحاربون من جيش النظام ومقاتلي “جبهة النصرة” من الإخوان والسلفيين وكذا الميليشيات الشيعية، انتهاك مقابر بعضهم البعض، والتمثيل بالجثث بنفس الطريقة القديمة التي عرفتها بداية التاريخ الإسلامي.
وتدلّ وحشية التسلط على القبور والنصب على مقدار رغبة هؤلاء المقاتلين في محو آثار أعدائهم ومحو ذاكرة الأجيال القادمة، وكذا التشفي والانتقام حتى بعد موت خصومهم. وقد ساهم الجيش التركي بدوره حليف “الإخوان” و”الدواعش” في معركة المقابر حيث تفوّق باستعمال الجرافات لتخريب مقابر السوريين والكُرد، ومعها مقابر الأقليتين العلوية والإيزيدية في “إدلب” و”عفرين”، ومن المقابر التي تم هدمها مقام الشخصية الثقافية الكُردية نوري ديرسمي التي تحظى بتقدير كبير لدى الكُرد. وكانت حصيلة الهجوم على المقابر في هذه المنطقة جرف أكثر من سبع مقابر للأقلية الدينية الإيزيدية، يعود بعضها إلى أكثر من 400 سنة، وتخريب أربعة عشر من معابدهم، وتخريب ونبش القبور والمزارات الدينية المقدسة كما تم جرف وتدمير وتفجير مقابر للسكان المحليين بحجة توسيع الطرقات، أو إقامة قواعد عسكرية. وتم تخريب وسرقة محتويات الكنائس في منطقة “عفرين”.
ولم تسلم مقابر الصحابة القدامى مرة أخرى من التخريب والنبش خلال الحرب السورية الحالية حيث قامت الميليشيات بنبش وتخريب قبر الخليفة عمر بن عبد العزيز سنة 2006. وكذا قبر الصحابي حجر بن عدي في شهر ماي 2013، حيث اُخرِج صاحب القبر من مكانه بعد أن هدموا مقامه بالجرافات. وتمّ تفجير مقام الصحابي عمار بن ياسر في الرقة في غشت من نفس السنة 2013. وتمّ انتقام المجموعات المتطرفة من تمثال الشاعر الفيلسوف أبي العلاء المعري بتخريبه ببلدة “معرّة النعمان” سنة 2018.
ويبدو أن هذا الصراع الدموي في العراق وسوريا لم يعُد مجرد صراع بين ميليشيات متمردة وحلفائها ونظام بحلفائه، بل إن امتداد الحرب إلى المقابر والمزارات والأضرحة تتم عبر استحضار كل التاريخ الطويل من الصراع المذهبي والعسكري بين العرب الأمويين والفرس والعباسيين والعلويين والشيعة الصفويين والكُرد والعثمانيين الأتراك، إنه التاريخ يعيد نفسه في سياق جديد وبأبعاد ورهانات جديدة، لكنه يدلّ على عدم تطور العقليات أو تأثرها بقيم العصر الحديث.
ولم يسلم شمال إفريقيا:
أما في شمال إفريقيا فقد فتحت سنة 2011 بما عرفته من اضطرابات باب تخريب المقابر ونبشها من جديد من طرف التيار السلفي المتشدّد، حيث بمجرد شعور هذا التيار ببعض الحرية، بعد سقوط مبارك في مصر وانهيار نظامي القذافي وبنعلي، بادر إلى تخريب عدد من الأضرحة الصوفية في البلدان الثلاثة، وتدنيس مقابر الشخصيات الثقافية والفكرية والأدبية التي تتعارض مع توجهه، ومن الأضرحة التي تم تخريبها قبر المصلح التونسي الكبير الطاهر الحداد الذي يلقب بـ “محرّر النساء”، حيث قاموا بطلاء رخام قبره باللون الأسود، وتخريب عبارة “شهيد الحق والواجب” التي نقشت عليه، وامتدت أيادي المتطرفين إلى مقبرة المسيحيين بسيدي بوزيد مباشرة بعد رحيل بنعلي وتمت بعثرة عظامها في العراء، وفي سنة 2013 بعد اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد اضطرّ الجيش التونسي إلى تأمين الحراسة لقبره بعد تهديدات بنبشه من طرف جماعات إسلامية. وتقول بعض المنابر الصحفية التونسية إن عدد الأضرحة والمقابر التي تم هدمها من طرف التيار السلفي من سنة 2011 حتى الآن تصل إلى 30 ضريحا.
وفي ليبيا حدث نفس الشيء حيث تم هدم ضريح الشيخ الصوفي الكبير عبد السلام الأسمر من طرف مجموعة من المتطرفين، وتمّ إحراق المكتبة الملحقة بالضريح الكائن في بلدة زليتن الليبية. كما تعرضت الكثير من الأضرحة في طرابلس للهدم والإحراق من طرف نفس المجموعات.
ولم تسلم مقابر وأضرحة تومبوكتو ومكتباتها العريقة في شمال مالي من نفس المصير الذي طالها من طرف ميليشيات “أنصار الشريعة” وفروع “القاعدة”، ما شكل صدمة كبيرة لسكان تلك المناطق.
وفي المغرب تناقلت وسائل الإعلام خبر تدنيس وتخريب مدافن يهودية بأسفي سنة 2012، كما تمّ تخريب قبور مسيحية ويهودية بمدينة طنجة سنة 2014، ما أدى إلى احتجاجات رؤساء الجاليات المعنيّة والزعامات الروحية والبعثات القنصلية ومنظمات حقوقية وثقافية كثيرة.
ومن الشخصيات السياسية التي تم انتهاك قبورها بعد دفنها عبد الرحيم بوعبيد وادريس بنزكري وأخيرا النصب التذكاري للفقيد عبد الرحمان اليوسفي بطنجة. وكلهم شخصيات يسارية، وفي كل مرة يُعلن عن “فتح تحقيق” في الموضوع دون محاسبة أحد على هذه الجريمة النكراء.
خاتمة:
ليس الغرض من استعراض هذا المسلسل الطويل من العنف ضدّ الأموات في تاريخ المسلمين مجرد تحريك المواجع، بل نرمي من ورائه إلى معرفة جذور سلوكات تعتبر من مساوئ الماضي، بينما ما زال البعض يعتقد أنها صدفة من الصدف لا علاقة لها بثقافة المسلمين وأنماط تدينهم، في الوقت الذي يعتبرها البعض الآخر ومنهم حنابلة اليوم، تقاليد عريقة تدخل في صميم عقديتهم.
ويظهر هذا أن السكوت عن طابوهات التاريخ لا يساهم في تصحيح سلوكات الحاضر، وأنه لا ينفع إلا التربية الصحيحة، التي قوامها المعرفة والحرية والحق في الاختلاف، واحترام الإنسان حيا أو ميتا.

أحمد عصيد كاتب وشاعر وباحث في الثقافة الامازيغية وحقوقي مناضل من اجل القضايا الأمازيغية والقضايا الإنسانية عامة