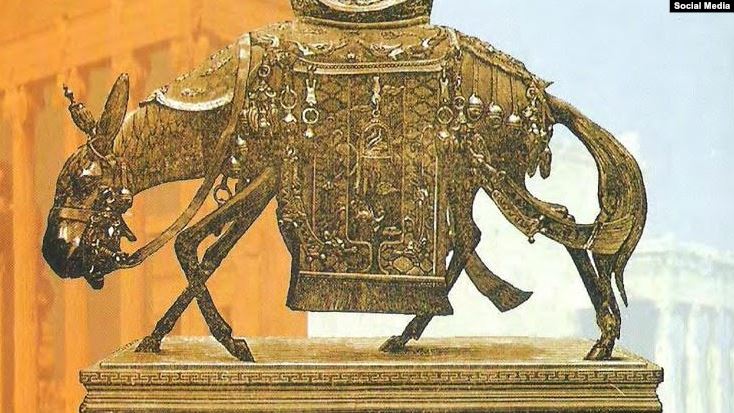رواية “متاهات فريد زمانه” لخالد الملاحظ
أصدر الأستاذ خالد الملاحظ رواية بالعربية تحت عنوان: “متاهات فريد زمانه”، طبع سليكي أخوين بطنجة، 2023، 187 صفحة من الحجم المتوسط. يروي فيها الكاتب المعاناة “السيزيفية” – معاناة تتكرّر بلا نهاية لها ـ للشاب “فريد” منذ أن غادرت أسرته في 1944، وهو في سن الرابعة عشرة، دوارها بـ”طاحونة الروابي” غير بعبد عن الحسيمة، بمنطقة الريف المغربي، إلى أن مات بفرنسا في 2007، دون أن يحقّق أمنيته في معانقة أمه ولقاء ما تبقى من أسرته، ولا في العودة إلى الريف التي كانت تشكّل حلمه الجميل.
أحداث الرواية:
بعد أن قَتَل الأبُ (والد فريد) الإقطاعيَّ “الحاج موحند” الذي كان عاملا لديه في فلاحة أرض سبق أن كانت ملكا للأول، كان مضطرا، رفقة زوجته “أرقية” وولديه فريد ومحمد الصغير وبنته “زوليخة”، إلى الفرار من المنطقة تجنّبا للانتقام منه ثأرا للقتيل. كان الأب يوهم كل من يسأله عن وجهته أنه متوجه إلى مولاي إدريس زرهون، لضليل من قد يتعقّبونه من أجل الثأر. لكن وجهته الحقيقية كانت “كبدانة” في اتجاه الجزائر للعمل في ضيعات المعمرين الفرنسيين.
عد أن أوصلهم الشيخ “حيدوش ن عمر” إلى الضفة الشرقية من نهر ملوية، عقب أيام قضتها الأسرة في ضيافة “عزي عياذ” وزوجته “خاتشي ثرايثماس”، كما كان يناديهما فريد، سيقودهم “الحاج عمار” إلى وهران، ثم دوار “أعْويوَه” حيث قضوا ليلتهم الأولى عند “حميدوش” ابن عمة “أرقية” والدة فريد. اكتروا مسكنا صغيرا مع مرحاض مشترك بين العديد من الأسر التي تسكن نفس الحي. حصل فريد وأبوه على عمل لدى الفرنسيين. سيموت “محمد الصغير”، ذو الثماني سنوات، بمرض التيفوئيد.
بعد أن أنقذ فريد “شارلوط” Charlotte الجميلة، بنت “مسيو جوزيف”، من السقوط من أعلى الحصان الذي كانت تمتطيه، تم تحويله إلى العمل بإسطبل الخيول وتعيينه مرافقا لـ”شارلوط” وأخيها “طوني”، في نزهاتهما.
في 1952، ستطلب “الغالية” من فريد، التي تعرّف عليها منذ أن زارتهم لتقديم العزاء في وفاة أبيه الذي عثر عليه، في 1947، جثة هامدة بأحد الأزقة، مرافقتَها إلى وهران لزيارة بعض الأقارب. ورغم أنها جزائرية إلا أنها تتقن اللهجة الريفية لكونها أرملة ميمون التوزاني من قبيلة آيت تسافت الريفية. في وهران وجدا في انتظارهما فتاة شابة قدمتها “الغالية” على أنها “جميلة” بنت أختها. بعد دخولهما إلى دار بحي “سيدي الهواري”، وجدوا هناك أشخاصا رحبوا بفريد، وكشفوا له بأنهم اختاروه ليكون عضوا معهم في جبهة مقاومة المستعمر لكونه ينتمي إلى ريف المقاوم الأكبر عبد الكريم الخطابي، وحددوا له الأماكن التي عليه أن يقوم بتفجيرها لقتل الفرنسيين الذين يرتادونها. وقبل حتى أن يستوعب ما يسمع، داهمت الشرطة المنزل، ففر غيره من الحاضرون من النوافذ، وضمنهم “الغالية” رغم عمرها الستيني. كانت الشرطة تسأله أثناء الاستنطاق عن علاقته بـ”جميلة بوحيرد” وبتنظيم “جبهة التحرير الجزائرية”. هنا سيعرف أن الشابة “جميلة” هي عنصر في هذا التنظيم، وهي “جميلة بوحيرد” التي استقبلتهم بمحطة الحافلات وقادتهم إلى منزل الاجتماع. ورغم أنه حكى لرجال الأمن كل الحقيقة، باستثناء سرقة دجاج “مسيو جوزيف” والأماكن التي كانت تعتزم “جميلة” ورفاقها وضع متفجرات بها، إلا أنه سيلقى به، ودون أية محاكمة، في السجن بولاية “بسكرة” على تخوم الصحراء، والذي لن يغادره إلا بعد استقلال الجزائر في 1962. بعد خروجه من السجن الذي قضى به عشر سنوات كاملة، سيعلم أن أمه، التي كانت تعتقد أنه مات، قد تزوجت بـ”حميدوش”، وأن أخته “زليخة” تزوجت بصديقه “البشير” وأنجبا ابنا سمياه “فريد” تخليدا لذكرى فريد الذي اعتقد الجميع أنه قد مات.
بعد عمله في ميناء وهران كحمّال ينقل حقائب المسافرين إلى البواخر المتجهة نحو أوروبا، سيجد نفسه، بعد أن استيقظ ذات مرة من غفوة غالبته وهو يستريح داخل إحدى تلك البواخر، بعيدا عن وهران وسط أمواج البحر الذي تمخر الباخرة عبابه. في “مارسيليا” سيتدخّل السيد “جون”، الذي سبق أن حمل حقائبه في وهران، لدى شرطة الحدود التي صرّح لها بأن “فريد” هو خادمه المسمى “محمد الوهراني”، وقد ضاعت منه أوراق هويته. بعد تحرير محضر بالضياع، منحوه بطاقة هوية مؤقتة باسم “محمد الوهراني”. سيركب القطار وينزل بمحطة “ليل”، ومنها إلى “لنس” Lens للعمل في مناجمها. هنا سيتعلم النضال النقابي، ويصبح مدافعا شرسا عن حقوق العمال بعد تنظيمه لإضراب ناجح.
في 1982 ستغلق مناجم “لينس” ويستفيد من تقاعد نسبي. فكان له الوقت الكافي ليثقف نفسه بقراءة الكتب وتتبع الأخبار في الجرائد. في 1992 سينتقل إلى دار العجزة حيث قضى ما تبقى من عمره إلى أن وافته المنية في 17 أكتوبر 2007، تاركا على طاولة “سبسي” والده، وظرفا يوصي فيه بالتبرع بجثته لكلية الطب، وظرفا ثانيا يحتوي على مذكراته التي هي هذه الرواية، مع وصية تخصيص مداخيلها إن طبعت لمرضى السرطان بالريف. وهو ما وفى به الكاتب بإعلانه، كملاحظة أخيرة على الصفحة الثانية من غلاف الكتاب، أن «كل إيرادات هذا العمل الأدبي مهداة لجمعية “أصدقاء مرضى السرطان بالحسيمة».
عندما يصنع قبحُ الأحداث جمالَ الرواية:
بما أن الكتابة الروائية هي فن وإبداع جمالي، فإن عرض أحداثها، تلخيصا أو حتى إسهابا، لن يجعلنا نحس بما فيها من جمال وروعة. حقيقة هناك أحداث تقع وتتعاقب لتصنع “متاهات فريد…”، لكن أسلوب حكيها الروائي هي التي تجعل من هذه “المتاهات” شيئا رائعا وجميلا، رغم قبح المآسي والآلام والمعاناة والأحزان التي تشكّل روح هذه “المتاهات”. فمما يميّز هذه الرواية ـ وهو ما قد يصدق على كل كتابة روائية ـ أنها حوّلت قبح الأحداث إلى جمال فني بديع وممتع. ولهذا لم يساير الكاتب انتظارات القارئ الذي يترقّب أن يجتمع فريد من جديد بعائلته ويعود الجميع إلى الريف الذي ظل يهيم بحبه منذ أن فارقه في 1944، كنهاية سعيدة لـ”متاهاته”، على شكل “حلّ” لـ”عقدة” القصة كما في الرواية الكلاسيكية. فبدل هذه النهاية السعيدة، جعل الكاتب معاناة فريد تتفاقم وتشتدّ مع الأيام، كأنه بطل تراجيديا إغريقية حيث تتضافر الآلهة والبشر على مباغتته بوضع عراقيل في طريقه أشد من التي اعتقد أنه قد تخطّاها وتغلّب عليها، وهو ما تجسّده لوحة غلاف الكتاب للفنان كريم أمسيرو، والتي تمثّل فريدا يحاول التسلق إلى الأعلى كأنه يريد الخروج من بئر المعاناة، مُمْسِكا بالأحجار المثبتة في الجدار، لكنها تنقلع من مكانها وتتساقط إلى الأسفل ليعود هو إلى قاع بئر العذاب والمعاناة، مثل “سيزيف” يعاود، إلى ما لانهاية، حمل الصخرة إلى قمة الجبل لتدحرج من جديد إلى الأسفل. فعكس ما كان ينتظره القارئ من “مسك الخاتمة”، يُربكه الكاتب بأسئلة بقيت بلا جواب، رغم أن هذا القارئ كان يتوقّع أن يأتي هذا الجواب قبل انتهائه من قراءة الرواية:
ـ من قتل والد فريد الذي عثر عليه مقتولا في الشارع؟ هل هو اقتصاص منه لقتله “الحاج موحند”، نفّذ عليه حتى بعد رحيله من الريف للإفلات من هذا القصاص؟ أم “حميديوش”، ابن عمة زوجته “أرقية” والدة فريد، هو الذي اغتاله حتى يتزوج هذه الأخيرة كما كان يرغب في ذلك قبل أن تتزوج وقبل أن يهاجر هو إلى الجزائر؟
ـ كيف عرفت صديقته “يطّو” أنه “فريد الريفي” ـ وهو الذي لم يسبق له منذ أن حل بفرنسا بهوية “محمد الوهراني” أن أخبر أحدا بأنه ريفي من المغرب ـ كما أفصحت عن ذلك عندما كتبت بأحمر الشفاه على مرآة الحمام: «كنت رائعا أيها الريفي» (صفحة 162) وهي تغادر شقة فريد حيث قضت معه الليلة، ثم اختفت عن الأنظار ولم يسبق أن التقاها فريد مرة أخرى رغم أنه لم يألُ جهدا في البحث عنها؟
ـ من هي تلك السيدة الفرنسية الأنيقة التي تقدمت عند “جيسموند” Gismonde، المسؤولة بدار العجزة حيث مات فريد، والتي سبق أن تحدّثت عن حالة هذا الأخير في برنامج تلفزيوني مخصص لـ”دور العجزة والمتخلى عنهم”، لتمنحها مساهمة مالية من أجل طبع مذكرات فريد، والتي عندما استفسرتها عن اسمها لتدوّنه في سجل المساهمات المالية، طلبت منها بأن تسجل مساهمتها باسم “فريد الريفي؟” هل تكون هي “يطّو”؟ أم تكون هي “شارلوط”، بنت “مسيو جوزيف” الذي كان يشتغل عنده فريد بالجزائر قبل أن يُعتقل، والتي سبق أن رسمت قبلة على خده هو وحده كوداع له من دون باقي الخدم عندما انتقلت إلى وهرات لمتابعة دراستها الثانوية؟
إلا أن الأسئلة التي تحيّر القارئ أكثر هي:
ـ لماذا لم يذهب فريد للقاء أمه وشقيقته “زوليخة” بعد خروجه من السجن، وهو ما ظل يتمنّاه ويحلم به إلى أن مات؟ لماذا اختار ألا تعرف أمه أنه حي يرزق، مفضّلا أن تستمر في اعتقادها الجازم بأنه مات؟
ـ لقد كان حبه واشتياقه للريف بلا حدود، بل يمكن القول إن هذا الريف كان بالنسبة إليه بمثابة علة وجوده. يقول عن هذا الحب والاشتياق: «ويحدث أحيانا بالسوق الكبير (بمدينة ليل الفرنسية) الذي تنشطه أغلبية من الجاليات المغاربية، أن أصادف من يتحدث بالريفية، فأسير وراءه كمخبر مكشوف، أسترق السمع وألتقط الخبر دون أن أثير انتباه المتحدثين. سعدت كثيرا يوم سبني أحد المهاجرين بالريفية، وكان يعتقد، كما الجميع هنا، أنني جزائري. لم أجبه كما لو أني لم أفهم حديثه العنيف. بالمقابل كنت أود أن أحضنه وأبادله تحية أهل الريف، فقمعت هذا الشعور وفضلت الدعاء لله بأن يمطرني سبا أكثر! فقد كنت عطشانا للارتواء من عيون لغتي الأم “الريفية”» (صفحة 151 ـ 152). لكن ما الذي منعه، عندما كان عاملا بفرنسا، أن يزور الريف، أو حتى أن يصارح الريفيين هناك بأنه ريفي مثلهم، وهو الذي يتعذّب ولها بهذا الريف وحنينا إليه؟
في الحقيقة، كان فريد واعيا بهذه الأسئلة الأخيرة، ويملك الجواب عنها عندما كتب يقول: «تتذبذب نرجسيتي بين سديم التيه الوجودي وهلوسات شخصية الورياغلي المارد القابع بداخلي، ذاك الذي حين يركبه الزهو يعتقد أنه العالِم بكل شيء. فلا أنا أعرف من أنا؟ أو ما أبحث عنه بالضبط؟ أو ما أريده تحديدا؟ كل ما أحس به أنني متأرجح دون توازن بين الصلابة في التحدي ومواصلة درب التصدّي، وبين الهشاشة والشك حين تساورني مشاعر القلق. أجادل مرآة الروح إن كنت أنا دوما ذاك الريفي المشاكس الذي تمرن على الهروب، وعشق التخفي، وآمن بان العودة إلى الوطن ضرب من الاستحالة. صعب جدا أن تخلص إلى إجابة شافية حين تكون أنت التائه وأنت الدليل» (صفحة 180 ـ 181). كان يعرف إذن أنه “تائه”، ويعرف أنه هو وحده يستطيع أن يرشد نفسه إلى الطريق الذي يخرجه من التيه.
ألا تكون هذه الأسئلة التي بقيت معلقة، جزءا من القبح الذي صنع به الكاتب جمال الرواية؟
جمالية اللغة والأسلوب:
للنجاح في تحويل قبح الأحداث إلى جمال روائي، فني بديع، استعمل الكاتب خالد الملاحظ لغة عربية طوّعها روّضها فأصبحت مِلك يمينه، يُجبرها على أن تعطي أكثر مما تملك، مما جعلها مكتنزة في المعنى ودسمة في التعبير والأسلوب، وهو ما أبرزها في هذه الكتابة الروائية أجمل وأبهى وأكفأ مما هو معهود فيها، كعروس تزيّنت بأفخر الحُليّ ولبست أجمل الأزياء بمناسبة زفافها. وهذا هو الإبداع: تحويل ما هو عادي (اللغة العربية) إلى شيء استثنائي، وما قد يكون متخيَّلا (قصة فريد) إلى شيء واقعي نحس به كأننا نعيشه.
لقد عرف الكاتب كيف يوظّف معطيات تاريخية تنسجم مع سياق الأحداث، مثل المجاعة التي ضربت الريف في بداية الأربعينيات من القرن الماضي، وما نتج عنها من هجرة إلى الجزائر؛ وثقافة الثأر؛ وشخصية “جميلة بوحيرد” التي تسبّب له لقاؤها، دون أن تكون له سابق معرفة بها إلى أن سألته الشرطة عن علاقته بها بعد اعتقاله، في سجنه الذي لم يغادره إلا غداة استقلال الجزائر بعد أن قضى عشر سنوات وراء القضبان بتهمة انتمائه لجبهة التحرير الجزائرية التي لم يسمع عنها إلا أثناء استنطاقه من طرف البوليس. كذلك وظّف تعابير من الشعر الجاهلي مثل: «أما أنا فكجلمود صخر حطّه السيل من علٍ، ظللت جامدا في مكاني بالمجلس» (صفحة 83)، تعبيرا عن الوضع الذي وجد فيه نفسه بعد أن تمكّن الجميع من الفرار إلى خارج منزل الاجتماع إلا هو الذي اعتقلته الشرطة عندما داهمت المنزل؛ وتعابير من القرآن، مثل: «حاولت استكمال حلقة النوم، لكنني أخفقت حين راحت تطاردني طيور أبابيل الأرق وترميني بحجارة من الأسئلة الموخوزة بإبر المصير» (صفحة 133)، واصفا حالة السهاد التي اعترته بعد أن تسلّل إلى الباخرة “رامونيتا 3”.
قلت لقد جعل الكاتب، بقدرته الإبداعية الفائقة وبأسلوبه الرائع، من العربية شبه عروس في ليلة زفافها، حيث تتبرّج وتتزيّن بأفخر وأنفس ما لديها من حلي ولباس. فلنسمع إلى الكاتب وهو يستعرض بعض مظاهر هذا التبرّج وهذه الزينة:
في وصفه لحالة الجوع الذي كان يخِز امعاءه، يقول فريد: «عصافير بطني تزقزق جوعا، وأمعائي في يوم مسغبة تتضور وتغرد طلبا لرمق زهيد» (صفحة 17). وعن التيه الذي بدأه مبكّرا وهو صغير، يقول: «في رماد هذا التيه أتعثر في اقتفاء أثر الخشوع، فأخرّ ساجدا بمحراب ذاكرتي، لأستسلم كطفل تائه تهدهدني ترانيم تهجّد ليلي وتحملني إلى هناك لتلقي بجسدي الصغير في مهد كينونتي» (صفحة 7)؛ «صراخ هادر بأعماقي، وكوابيس علامات الاستفهام تحاصرني حين تداعبني همسات القوافي، ويتقاذفني صولجان الكلمات، وتضيع عني ومني الإجابات، عن أسئلة التيه. أتمرد على أغلال جنوني فأعتلي المئذنة سرا وعلانية مستفسرا القوم بأعلى صوتي عن شرك سؤال الهوية برمزية أسئلة عددها سبعة تناجي في حكمتها السماوات والأرض والأيام» (صفحة 8). في تعبيره عن القدرة على مقاومة النسيان، يقول: «كنس الذاكرة من طحالب النسيان يعيدني إلى حضرة جدتي…» (صفحة 9)
عندما رافق هو وصديقه البشير الشابة “شارلوط” في نزهتها، ترجّت من الثاني أن يؤدي لها أغنية “محّنّي زّين ألعْمارْ”، فبدأت ترقص على نغمات الأغنية. فقال عنها فريد: «كان جسمها يتمايل كزهرة شقائق النعمان حين يداعبها نسيم المساء، فنتمايل معها نحن كالسكارى وما نحن بسكارى. خصلات شعرها تركع وتسجد في الفضاء ونحن متعبدون ناسكون، وفي محراب جمالها نهيم» (صفحة 66). يتذكّرها وهو رهن الاعتقال لدى الشرطة، فيقول: «أما أنتِ يا Charlotte، فعتابك يحتاج إلى جلسة خاصة جنب نبع الماء، أدمنت أنفاسك وأكاد أختنق حين يفر من خيالي أكسجين حنانك. لا أحد بعدك يعنيني، فدعينا نغتسل من بؤس الحرمان ونصلي صلاة المجانين في جنة النعيم… لكرز عينيك أهمس: “يكفيني من هذا العمر أنك مررت بعمري يا حياتي» (صفحة 92).
عندما باتت الأسرة في محل قديم يبدو أنه مسجد مهجور، يقول فريد في وصف شخير والده: «حتى والدي الذي كان يدعي أنه سيقوم بدور الحراسة، راحت خياشيمه تعزف معزوفة شخير تشبه في نشازها الصوتي محرك جرار متهالك» (صفحة 22). بعد موت الشقيق محمد الصغير، ثم الأب من بعده، كتب فريد يقول: «في رمشة عين انصهرت كل أحلامنا، واحترقت كل أوراقنا، وذبلت كل أزهارنا، وانهارت كل أمانينا، فقدنا بوصلة الطريق ووقّعنا على ميلاد رواية أخرى. حبات العقد تتناقص وتتناثر في صمت…» (صفحة 74).
في وصفه لحالة الجو، وهم (أعضاء أسرته) يبتعدون عن دوار “طاحونة الروابي” بمنطقة الحسيمة في 1944: «سحب مشاغبة ظلت تغازل خيوط الشمس وتحجبها عن الانزلاق نحونا، فتمنعها من تدفئتنا وإذابة منسوب الطاقة السلبية المعشعشة في ذواتنا» (صفحة 14). أما داخل الزنزانة التي كان يقبع فيها مع معتقلين آخرين، فيقول عن معاناتهم من برودة شهر دجنبر: «لفحات هواء بارد تتسلل من ثقوب التهوية المحدثة بالجدار الإسمنتي للزنزانة، ندفن الزمن برفق ونحن نتأملها تداعب ما تمزّق من شبكات العنكبوت المنصوبة أسفل السقف. نقاوم بعناد برودة طقس دجنبر القاسي. تحتمي أجسادنا النحيفة بغطاء يتيم، يبدو للناظرين كسجاجيد ملفوفة، أو كمومياءات من العصر الفرعوني» (صفحة 98)
في تذكّره لما كان قد ألفه في منزلهم وأصبح غائبا عنه، يقول: «ولم أرهف السمع في التقاط ذبذبات حفيف أغصان شجرة التين، وهي تتحرّش بجدار غرفتنا بعد أن تخلّصت من أوراقها وأضحت عارية. ولم يداعب أزيز النافذة الخشبية المتهالكة طبلة أذني وهي تقاوم البرد الثمل في تمايله المصطنع حتى يتسلّل إلى الغرفة فيعكّر صفو راحة أجسامنا» (صفحة 14 ـ 15).
عند خروجه من السجن لم يتعرّف بسهولة عن فضاءات حي “أعويوه” بعد أن «نمت طفيليات إسمنتية فبعثرت التصاميم المثبتة بغرفة ذاكرتي الهندسية» كما كتب بالصفحة 108.
وعندما علم، بعد خروجه من السجن، بزواج أمه من “حميدوش”، كتب يقول: «ما كان لي من عزاء سوى البكاء كطفل فقد كل لعبه التي يحبها، كطفل تعب من أجل بناء قصر رملي فسحبته في لحظة مد موجة طائشة…» (صفحة 112).
عندما ذهب إلى وهران، بعد خروجه من السجن، لطرق باب المنزل الذي اعتقل فيه للاستفسار عن “الغالية” و”جميلة” اللتين تسببتا له في 10 سنوات من السجن، فوجد به امرأة لا يعرفها، فكتب يصف الموقف: «ارتبكت كممثل هاو نسي النص الذي ظل يستظهره لأيام» (صفحة 123).
في الحافلة الصغيرة التي أقلته مع آخرين في اتجاه مناجم “لينس” للعمل بها تحت الأرض، يقول في وصف حالهم: «كان البؤس هويتنا والفقر تهمتنا والهجرة خيارنا…» (صفحة 143).
في الحقيقة، إذا حاولت أن أستشهد بنماذج من التعابير الجميلة للرواية، فيجب علي أن أعيد كتابتها كاملة، لأن كل تعابيرها هي نموذج في الجمال والبهاء والإبداع الفني الراقي.

كاتب ومفكر وباحث ومناضل أمازيغي منحدر من منطقة الريف ومدير نشر جريدة تاويزا. ألف العديد من الكتب والمقالات التنويرية القيمة