خرافة اكتساب وإتقان العربية بالسليقة قبل الإسلام
اللغة العربية لغة فاتنة ومحيّرة في نفس الوقت، ومن عدة أوجه. فهي الوحيدة، من بين أخواتها الساميات، من آرامية وسريانية وعبرية، تمتلك خاصية الإعراب الملازم لها، والذي ينتج عنه أنه لا يمكن استعمال العربية بشكل سليم، نطقا وكتابة، إلا بمعرفة العلامات الإعرابية المناسبة. وقد نقضي سنين طويلة في دراسة النحو والإعراب، في التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، دون أن نُفلح في استعمال العربية بلا لحن أو خطأ. لكن، في المقابل، درجنا على الاعتقاد الراسخ أن عرب الجاهلية كانوا يتقنون الاستعمال الشفوي للعربية بشكل نموذجي، سليم وفصيح، والتي ـ حسب هذا الاعتقاد ـ اكتسبوها بالسليقة والفطرة، ودون أن يتعلّموا قواعدها كما نفعل نحن، لغياب الكتابة والمدرسة عندهم في ذلك الوقت. فهل يستقيم الاكتساب السليقي للعربية مع طبيعتها الإعرابية، أم أن عرب الجاهلية كانوا يتحدثون لغة عربية أخرى غير هذه العربية الإعرابية التي نعرفها نحن؟ وإذا كان هذا واردا، أفلا تكون هذه العربية الإعرابية من صنع النحاة بعد الإسلام، ليحاكوا بها لغة القرآن، التي كانت تمثّل، بلغتها الإعرابية الجديدة، إعجازا حقيقيا تحدّى به القرآنُ العرب؟
هذه جملة من الأسئلة والقضايا التي سأناقشها في هذا الموضوع.
اللغة بين الاكتساب والتعلّم:
من المعلوم أن الاستعمال الشفوي، أي الكلام، هو الأول والأصل في اللغة، قبل استعمالها الكتابي. وهذا صحيح سواء بالنسبة لتاريخ البشرية phylogenèse أو تاريخ الأفراد ontogénèse: فاللغة المنطوقة ظهرت منذ بضع مئات آلاف السنين (Encyclopédie Universalis, langues et langage)، في حين أن الكتابة ظاهرة حديثة نشأت منذ أقل من 6000 سنة فقط. وكذلك يبدأ الفرد باكتساب اللغة المنطوقة منذ ولادته ويصبح قادرا على التواصل بها في السنة الرابعة من عمره. وبعد ذلك يتعلّم، بالنسبة للغات ذات الاستعمال الكتابي، الكتابةَ عن طريق المدرسة أو ما يقوم مقامها. ولا تزال توجد، إلى اليوم، المئات من اللغات واللهجات متداولةً دون أن تعرف الكتابة بعدُ. واكتساب اللغة يكون تلقائيا ولاشعوريا، كما يحصل للطفل عندما يكتسب اللغة الأمّ داخل الأسرة. أما تعلّمها فهو، تماما مثل تعلّم كتابتها، عمل إرادي ومقصود، وقسري في الغالب (المدرسة مثلا).
ومن المعلوم كذلك أن الشخص عندما يكتسب اللغة الأمّ، يصبح متمكّنا من الحديث بها بشكل طبيعي، سليم ومفهوم، دون أن يكون بالضرورة واعيا أو عارفا بالقواعد النحوية التي تجعل كلامه سليما ومفهوما، كما نلاحظ ذلك عند الأطفال قبل التحاقهم بالمدرسة، وعند الأميين الذين يتحدثون لغتهم التي اكتسبوها منذ صغرهم كلغة أمّ. وغني عن البيان أن هذه القواعد النحوية، التي يجهلها هؤلاء الأطفال والأمّيون، ليست غائبة عن اللغة أو اللهجة التي يتحدثونها، بل ـ وإلا لما أمكن لهم التواصل بها ـ هي حاضرة دائما، ولكن بشكل خفي، لا يدركه مستعملو تلك اللغة من غير المتعلّمين الذين درسوا نحوها وقواعدها.
خرافة اكتساب وإتقان العربية بالسليقة قبل الإسلام:
هذا هو حال اللغات الطبيعية (اللغات الأمّ) التي تُكتسب بالسليقة، ولا يكشِف عن نحوِها وقواعدِها إلا الدارسون لخصائص هذه اللغات، من متخصّصين ولسانيين…، أو من تعلّموا في المدرسة كتابتَها وقواعدَها ممن يتحدّثونها، بالنسبة إلى اللغات التي ارتقت إلى مستوى الاستعمال الكتابي. وسيكون من المسلَّم به أن العربية لا تشذّ عن هذا المسار الطبيعي لجميع اللغات، مما يعني أنها ظلت لغة متداولة شفويا، يكتسبها ويتحدّثها أصحابها بالسليقة، وبشكل سليم ومفهوم، وذلك قبل تقعيدها، في فترة لاحقة، ووضع القواعد النحوية والتركيبية والصرفية المستخلصة من استعمالها الشفوي.
ولما بدأ هذه التقعيد، من النصف الثاني للقرن الأول الهجري حتى القرن الرابع، كان مشاهير النحاة، أمثال الأصمعي وحماد الراوية والكسائي…، كما تقول كتب التراث، يلجؤون إلى أعراب البادية ليأخذوا عنهم اللغة العربية كما اكتسبوها بالسليقة، وكما يتحدّثونها بالفطرة، وفي شكلها الطبيعي، النقي والسليم الفصيح، وقبل أن تُفسدها عجمة أو تخالطها اللهجات الدخيلة لسكان الحضر. وتقدّم لنا المناظرة الشهيرة، التي جرت ببغداد بين سيبويه (148 هـ – 180 هـ) والكسائي (119 هـ – 189 هـ)، وتُعرف بـ”المسألة الزنبورية” (تتعلق بلدغة الزنبور)، شهادةً جد معبّرة عن هذا اللجوء المزعوم إلى كلام الأعراب للاستشهاد به على ما هو صواب، اكتُسب بالسليقة، يُعتدّ به، وما هو خطأ ينبغي تركه واستبعاده. وخلاصة القصّة أنه بعد أن تمسّك كل من المتناظريْن بصواب رأيه وخطّأ رأي مناظره، اتفقا على استقدامَ مجموعة من الأعراب للاحتكام إليهم لمعرفة الأصحّ والأصوب نطقا (ما يخصّ العلامات الإعرابية المناسبة) ولغة، بناء على ما اعتادوا استعماله في كلامهم من تعابير مماثلة لتلك التي ناقشها المتناظران، باعتبار كلامهم هو الأصوبَ والأفصح لاكتسابهم له بالفطرة والسليقة. والأكيد، رغم تواتر هذه القصة في كتب القدماء، أن طريقة حسم الخلاف بين المتناظريْن بالاحتكام إلى كلام الأعراب ليس إلا إخراجا مسرحيا الهدف منه هو الإقناع أن الكلام المحكي للأعراب الأميين (يجهلون القراءة والكتابة) كان هو المرجع المعتمد في جمع العربية وتدوينها وتقعيدها. وهو ما استخلص منه الراحل محمد عابد الجابري أن الأعرابي، ابن الصحراء والبادية، هو صانع عالم الإنسان العربي، لأنه نقل إليه لغته التي نقل عبرها إليه كذلك نمط تفكيره البدوي، ونظرته إلى العالم وإلى الطبيعة وإلى الأشياء وإلى نفسه وإلى الآخرين…
هذا الاعتقاد بأن العرب كانوا، قبل الإسلام، يكتسبون العربية، وباختلاف لهجاتها، بالسليقة ويتحدّثونها بشكل سليم ومفهوم، ومطابق لقواعدها النحوية التي كانوا يجهلونها، ظل حقيقة بديهية لا تُناقش، رسّخها القدماء، وأقرّها المحدثون، وصدّقها المستشرقون. لماذا حقيقة بديهية؟ لأن هذا ما يحصل لجميع اللغات الطبيعية عندما يكتسبها مستعملوها بشكل تلقائي ولاشعوري كلغة أمّ منذ صغرهم، ويتحدّثونها بشكل سليم يراعي قواعدها النحوية والصرفية والتركيبية رغم جهلهم لهذه القواعد، كما هو حال الأميين الذين يتحدّثون الإسبانية أو الفرنسية أو الإنجليزية أو الأمازيغية أو الدارجة…، بشكل صحيح وسليم، نحوا وتركيبا وصرفا، دون أن يعرفوا شيئا عن القواعد النحوية والتركيبية والصرفية لهذه اللغات. وقياسا على هذه اللغات الطبيعية، يسري على العربية ما يسري عليها بخصوص اكتسابها واستعمالها الشفوي بشكل سليم لا يخالف قواعدها النحوية والتركيبية والصرفية، وذلك حتى قبل معرفة هذه القواعد.
لكن، “لا قياس مع وجود الفارق”، كما ينصّ المبدأ الأصولي المشهور. والفارق، هنا، بين العربية واللغات الطبيعية، كبير جدا يجعل مثل هذا القياس فاسدا ويعطي، بالتالي، نتائج فاسدة ومغلوطة، وتصبح معه بديهية اكتساب الأعرابي للعربية بالفطرة والسليقة في الجاهلية، مجرد خرافة تدحضها الخاصية الجوهرية للعربية، والتي تتنافى مع الاكتساب السليقي لها.
الإعراب في اللغة العربية:
هذه الخاصية الجوهرية للعربية، وهي ما يشكّل الفارق الكبير بينها وبين اللغات الطبيعية، تتجلّى في كون لغة الضاد، وعكس الإسبانية أو الفرنسية أو الإنجليزية أو الأمازيغية أو الدارجة…، وغيرها من اللغات الحية الأخرى، لغة مُعرَبة، أي يحكمها الإعراب، وليست مبنية. ويمكن تعريف الإعراب باختصار بأنه تغيّر في حركة (رفع ونصب وكسر وجزم وتنوين يتبع الحركات الثلاث الأولى) الحرف الأخير للكلمة حسب وظيفتها النحوية (فاعل، مفعول، خبر، مضاف إليه…، مضارع مجزوم…إلخ) في الكلام أو الجملة، وذلك عندما تأتي اسما أو فعل مضارع مسبوق بأدوات عاملة. أما البناء، الذي هو غياب للإعراب، فيتمثّل في بقاء الحركة الأخيرة للكلمة على حال واحدة كيفما كانت وظيفتها النحوية في الجملة، كما في الإسبانية والفرنسية والإنجليزية والأمازيغية والدارجة…
والإعراب، في العربية المدرسية (التي لا بدّ لاكتسابها من تعلّمها في المدرسة أو ما يقوم مقامها) التي نعرفها وندرُسها وندرّسها، ليس خاصية ثانوية أو عرضية، كما قد نجد ذلك في بعض اللغات الأخرى، بل هو شيء جوهري فيها، يشكّل طبيعتَها وروحَها وماهيتَها. ويوضّح الدكتور جميل علوش هذا الدور الجوهري للإعراب في العربية بقوله: «الإعراب ظاهرة بارزة من ظواهر اللغة العربية، بل هو إحدى خصائصها الفريدة المتميزة. وهو مقترن بالعربية اقترانا لا مجال فيه لانفصال أو بينونة. وأكثر من ذلك أنه لا سبيل للحديث عن العربية دون الحديث عن الإعراب. فالإعراب هو عنوان العربية بل هو روحها وجوهرها. ومن غير الممكن أن يتصدى أحد لدراسة العربية بعيداً عن الإعراب ودلالاته وأحكامه وعلاماته». (الدكتور جميل علوش، “الإعراب والبناء، دراسة في نظرية النحو العربي”، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى 1997، صفحة 15).
الإعراب ليس عنصرا أصليا في العربية:
وأين المشكل إذا كانت العربية لغة إعراب وليست لغة بناء؟ المشكل هو أن الإعراب، بشكله الملازم للعربية كجزء من طبيعتها، يجعل هذه اللغة غير قابلة للاكتساب والاستعمال الشفوي بالسليقة، وبشكل سليم لا لحن فيه قد يلتبس معه المعنى والفهم، ودون تعلّم لقواعدها النحوية، كما قيل لنا عن الأعراب الذين اُتّخِذ كلامُهم نموذجا للكلام العربي الصحيح، السليم والفصيح، ومرجعا منه استخلصت هذه القواعد النحوية إبان تقعيد اللغة العربية.
لماذا لا يمكن اكتساب العربية، في شكلها الإعرابي هذا، بالسليقة، حسب ما هو شائع كمعطى بديهي، كما سبق أن أوضحت؟
1ـ لأن الإعراب، كما هو مطبّق في العربية المدرسية التي نعرفها، ليس ظاهرة طبيعية تابعة للغة طبيعية. فالعلامات الإعرابية، أي حركات أواخر الأسماء، ليست، بسبب تغيّرها، عناصر أصلية في هذه الأسماء، حسب ما تواضع عليه أصحاب اللغة المعنية من نطقهم لتلك الأسماء بمكوّناتها الصوتية التي تتشكّل من حروف صامتة consonnes، وأخرى صائتة voyelles (الحركات) تابعة للأولى. فكلمة “طَرِيق”، كمثال، رغم أن ثلاثة صوامت consonnes تدخل في تكوينها، إلا أن الصوائت voyelles (الحركات) التابعة لهذه الصوامت، لا يدخل منها في تكوين نفس الكلمة إلا اثنان: فتحة الطاء وكسرة الراء مع المدّ الطويل (رِيـ). أمّا الحركة الأخيرة للقاف، فلأنها متغيّرة، فهي ليست من المكوّنات الأصلية لكلمة “طريق”. فإذا اعتبرناها أصلية مثل الحركتين الأولى والثانية والمدّ الطويل، فستكون لدينا سبع نسخ من كلمة “طريق”: طريقْ، طريقُ، طريقَ، طريقِ، طريقٌ، طريقًا، طريقٍ. وهذا خُلْف بتعبير المناطقة. فالإعراب لم يولد إذن مع العربية كجزء أصلي فيها، بل أُضيف إليها في مرحلة لاحقة. فهو، من هذه الناحية، يشبه خطّ الكتابةَ: فإذا كان لا يُكتسب بالسليقة لأنه ليس جزءا من اللغات الطبيعية، وإنما هو شيء استُحدِث وأُضيف إلى اللغة لغرض استعمالها الكتابي، فكذلك العلامات الإعرابية ليست جزءا من عربية طبيعية، وإنما هي شيء استُحدِث وأُضيف إليها، كما سنشرح ذلك في الفقرة الخاصة بكيفية نشأة العربية الإعرابية. وبهذه الإضافة ستفقد العربية صفة اللغة الطبيعية وتتحوّل إلى لغة “مصنوعة” في جزئها الإعرابي. وليس صدفة أن هذه العربية الإعرابية، أو “المصنوعة”، تربطها علاقة تكوينية بالكتابة: نشأت بها ومعها، ولم يسبق أن كانت متداولة شفويا، في شكلها الإعرابي، قبل كتابتها.
ومما يؤكّد، كذلك، أن الإعراب ليس عنصرا أصليا وطبيعيا في العربية، هو أنه يخصّها وحدها من دون أخواتها الساميات، كالآرامية والسريانية (هما في الأصل لغة واحدة) والعبرية، كما أوضح ذلك بتفصيل الدكتور ابراهيم أنيس في كتابه: “من أسرار اللغة ” (طبع ونشر مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الثالثة 1966، صفحة 199 وما بعدها)، مع تبيانه أن ما قد يُؤوّل على أنه نصْب لأواخر بعض الكلمات في العبرية لا يعني الإعراب ولا علاقة له بوظيفته كما هو ممارَس في العربية.
معرفة الوظائف النحوية تتنافى مع الاكتساب السليقي للغة:
2ـ ثم، وهذا هو الأهمّ، لأن الإعراب الملازم للعربية يجعل نطق الحركة الأخيرة للاسم أو الفعل المضارع، فتحا أو ضمّا أو كسرا أو سكونا أو تنوينا، حسب وظيفتهما النحوية في سياق الكلام، مشروطا بمعرفة هذه الوظيفة. والحال أن هذه المعرفة ليست شرطا في اللغة الطبيعية. والدليل على ذلك أن الطفل أو الأمي يستعملان لغتهما الطبيعة وهما يجهلان الوظائف النحوية لما يستعملانه من كلمات في حديثهما. فتغيّر حركات أواخر الكلمات، أسماء وأفعالا مضارعة، حسب وظائفها النحوية في العربية، يجعل إذن اكتساب هذه اللغة بشكل تلقائي ولاشعوري، وبالسليقة، أمرا مستحيلا، لأن هذه المعرفة تحتاج إلى تعلّم القواعد التي تحكم تلك الوظائف. وهو ما لا يتوفّر للطفل الذي يكتسب لغته الأمّ داخل الأسرة، ولا لأي أعرابي في الجاهلية ـ الذي قيل لنا بأنه كان نموذجا في الفصاحة والنطق السليم بالعربية ـ لأنه يجهل هذه الوظائف التي لم يتعلّمها.
نعم قد نفهم ونقبل، استنادا إلى الآليات التي يكتسب بها الأطفال اللغة الأمّ، أن الطفل قد يكتسب، داخل أسرته، تلقائيا ولاشعوريا، بالسماع والقياس (قياس كلامه على أمثلة سبق أن سمعها واستدمجها ضمن رصيده اللغوي) والممارسة التدريجية للكلام بالتفاعل مع المحيطين به ومع نظرائه من الأطفال، الاستعمالَ والنطق الصحيحين لجمل من قبيل: “ضرَب زيدٌ محمدًا…”، “نشكر زيدًا…”، “زيدٌ مريضٌ…”، “إن زيدا مريضٌ…”، “لم يحضرْ زيد…”، دون معرفة بالوظائف النحوية للكلمات التي يستعملها في مثل هذه العبارات. وبالسماع دائما والقياس والتفاعل والممارسة يعمّم النطق، وهو يتقدّم في السنّ، بنفس الحركات لأواخر الألفاظ إلى تعابير مماثلة في بنائها وتركيبها للنوع الأول من الجمل، سيستعملها في كلامه، مثل: “نواجه الخصمَ…”، “الجوّ حارٌّ…”، “إن السماءَ ممطرةٌ…”، “الأطفال يلعبون…”. إلى هنا قد يبدو الاكتساب التلقائي واللاشعوري للغة (اللغة الأمّ)، مع نطق العلامات الإعرابية بشكل صحيح وسليم، أمرا ممكنا، بل عاديا. لكن الطفل، وهو يكتسب بالتدريج اللغة الأمّ منذ صغره، أو الأعرابي الأمّي الراشد الذي سبق أن كان في وضع ذلك الطفل، لا يمكنهما ـ رغم قدرتهما مبدئيا على إنتاج جمل جديدة لم يسبق أن استعملاها من قبلُ وفهم جمل جديدة لم يسمعاها من قبلُ كما تُتيح ذلك خاصيةُ الإنتاجية (القدرة اللامحدودة على استعمال اللغة لإنتاج جمل جديدة) التي تميّز اللغات الطبيعية ـ أن يستوعبا كل أشكال التعبير التي سيضطران إلى استعمالها في تواصلهما اليومي في حياتهما، وبعلامات إعرابها المناسبة. فالمشكل إذن ليس في اللغة في حدّ ذاتها أو في اكتسابها السليقي، بل لإن الاستعمال اللغوي السليم لهذه اللغة مشروط بضبط علامات إعرابها المناسبة لكونها لغة مُعربة، وهو ما لا يُكتسب بالسليقة بل يستلزم تعلّم القواعد النحوية التي تحكم هذه العلامات.
فإذا كان أعرابي الجاهلية، الذي اكتسب العربية بالسليقة كلغة أمّ وهو طفل، سينطق، بشكل نحوي صحيح، وبالتعميم والقياس، عبارة: “صدّ الجيشُ هجوما…”، قياسا على: “ضرب زيدٌ محمّدًا…”، و”نرعى الغنمَ…” قياسا على “نشكر زيدًا…”، فكيف سينطق العلامات الإعرابية الصحيحة لهاتين العبارتين: “نشتري الحلْويات…”، “واجه خصمه زيد…”؟ وليس هذان التعبيران من النوازل الافتراضية للنحاة، بل هما موجودان في العربية قبل تقعيدها، مما يعني أنهما كانا جزءا من العربية التي افتُرِض أنها كانت تُكتسب بالسليقة. فقد جاء في الشعر المنسوب إلى عمرو بن كلثوم: «بأَنا نـورد الـراياتِ بيضـاً *** ونصـدرهن حمرا قد روينا». وجاء في الشعر المنسوب إلى طرفة بن العبد: «يشقّ حابَ الماء حيزومُها بها *** كما قسم التربَ المفايلُ باليد». وإذا كان الشاعر الأول قد عرف كيف يكسِر الحرف الأخير لكلمة “رايات” (هكذا نقلها الرواة مكسورة) رغم أن القياس على عبارة: “نشكر زيدًا…” توجب نصبَها لأنها تؤدّي نفس الوظيفة النحوية (المفعول به)؛ وإذا كان الثاني قد عرف كيف يقدّم المفعول به عن الفاعل دون أن يخطئ في العلامات الإعرابية، فذلك دليل على أنهما اكتسبا ذلك بالسليقة، وليس أنهما درسا القواعد النحوية في المدرسة كما نفعل نحن اليوم. وهو ما تكرّره أطروحة “السليقة” الشائعة كحقيقة مسلّم بها، والتي تؤكّد أن شعراء الجاهلية نظموا أشعارهم ومعلقاتهم، ذات العربية الفصيحة، والسليمة نحوا ولغة، انطلاقا من عربيتهم الفطرية التي اكتسبوها بالسليقة ككل الأعراب، وأصبحوا يتقنونها بنفس السليقة، ويستعملونها بشكل سليم، نحوا وتركيبا وصرفا ومعجما، كما يشهد على ذلك شعر المعلقات… لكن إذا تأملنا هذين البيتين لعمرو بن كلثوم ولطرفة بن العبد، وتركنا جانبا خرافة “السليقة” التي تمنع مثل هذا التأمل، مع استحضار طبيعة العربية كلغة إعرابية، فسنخلص إلى أن الشاعر الأول لا يمكن إلا أن يكون عارفا بأحكام جمع المؤنّث السالم عندما يأتي مفعولا به، والثاني عارفا بالوظيفة النحوية لكلمتي: “حبابَ” و”التربَ”، التي تجعل منهما مفعولا به مقدَّما، ثم لكلمتي “حيزومُها” و”المفايلُ”، التي تجعل منهما فاعلا مؤخَّرا.
ولا يصحّ الاعتراض بأنه لا يجوز الاحتكام إلى الشعر لأن في لغته غير قليل من الصنعة التي تبتعد عن اللغة الفطرية. إذا كان هذا صحيحا، وهو كذلك، فمن أين استمدّ هؤلاء الشعراء تلك الصنعة في الأشكال النحوية التي تظهر في العلامات الإعرابية الصحيحة في أشعارهم؟
ـ إما أنهم تعلّموها حتى تمكّنوا من استعمالها. وهنا نخرج عن “السليقة”، فنكون أمام التعلّم الذي يكون بوعي وقصد وجهد، عكس الاكتساب بالسليقة.
ـ وإما أنهم اكتسبوا كل ذلك بالسليقة، كما تقول الأطروحة الشائعة. وهو ما يتنافى مع آليات اكتساب اللغة عند الطفل لكون اللغة إعرابية، علما أن المفترض في هؤلاء الشعراء أنهم اكتسبوا لغتهم داخل الأسرة وهم أطفال.
وتجدر الإشارة إلى أن استحضارنا للسماع كإحدى الآليات التي يكتسب بها الطفل اللغة الأمّ داخل الأسرة، هو على سبيل المقارنة والتوضيح فقط. أما الحقيقة فهي أنه لا يوجد من سيسمع منهم الطفل العربي في الجاهلية كلاما عربيا مُعربا، لأن ما يصدق عليه من استحالة اكتسابه للعربية الإعرابية، يصدق على الذين كانوا مثله، وعنهم يُفترض أنه أخذ العربية الإعرابية بالسماع.
تهافت خرافة “السليقة”:
وقد نورد أمثلة لا عدّ لها تقوّض خرافة “السليقة” في اكتساب واستعمال عرب الجاهلة لعربية إعرابية بشكل سليم ومفهوم، وبلا لحن ولا خطأ. فهل من المعقول أن نقبل ونصدّق أن من يجهل الوظيفةَ النحوية لكلمتي “راكبا” و”راكب” سينطق إحدى العبارتين، بدل الأخرى، بشكل صحيح وسليم ومفهوم: “جاء راكبا” و”جاء راكبٌ”؟ وهل يستطيع أن يعلّل لماذا اختار النصب أو الرفع إن لم يكن يعرف أن الاختيار الأول هو بسبب أن الوظيفة النحوية للكلمة جاءت حالا، والاختيار الثاني هو بسبب أنها جاءت فاعلا؟ وكيف سينطق، بشكل صحيح حسب سياق الكلام، العلامات الإعرابية لهاتين العبارتين: “نحن العربَ كرماء”، “نحن عربٌ كرماء” إن لم يكن عارفا أن “عرب” في الجملة الأولى منصوبة على الاختصاص وفي الثانية مرفوعة لأنها خبر؟ كيف سيميّز بين نطق: “هذا سارقُ نقودي” بلا تنوين، و”هذا سارقٌ نقودي” بالتنوين؟ ولماذا سيقول: “تسعة عشر رجلا”، “تسع عشرة امرأة”، “وصل الرجل التسع عشر”، وصلت المرأة التاسعة عشرة، وليس: “تسع عشر رجلا”، “تسعة عشرة امرأة”، “وصل الرجل التاسع عشرة، “وصلت المرأة التاسعة عشر”، إن لم يكن عارفا بقواعد العدد والمعدود؟
أما تصريف الأفعال، الذي هو شرط لإتقان اللغة واستعمالها، فيجب الاعتراف بأنه، باستثناء الفعل المضارع، سهل الاكتساب بالسماع والقياس والتفاعل والممارسة…، رغم كثرة الضمائر وأنواع الفعل (ثلاثي، رباعي، خماسي، سداسي؛ ثم الصحيح والمعتلّ…). لماذا؟ لأن الصيغ الصرفية (الجمع المذكّر المخاطب، المثنّى المؤنث الغائب، المفرد المؤنث الغائب…إلخ…) لغير المضارع، قارّة تبقى على حال واحدة، مما يسهل معه اكتسابها بالسماع والقياس والتفاعل والممارسة. وهذا ما لا يسري على الفعل المضارع عندما تدخل عيه الأدوات العاملة للجزم أو النصب. فهذه الأدوات لا تسمح باستعمال الفعل المضارع الذي تدخل عليه، وبشكل صحيح وسليم، بناء فقط على السماع والقياس والممارسة كجزء من آليات الاكتساب التلقائي واللاشعوري للغة الأمّ، مثل تلك الجمل البسيطة التي استشهدنا بها أعلاه (“ضرَب زيدٌ محمدًا”، “نشكر زيداً”، “زيد مريضٌ”، “إن زيدا مريضٌ”، “لم يحضرْ زيد…”). وما يمنع ذلك هو كونها متعدّدة (أكثر من أداة واحدة للجزم وكذلك للنصب). يضاف إلى ذلك أن وظائفها النحوية، التي على أساسها تعمل عملها (جزم ونصب المضارع)، هي نفسها متعدّدة في الغالب. فمثلا أداة “لا” قد تكون ناهية فتجزم المضارع وقد تكون نافية فلا عمل لها… وحرف “الفاء” قد تكون وظيفته، عندما يدخل على المضارع، العطف، أو التفسير، أو رابطة لجواب الشرط، أو السببية… والنتيجة أنه من المستبعد جدّا أن ينجح المتكلّم في استعمال فعل المضارع بشكل سليم في كل التعابير التي تدخل فيها عليه هذه الأدوات العاملة، بناء فقط على الاكتساب التلقائي، ودون أن يكون عارفا بأحكام هذه العوامل. ومن هنا قد نجزم أن هذا البيت المنسوب إلى امرئ القيس: «فقلت له لا تبك عينك إنما *** نحاول ملكا أو نموت فنعذرَ»، لا يمكن أن يقوله إلا من يعرف أحكام فاء السببية التي بموجبها نصب فعل “فنعذرَ”.
قد يردّ أصحاب خرافة السليقة بأن كل هذه الحالات، من حركات أواخر الكلمات التي تتغيّر حسب الوظائف النحوية لهذه الكلمات، أو من إضافة حرف أو حذفه كما في العدد والمعدود، أو من تغيير في صيغة تصريف المضارع عندما تدخل عليه أدوات عاملة، أو من حذف نون الأفعال الخمسة عندما تدخل عليها نفس الأدوات…، يمكن ضبطها بالسماع والقياس، ليصبح، مع الممارسة، استعمالها من طرف المتكلّمين استعمالا صحيحا وسليما، مطابقا لقواعدها النحوية التي لا يدركها هؤلاء المتكلّمون. لكن إذا عرفنا ـ وهذا مثال فقط ـ العدد الضخم للأدوات العاملة لكل من الاسم والفعل، والعدد الأكبر لأحكامها وعملها، والعدد الهائل لقواعد العدد والمعدود، والعدد اللامحدود لأشكال الجمل والقول…، فسيتكوّن لدينا اليقين بأنه من المستحيل أن سيستوعب الأعرابي، ولو منذ ولادته حتى بلوغه السبعين من عمره، كل ما ترتّبه هذه الأدوات والأحكام والقواعد والأشكال من تغييرات على حركات أواخر الألفاظ، حتى يكون كلامه صحيحا وسليما ومفهوما، مطابقا للقواعد النحوية التي تحكم هذا الكلام دون أن يكون عارفا بها ومدركا لها. نعم ربما قد ينجح في ذلك إذا افترضنا أنه كان يلجأ إلى تسجيل ما يسمع (وحتى هنا سيطرح السؤال: من أين جاءت صحة ما كان يسمع ما دام أن ما يسري عليه يسري على من يُفترض أنه كان يسمع منهم؟) من كلام تختلف حركات أواخر كلماته عما يعرفه، ليقيس عليه عندما يستعمل تعابير مماثلة. لكن بغض النظر أنه لا يمكن حصر كل أشكال التعابير التي تختلف حسب المواقف والسياقات، فإن اللجوء إلى التسجيل (على افتراض معرفة الكتابة) سيُخرجنا من الاكتساب السليقي واللاشعوري للغة إلى التعلّم الذي يكون عن وعي وقصد وإرادة.
نريد بهذا الاستدلال أن نبيّن أن الاعتقاد السائد أن الأعرابي كان يكتسب العربية ويتقنها بالسليقة هو مجرد خرافة. ويكفي، لتفنيد هذه الخرافة، التذكير بأن هناك من يدرس العربية، نحوا وصرفا وتركيبا ومعجما، في المرحلة الابتدائية والثانوية والجامعية، وقد يحصل فيها على درجة دكتوراه، ومع ذلك تجده يلحن عندما يتكلّمها أو أيقرأها إن لم يكن النص مشكولا. إذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى مثل هؤلاء الذين قضوا ردَحا من الزمن في تعلّم ودراسة العربية، فما بالك بأعرابي لا يعرف الكتابة ولا المدرسة، أن يكتسب ما فشل فيه مثقّف دكتور، وبالسليقة وبدون جهد ولا تحضير ولا تعب ولا سهر… وهل يُعقل أن سيبويه، شيخ النحويين بلا منازع، كان يقول، كما يُنسب إليه ذلك: “أموت وفي نفسي شيء من حتّى”، قاصدا بذلك أنه سيموت دون أن يلمّ بكل أحكام أداة “حتى” وعملها على الاسم والفعل عندما تدخل عليهما، ومع ذلك نصدّق أن الأعرابي كان متمكّنا من كل ذلك، ويعرف بالسليقة كل أحوال “حتى” كما يتجلّى ذلك في نطقه الصحيح المفترض للعلامات الإعرابية لكل ما يأتي بعدها من اسم أو فعل؟
الخلاصة أن العربية، لكونها لغة إعرابية، كما شرحنا، فإن الحديث الشفوي بها يتطلّب، حتى يكون ذلك الحديث سليما من حيث العلامات الإعرابية، ما يتطلّبه نفس ذلك الحديث عندما يكون نصّا مكتوبا لا يمكن أن يقرأه بشكل سليم، من حيث علاماته الإعرابية، إلا من كان عارفا بالوظائف النحوية لكلمات ذلك النصّ. مما يجعل من العربية، كلغة إعرابية، لغة تُتعلّم بالضرورة، وعن وعي وإرادة كما تُتعلّم كتابتها وقراءتها، ولا تُكتسب تلقائيا ولاشعوريا.
اللهجات العربية كانت بلا إعراب قبل الإسلام:
وإذا كان من المستحيل أن تكون العربية الإعرابية، التي نعرفها، لغةَ التداول والتخاطب لدى كل أو بعض أو إحدى قبائل الجاهلية، لكون طبيعتها الإعرابية تتنافى من الاكتساب السليقي للغة، فماذا كان يتكلّم العرب إذن قبل الإسلام؟
لقد كانوا، بكل بساطة، يتكلّمون لهجاتهم العربية، التي كانت تُكتسب حقا، عكس العربية الإعرابية، بالسليقة وبدون تعلّم، كلغة أمّ. والفرق بين هذه العربية السليقية والعربية الإعرابية هو أن الأولى كانت مبنية بالضرورة ـ أقول بالضرورة لأنه، كما رأينا، يستحيل اكتساب اللغة المعربة، مثل العربية التي تعلّمناها ودرسناها ونكتب بها، بالسليقة وبدون تعلّم ـ، أي لغة غير إعرابية، وهو ما يعني أن حركات أواخر أسمائها وأفعالها المضارعة لم تكن تتغيّر حسب وظائفها النحوية في القول والكلام، والتي كانت في الغالب ساكنة، كما هو الحال في اللهجات العربية الحالية. وإذا كانت اللهجات العربية غير إعرابية في الجاهلية، فهذا لا يعني، كما يعتقد البعض جهلا، أنها كانت بلا قواعد نحوية وصرفية وتركيبية لأنها كانت مجرد لهجات. فلغة بلا قواعد، ولو أنها لهجة عاميّة لم يسبق لها أن عرفت الكتابة والتقعيد، تساوي لا لغة. فما يجعل التواصل ممكنا بلغة ما كيفما كانت، سواء عالِمة أو عامّية، هو قواعدها، التي قد لا يعرفها مستعمل هذه اللغة، مثل الطفل والأمي اللذين يتكلمان لغتهما الشفوية بشكل سليم طبقا لقواعدها النحوية والصرفية والتركيبية دون أن يكون لهما إلمام ولا وعي بهذه القواعد. ولا ننسى أن الفرق بين اللغة واللهجة هو أن الأولى لهجة تُدرّس وتُكتب في حين أن الثانية محرومة من المدرسة والكتابة.
والسؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن، هو: كيف يمكن استعمال لهجة عربية، بشكل سليم ومفهوم، رغم أنها مبنية تبقى حركات خواتم ألفاظها على حال واحدة كيفما كانت ووظيفتها النحوية في الكلام؟ في الحقيقة، بطرحنا لهذا السؤال، نكون لا زلنا ننظر إلى هذه اللهجة المبنية انطلاقا هي العربية الإعرابية؟ ولهذا فنحن لا نكاد نصدّق أن تكون هناك عربية مفهومة دون أن تتغيّر حركات أواخر كلماتها حسب وظيفتها النحوية في الجملة أو القول، كما تقضي بذلك قواعد العربية الإعرابية التي نعرفها. مع أنه يكفي أن نتأمل اللهجات العربية الحالية لبلدان الخليج بشبه الجزيرة العربية، لنلاحظ أنها تُستعمل بلا إعراب، أي دون أن تتغيّر الحركات الأخيرة لألفاظها حسب وظيفتها النحوية في الكلام، ومع ذلك فالحديث بها يكون مفهوما وواضحا. ويبدو أن هذا ما كانت عليه لهجات اللغة العربية قبل الإسلام، تُستعمل بلا إعراب، مما جعل منها لغات أمّ تنتقل من جيل إلى آخر بالاكتساب التلقائي السليقي.
وإذا كانت هذه اللهجات السابقة عن الإسلام تشترك مع العربية الإعرابية في معجمها، وخصوصا لهجة قريش، إلا أنه من الراجح أنها كانت تختلف عنها في تراكيبها وتصريف أفعالها، بالقدر الذي كان يسمح بالاستغناء عن الإعراب وباستعمالها مبنيةً دون أن يخلّ ذلك بالفهم والمعنى، أو ينتج عنه التباس في التواصل بها. فيكفي أن يكون تركيب الكلام بشكل يجعل الوظيفة النحوية للاسم تتحدّد، كما يلاحَظ ذلك في غالبية اللهجات العربية الحالية، بموضعه الثابت في القول المفيد (الجملة)، كأن يأتي الفاعل لزوما قبل الفعل والمفعول في كل التعابير المماثلة، ليُستغنى عن حركات أواخر الأسماء ويستعاض عنها بالسكون دون أن يكون هناك مشكل في الفهم والتواصل. فمثل هذا المشكل ناتج في العربية الإعرابية عن كون الوظيفة النحوية للاسم لا تتحدّد بموضع هذا الاسم في الجملة، كأن يكون الأول أو الثاني أو الثالث…، وإنما بالمعنى الذي يقصده المتكلّم، مما لا بدّ منه من إدراك هذا المتكلّم للوظائف النحوية (مثل الفاعل والمفعول به…) لما يستعمله من كلمات حتى يكون كلامه سليما، معنًى ونحوا. وهكذا تقبل العربيةُ الإعرابية، للتعبير عن نفس المعنى، تراكيب مثل: “ضرب زيدٌ محمّدا”، “ضرب محمّدا زيدٌ”، “زيدٌ ضرب محمّدا”…
لكن لو كان ترتيب كلمات هذه الجمل، كما في العديد من اللهجات، بهذا الشكل: “زيد ضرب محمد”، فحتى لو نطقنا أواخر أسماء هذه الجملة سكونا، كما في هذه اللهجات، فسيكون المعنى واضحا ومفهوما، وهو أن زيدا هو الذي قام بفعل الضرب، وأن محمدا هو الذي وقع عليه هذا الفعل. وهذا ما أكّده الدكتور ابراهيم أنيس عندما كتب يقول: «نكتفي هنا ببيان قصير عن موضع الفاعل من الجملة، وموضع المفعول منها، کي نبرهن على أن الفاعل لا يعرف بضم آخره، ولا المفعول بنصب آخره بل يعرف كل منهما في غالب الأحيان بمكانه من الجملة الذي حددته أساليب اللغة» (“من أسرار اللغة”، صفحة 228). ويضيف: «على كل حال نستطيع ونحن مطمئنون أن نقرر هنا أن الأساليب العربية القديمة قد عينت مكان الفاعل ومكان المفعول، بما لا يدع مجالا للبس، وبما لا يحوج إلى رفع في الفاعل حتى تظهر فاعليته؛ أو نصب للمفعول حتى تتضح مفعولیته» (صفحة 231). وفي نفس الاتجاه يوضّح أن تحريك أواخر الكلمات لم يكن يُلجأ إليه في الأصل إلا لتجنّب التقاء ساكنين (صفحة 236).
وإذا أضفنا إلى كل هذا أن تصريف الفعل في اللهجات مخفّف، لكون عدد الضمائر أقلّ، ونون التوكيد غائبا، والمثنّى غير موجود في الغالب الأعم، والأدوات العاملة المعروفة في العربية الإعرابية غير مستعملة…، سنفهم أنه ليس من الضروري استعمال عربية إعرابية ليكون الكلام مفيدا وسليما، واضحا ومفهوما.
الإعجاز القرآني ونشأة العربية الإعرابية:
إذا كانت اللغة العربية لم يسبق لها، في شكلها الإعرابي، وقبل تقعيدها وبداية استعمالها الكتابي في الفترة الإسلامية، أن تناقلتها الأجيال عبر الاستعمال الشفوي كلغة أمّ ولغة تخاطب تُكتسب، منذ الصغر، بالسليقة والسماع والممارسة الشفوية، فكيف احتُفظ بها حتى وصلت إلى مرحلة التقعيد والكتابة بعد الإسلام؟
الجواب هو أن العربية، في شكلها الإعرابي دائما، لم يسبق لها أن وُجدت قبل الإسلام. ذلك أن نشأتها كانت متزامنة ومتلازمة مع نشأة النحو العربي. بل هي وليدة هذا النحو وابنته. فبوضع النحاة لقواعد النطق الصحيح لحركات أواخر الأسماء والأفعال المضارعة، حسب وظائفها النحوية في التعبير، نشأت العربية الإعرابية. وقد ظلت، منذ نشأتها هذه، لغة كتابية تُتعلّم في المدرسة أو ما يقوم مقامها، ولا تُكتسب بالسليقة كلغة أمّ. فكل ما انتقل إليها من الفترة الجاهلية هو معجم اللهجات العربية، أما النظام النحوي والتركيبي والصرفي لهذه العرية الإعرابية فهو نظام جديد أنشأه النحاة إنشاءً. لكن ذلك لم يكن خلقا من عدم، بل كان انطلاقا من القرآن الذي جاء، للمرة الأولى، بعربية جديدة في شكلها الإعرابي، والذي لم يكن معروفا في أية عربية من تلك التي كانت متداولة في الجاهلية. وهذا ما شكّل إعجازا حقيقيا تحدىّ به القرآنُ العربَ. وإذا كنا موضوعيين، فقد لا نجد في القرآن، كما فهم وشرح المفسّرون الإعجاز القرآني، ما يعجز العرب، أو غيرهم، عن الإتيان بمثله، سواء من حيث الشكل (التعبير والأسلوب…) أو من حيث المضمون (أحكام تشريعية، حقائق علمية، الإخبار بالغيب الذي كان معروفا في كتب دينية سابقة…).
لكن إذا عرفنا، كما سبق بيان ذلك، أن العرب قبل الإسلام كانوا يتحدّثون لهجاتهم العربية بشكل لا إعراب فيه، أي كلغة مبنية لا دور فيها للعلامات الإعرابية لفهم مقاصد القول، فسيكون القرآن حقا شيئا معجزا لا يستطيع أن يأتي بمثله لا العرب ولا غيرهم. ويتمثّل هذا الإعجاز في استعماله لغة إعرابية ـ وليست مبنية كاللهجات العربية في الجاهلية ـ تتوقف قراءته السليمة على ضبط الحركات الإعرابية للكلمات حسب وظيفتها النحوية. وهذا شيء لم يكن يعرفه ولا يتقنه ولا يمارسه عرب الجاهلية، عكس من تؤكّده خرافة “السليقة”. فالإعجاز الأكبر للقرآن هو لغته الإعرابية التي صيغ بها. فعندما تحدّى العرب أن يأتوا بمثله، فلأنه كان يعرف أنهم لا يملكون إلى ذلك سبيلا، لأن كل ما كانوا يعرفون التعبير به هو لغتهم المبينة، وليست الإعرابية كما في لغة القرآن.
ولهذا كانت هناك، في البداية، مشكلة في قراءة القرآن قراءة سليمة، يتوقّف عليها الفهم السليم لمعاني القرآن، التي تحكمها علامات الإعراب، والتي لا يعرفها العرب. فكان ذلك هو الدافع الأول إلى إنشاء القواعد النحوية لضبط هذه العلامات الإعرابية لحفظ القرآن من اللحن الذي كان يُخلّ بالمعنى عند قراءته. وهناك رواية متواترة، ولو أن ابراهيم أنيس يعتبرها مختلَقة، تورد أن أب الأسود الدؤلي، الذي تُنسب إليه نشأة النحو العربي، سمع من يقرأ: «أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهُ» (سورة التوبة، الآية 3) بكسر اللامِ في رسوله، فقال: “ما ظننتُ أمرَ الناس يصل إلى هذا”، فبدأ، بأمر من عمر الخطاب أو علي بن أي طالب حسب الروايات، في وضع قواعد النحو. لكن بما أن لغة القرآن، نظرا لمصدرها الإلهي حسب العقيدة الإسلامية الجديدة، أصبحت، بشكلها الإعرابي الجديد، نموذجا للغة المعيارية المثلى، الكاملة المكتملة، الراقية والفصيحة، عكس اللهجات العربية في الجاهلية، فقد استٌبعد كل تعبير عربي لا يوافق النموذج الإعرابي للغة القرآن باعتباره تعبيرا خاطئا، غير سليم وغير مقبول. وهو ما نتج عنه أن التعبير السليم، وبعربية سليمة، أضحى مشروطا بالالتزام بقواعد اللغة الإعرابية التي جاء بها القرآن.
هذه القواعد هي التي سيضعها النحاة ويفرضون بواسطتها، كشرط للتعبير السليم المقبول، لغة إعرابية جديدة لم تكن معروفة في الجاهلية، إلى أن جاء بها القرآن. ومع هذه اللغة الإعرابية، دخل ما عداها من التعابير العربية غير الإعرابية، كالتي كانت متداولة ومعروفة في الجاهلية، في حكم اللهجات الأقل درجة وقيمة من اللغة الإعرابية التي تحاكي في إعرابها لغة القرآن. وهو ما حرم هذه اللهجات من التطور نحو التقعيد والكتابة، اللذيْن أصبحا مقصوريْن على لغة القرآن ومثيلتها من اللغة الإعرابية التي صنعها النحاة.
كيف صنع النحاة العربية الإعرابية:
والمتتبّع لنشأة وتطوّر النحو العربي ما بين القرن الأول والرابع الهجرييْن، سيستوقفه، كما أبرز ذلك محمد عباد الجابري، النموّ السريع والازدهار المدهش لهذا العلم الجديد، حتى كثرت مدارسه واشتهر علماؤه ورجالاته في ظرف وجيز نسبيا، وهو ما يشكّل ظاهرة فريدة لا نجد مثيلا لها في اللغات والثقافات الأخرى. فاللغة اليونانية، مثلا، والتي كانت، ومنذ قرون قبل الفترة المسيحية، لغة كتابة وإنتاج كتابي غني، حيث أُلّفت بها المئات من الكتب في العلم والفلسفة والسياسة والمسرح والشعر والأدب والتاريخ…، لم تعرف اهتماما بنحوها يُشبه، ولو بنسبة واحد على عشرة، ذلك الاهتمام الذي عرفته العربية في بداية تقعيدها، رغم أنها كانت بلا تراث كتابي كما عند اللغة اليونانية، إذ كانت في بداية انتقالها إلى مستوى الاستعمال الكتابي.
لماذا إذن كل هذا الاهتمام غير العادي بالنحو العربي بعد ظهور القرآن؟ لأن وظيفة هذا النحو لم تكن فقط هي القراءة السليمة للقرآن وفهم لغته الإعرابية، بل كانت أيضا هي إنشاء لغة عربية جديدة إعرابية على غرار عربية القرآن الإعرابية، تحلّ محل اللهجات العربية غير الإعرابية، والتي كانت متداولة قبل الإسلام. فكان هناك اهتمام زائد بالنحو لأن ذلك عمل يدخل في صنع وبناء لغة عربية جديدة. وإذا كان القرآن هو النموذج الأصلي للعربية الإعرابية الجديدة، إلا أن النحاة سيتوسّعون في هذا النموذج ليصنعوا قوالب تصاغ على مَقاسها العربية الإعرابية الجديدة، حتى لو كانت هذه القوالب تمثّل حالات افتراضية بعيدة كل البعد عما هو متداول في الاستعمال التواصلي والكتابي للعربية، مثل: “أكلت السمكة حتى رأسها، بالفتح أم الرفع أم الكسر”؟، أو ما الأصحّ: “فإذا هو هي أم فإذا هو إياها”؛ “خرجت فإذا عبد الله القائمَ، أو القائمُ”؟ كما جاء، حسب ما تحكيه كتب التراث، في مناظرة سيبويه والكسائي. وهكذا نشأ النحو أولا، لتنشأ بعده وبه العربية الإعرابية الجديدة. وهذا وضع غريب وشاذ: النحو يسبق اللغة المتداولة وينشئها. مع أن المسار الطبيعي للغات الطبيعية هو أن تبدأ شفويةً يكتسبها أصحابها ويستعملونها بالسليقة كلغة أمّ، ثم بعد ذلك يُستخلص من هذا الاستعمال نظامُها النحوي من طرف الدارسين لطبيعة هذه اللغة من لسانيين ونحويين. فالنحو يأتي دائما بعد أن توجد اللغة وتستعمل في التداول الشفوي. فهو بمثابة حمضها النووي AD N:
وكما أن الحمض النووي الخاص بأي كائن حيّ organisme يُستخلص منه بعد أن يكون هذا الكائن موجودا، فكذلك النظام النحوي الخاص بأية لغة يُستخلص منها بعد أن تكون هذا اللغة متداولة في التواصل والتخاطب. والحال أن العربية الإعرابية، حتى وإن كانت موجودة كنص قرآني يُقرأ ويُتلى، إلا أنها لم تكن موجودة كلغة تخاطب في الحياة عندما وضع النحاة قواعد لنظامها النحوي. فلم يعد، مع هذه العربية الإعرابية، أن النحو مستخرج من اللغة المتداولة، كما هي العلاقة الطبيعية بين النحو واللغة، بل أن هذه الأخيرة، في شكلها الإعرابي، هي المستخرجة من النحو. فأصبحت هذه اللغة لا توجد إلا إذا تكلّمها أو كتبها مستعملوها بشكل مطابق، للقواعد الإعرابية التي وضعها النحاة، وليس لشكلها الطبيعي الذي كانت متداولة به قبل الإسلام. هكذا نشأت إذن العربية المعيارية الفصحى، عربية النحو والإعراب والكتابة، كنسخة موازية للغة القرآن في روحها الإعرابية. ومع نشأتها أصبح كل ما عداها من كلام عربي لا يُلتزم فيه بقواعد هذه العربية المعيارية مجرد لهجة. فهي إذن لغة غير طبيعية، بل لغة صنعها النحاة. والنتيجة أنها لغة غير قابلة للاكتساب شفويا، تلقائيا ولاشعوريا، أي بالسليقة كما هو مفترض كحقيقة مؤكّدة بخصوص عربية الجاهلية، وإنما لا بدّ لهذا الاكتساب من تعلّم وكتابة. فهي بالتعريف لغة مدرسية وكتابية، أي لغة يتوقّف إتقانها واستعمالها على تعلّمها الكتابي، طبقا للقواعد التي قرّرها النحاة.
لماذا اختفت اللغة العربية من التداول الشفوي؟
لماذا اختفت اللغة العربية من التداول الشفوي مع انتشار الإسلام، وأصبح استعمالها، منذ ذلك الاختفاء، مقصورا على الاستعمال الكتابي أو قراءة ما هو مكتوب؟ التفسير الشائع هو أن اختلاطها بلهجات أعجمية، بعد دخول أقوام غير عربية كثيرة في الإسلام، أقبلت على تعلّم العربية واستعمالها باعتبارها لغة دين وثقافة ونفوذ سياسي، أدّى إلى انتشار واسع للحن في استعمالها حتى طغا هذا اللحن في الكلام والتخاطب وأصبح شبه قاعدة. وهذا ما كان وراء وضع قواعد نحوية لضبط القراءة الصحيحة للقرآن والنطق السليم للعربية، وصونها من اللحن، وخصوصا ما يتعلق بحركات خواتم الكلمات. وهكذا حفظ النحوُ العربيةَ الإعرابية من اللحن والخطأ. لكن ذلك لم يمنع العربية اللحنية، التي لا يُلتزم فيها بقواعد الإعراب، من التداول الشفوي حتى شكّلت لهجات خاصة بكل منطقة، وغدت هي التي تُستعمل في التخاطب والتواصل اليومي. أما العربية الإعرابية المعيارية فاستمرت لغة للتعلّم والكتابة والإنتاج الثقافي والأدبي.
هذا التفسير لاختفاء العربية الإعرابية المعيارية، أي الفصحى، من التخاطب اليومي، ولنشأة اللهجات، لا يختلف كثيرا عن خرافة “السليقة” في تفسير إتقان عرب الجاهلية للعربية الإعرابية بالسليقة و”بدون معلّم”.
ـ فإذا كان انتشار اللحن، نتيجة استعمال العربية من طرف الأعاجم، هو الذي أدى إلى ظهور اللهجات العامّية واختفاء العربية الإعرابية من الاستعمال في التخاطب اليومي، فبماذا نفسّر اختفاء هذه العربية الإعرابية نفسها من الموطن التاريخي الأصلي لظهورها وانتشارها بشبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، مثل بلاد الحجاز، حيث لم يعد أحد يستعملها كلغة أمّ بهذه المنطقة، رغم أنها لم تعرف اختلاطا بالأعاجم كما في الشام ومصر وشمال إفريقيا…؟
ـ ثم لماذا وحدها العربية ينال منها اللحن الناتج عن استعمالها من طرف الأعاجم حتى تختفي نهائيا من الاستعمال اليومي؟ لماذا لم يحصل ذلك للإنجليزية ولا الإسبانية ولا البرتغالية، وهي لغات أوروبية وصلت إلى القارة الأمريكية منذ أزيد من خمسة قرون، وكان وراءها، مثل العربية، نفوذ ديني وسياسي وعسكري وثقافي، وانتشرت بهذه القارة وسط العشرات من اللهجات المحلية للسكان الأصليين، الذين سيستعملون هذه اللغات الأوربية بجانب لهجاتهم الأمريكية دون أن يؤدّي ذلك إلى اختفاء النسخة الأوروبية الأصلية لهذه اللغات من التداول الشفوي، لتتحوّل إلى عاميّة إنجليزية وإسبانية وبرتغالية مختلفة تماما عن تلك المستعملة في الكتابة، كما يُفترض أن ذلك هو ما حصل للهجات العربية التي أصبحت “لغات” مختلفة ومستقلة عن العربية الكتابية، لا تشترك معها إلا في جزء من معجمها؟
الحقيقة هي أن العربية الإعرابية، التي قيل لنا إنها كانت تُكتسب بالسليقة في الجاهلية، لم تختف من التداول الشفوي بفعل تأثير اللهجات الأجنبية للأعاجم الذين اعتنقوا الإسلام، وإنما اختفت لأنها كانت أصلا مختفية لم يسبق لها أن وجدت كلغة أمّ تُكتسب في مرحلة الطفولة، وتنتقل من جيل إلى جيل عبر تداولها الشفوي. وإذا كانت تلك اللغات الأوروبية قد احتفظت، عند انتقالها إلى أمريكا، على وضعها كلغات تداول شفوي في الحياة اليومية، فذلك لأنها أصلا كانت تُستعمل بموطنها الأوروبي بهذا الوضع نفسه، أي كلغات تُستعمل في التخاطب الشفوي، وهو ما نقلته معها إلى أمريكا لأنه يدخل في تكوينها كلغات طبيعية.
أما العربية الإعرابية، فلأنها لم يسبق أن كانت لغة شفوية، فلم تنقل معها وظيفتَها الشفوية ـ لأنها لا تملكها ـ إلى البلدان التي انتشر فيها الإسلام، بل نقلت إليها وظيفتَها الكتابية فقط. ولأن العربية لغة الإسلام ـ بل حتى لغة الجنة عند بعض الفقهاء ـ، فقد أراد المسلمون الجدد من العجم أن يتعلّموها ويستعملوها في حياتهم اليومية، ويتخلوا حتى عن لغاتهم الوطنية، كما فعل الأمازيغيون والمصريون والشاميون… لكنهم لم يجدوها متداولة في التخاطب حتى يكتسبوها ويتكلّموها. فكل ما وجدوه هو إمّا لهجات عربية غير إعرابية محدودة الانتشار لقلة عدد من يسمّوْن بالعرب “الفاتحين”، أو فقط العربية المكتوبة التي أقبلوا على تعلّمها. لكن لما أرادوا التحدّث بها، استعملوا معجمها المتوفر في هذه العربية المكتوبة، بالنسبة للمتعلّمين منهم، مع صياغتها في قوالب لغتهم المحلية. ولأن معجم هذه اللغة الجديدة عربي في الجزء الأكبر منه، فقد اعتقدوا أنهم يتكلّمون العربية الحقيقية، في حين أن ما يتكلّمونه هو لهجة صيغت بتراكيب لغتهم المحلية وبمعجم عربي. وهكذا نشأت الدارجة بشمال إفريقيا. لكن لو أن العربية كانت تملك وظيفتها الشفوية، كتلك اللغات الأوروبية التي غزت أمريكا، لما كانت هناك دارجة أصلا: لماذا سيصنع الأمازيغ دارجة أدنى رتبة ومقاما من لغة القرآن الإعرابية، التي كانت رغبتهم في التحدّث بها وراء هذه الدارجة، لو كانت العربية قد وصلتهم وهي مستعملة في التواصل الشفوي؟
الانتقادات والاعتراضات:
أتفهّم أن هذا التحليل سيثير ردودا رافضة، وانتقادات لاذعة، واعتراضات شديدة. وأول هذه الاعتراضات هو السؤال الاستنكاري: كيف غابت هذه “الحقائق” عن كل الذين تناولوا موضوع نشأة اللغة العربية وتطوّرها وخصائصها، من قدماء ومحدثين، وأشبعوه بحثا ودرسا وتأليفا؟ كيف لم ينتبهوا إلى أنها لم تكن تُكتسب وتُستعمل بالسليقة قبل الإسلام؟ إنها أسئلة مشروعة ومُحِقة.
إذا عرفنا أن كل الإنتاجات المعرفية هي عبارة عن أجوبة لأسئلة مثارة، وحلول مقترحة لمشاكل مطروحة، فسيكون غياب أسئلة حول بديهية “السليقة”، بخصوص اكتساب العربية في الجاهلية، شيئا عاديا، لأن هذا السؤال لم يُطرح إطلاقا. ولا تهمّ الأسباب، مثل الإجماع، تواتر الروايات التي تؤكد حقيقة هذه “السليقة”، وجود أشعار نظمها شعراء لم يكونوا يعرفون الكتابة والقراءة… وإنما الذي يهمّ هو أنه لا يمكن الإجابة عن سؤال غير مطروح أصلا. فالذين درسوا الشعر الجاهلي، مثلا، انطلقوا من أسئلة، من قبيل: ما هي مميزات هذا الشعر؟ ما هي اللهجات التي نُظم بها؟ ما هي طبيعة المجتمع الجاهلي كما نستشفّها من هذا الشعر؟… وقد أُلّفت العديد من الكتب في الإجابة عن هذه الأسئلة، دون أن تتطرّق لمسألة حقيقة ظاهرة السليقة لأن هذا السؤال لم يطرحه أصحاب هذه الكتب. وحتى طه حسين، عندما شكّك في هذا الشعر الجاهلي واعتبره منحولا كُتب في الفترة الإسلامية، لم ينطلق في ذلك من سؤال حول مسألة “السليقة”، بل كان سؤاله هو: لماذا نجد لغة هذه الأشعار موحّدة في شكل لهجة واحدة، هي لهجة الحجاز، ولا تختلف كثيرا عن لغة القرآن الموحّدة، ولا نجد فيها أثرا للهجات عربية أخرى، مثل اللهجات الجنوبية؟ فكان جوابه هو أن هذا “الشعر الجاهلي” ينتمي إلى العصر الإسلامي، ولا علاقة له بالعصر الجاهلي. فطه حسين أجاب عن الأسئلة التي طرحها، والتي لم يكن ضمنها سؤال يخص حقيقة “السليقة”، ولو أن النتيجة كانت ستكون، لو طرح هذا السؤال، واحدة، وهي أن تلك الأشعار لا تنتمي إلى العصر الجاهلي. وكذلك أولئك المستشرقون، الذين أرادوا تفسير ظاهرة الإعراب بإيجاد جذور لها في اللغات السامية القديمة بحكم أن العربية لغة سامية (تفاصيل ذلك في كتاب: “من أسرار اللغة”، صفحة 199 وما بعدها)، انطلقوا من هذا السؤال: ما هو الأصل السامي للإعراب؟ أما لو طرحوا هذا السؤال: هل تتوافق آليات اكتساب الطفل للغة الأمّ مع خاصية الإعراب الملازم للعربية؟ لخلصوا إلى جواب يؤكّد أن الإعراب، كما هو مطبّق في العربية، لا يمكن أن يوجد في أية لغة شفوية، سواء كانت سامية أو هند ـ أوروبية أو غيرهما، تنتقل من جيل إلى آخر بواسطة الأطفال باعتبارها لغة أمّ، وهو ما ينفي، نفيا مطلقا، اكتساب العربية الإعرابية بالسليقة.
وهذا السؤال المتعلق بعلاقة الإعراب بقدرة الأطفال على اكتساب العربية، لتنتقل عبرهم إلى الراشدين وإلى الأجيال القادمة، هو الذي كان منطلَقا لما كتبتُ.
ونلاحظ أنه في الحقيقة، وقبل أن يكون سؤالا حول العربية واستعمالها قبل الإسلام…، فهو سؤال بيداغوجي لِسني في جوهره، يخصّ عملية processus اكتساب الأطفال للغة الأمّ، وعلاقة هذه العملية بالإعراب الذي هو جزء من اللغة العربية. فقد استفزتني، من هذه الناحية البيداغوجية، مسألة الاكتساب السليقي المزعوم للعربية في الجاهلية، لأنني لم أجد مسوّغا بيداغوجيا ولسنيا يُقنعنا بإمكان اكتساب الطفل للغة إعرابية كلغة أمّ. ويتعلّق الأمر هنا بالطفل فعلا، لأن عرب الجاهلية، إذا كان المفترض أنهم كانوا يتحدّثون العربية بالسليقة، فذلك يفترِض أيضا أنهم كانوا يكتسبونها كلغة أمّ وهم أطفال. فالمسألة تتعلق إذن بآليات اكتساب الطفل للغة الأمّ، وما يثيره ذلك من سؤال حول مدى تلاؤم أو تنافي لغة ذات خصائص إعرابية مع هذه الآليات. وهذا هو بيت القصيد في كل هذه المناقشة، وهو ما كان وراء كتابة هذا الموضوع. ولهذا فإن كل ردّ على هذه الخلاصات من دون إثبات أن الطفل يستطيع، يبداغوجيا ولسنيا، اكتساب العربية الإعرابية كلغة أمّ، هو ردّ خارج الموضوع.

كاتب ومفكر وباحث ومناضل أمازيغي منحدر من منطقة الريف ومدير نشر جريدة تاويزا. ألف العديد من الكتب والمقالات التنويرية القيمة


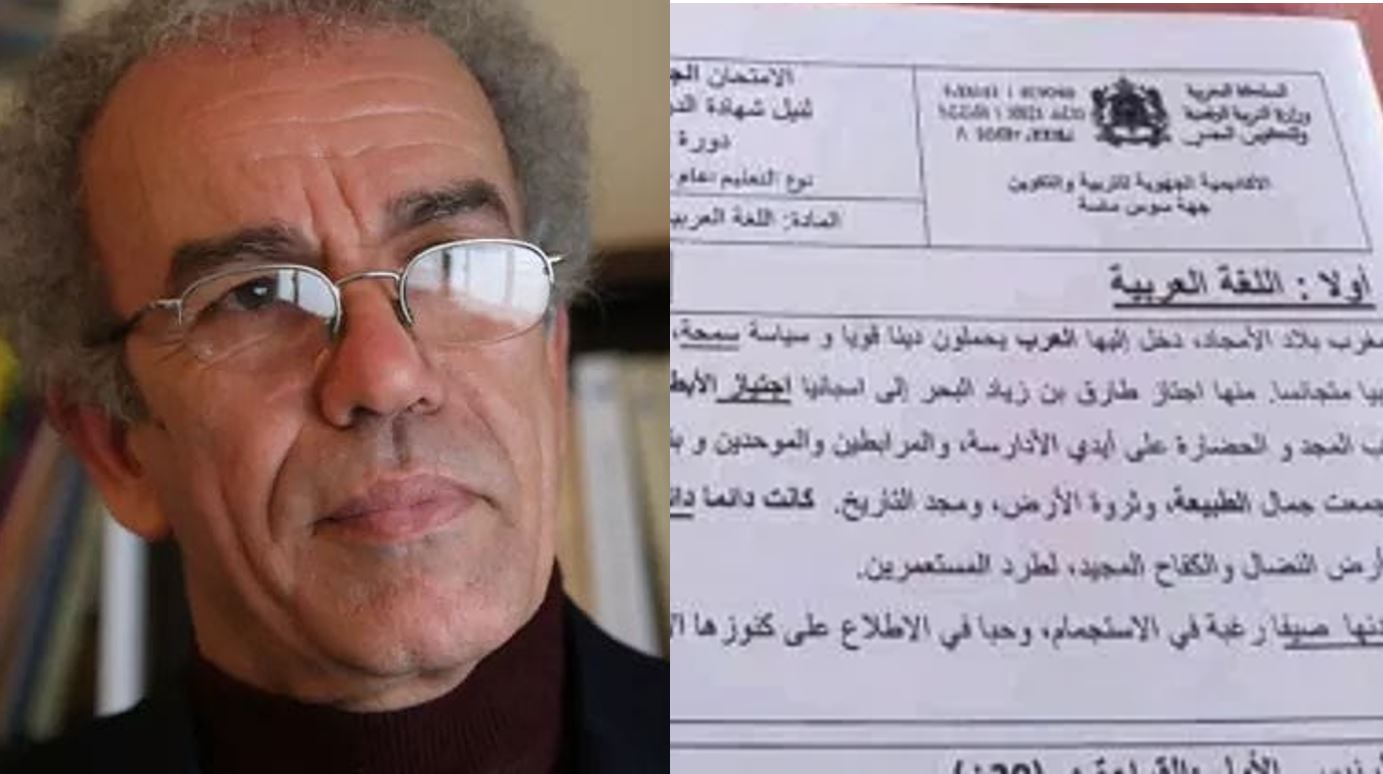



لا يمكن أن نتحدث عن لغة عربية بوصفها الحالي قبل سيبويه الفارسي الذي وضع معيرتها قرنين بعد موت النبي . القرآن الأصلي لم يكتب باللغة العربية كما خدعوا الناس و مازالوا يخدعونهم .المخطوطات القرآنية الأولى مثل مخطوطات صنعاء و الاخرى الموجودة بمتاحف أوروبا كتبت بلهجة بدائية لا يقراها إلا بضعة مختصين في اللسانيات القديمة . مكاسب العرب مبنية على السرقة واللغة العربية لا تخرج عن القاعدة بل تستعمل كمادة مخدرة تسبق العملية .حروفها سريانية و تطويرها يرجع إلى غير العرب . خطأ الأمازيغ الكبير أنهم يحتضنون لغة الغازي . كان الإسلام بمثابة ذبابة جاء على ظهرها العرب من أجل السبي… Lire la suite »
موتوا بغمكم وحقدكم وكراهيتكم يا متصهينين